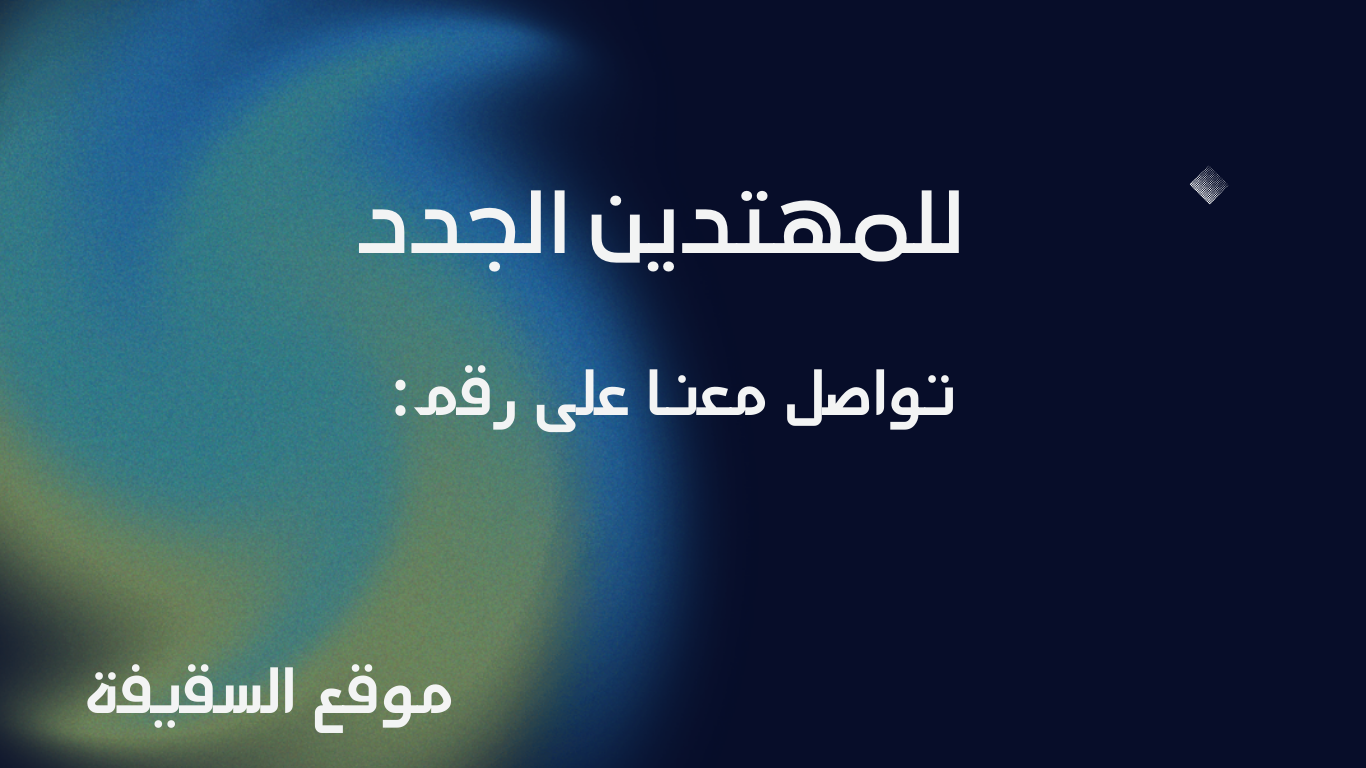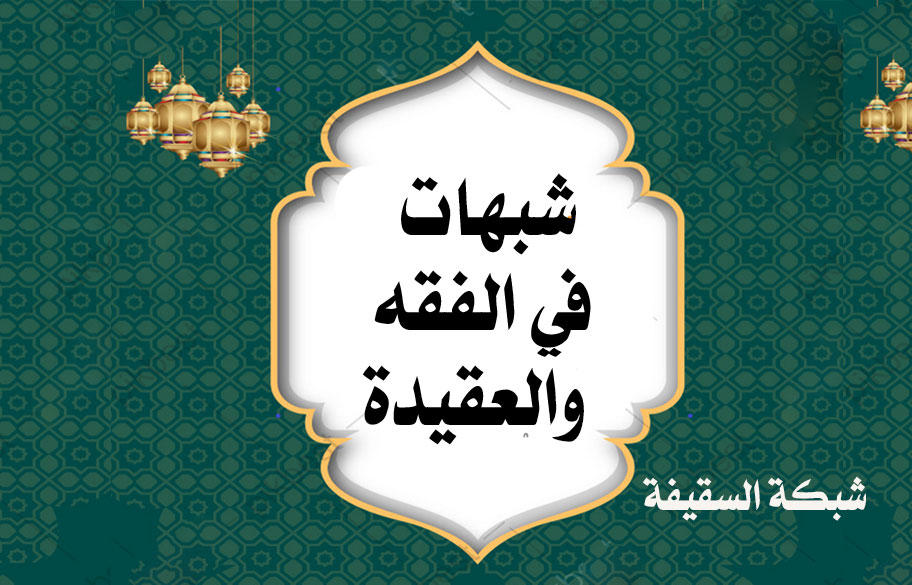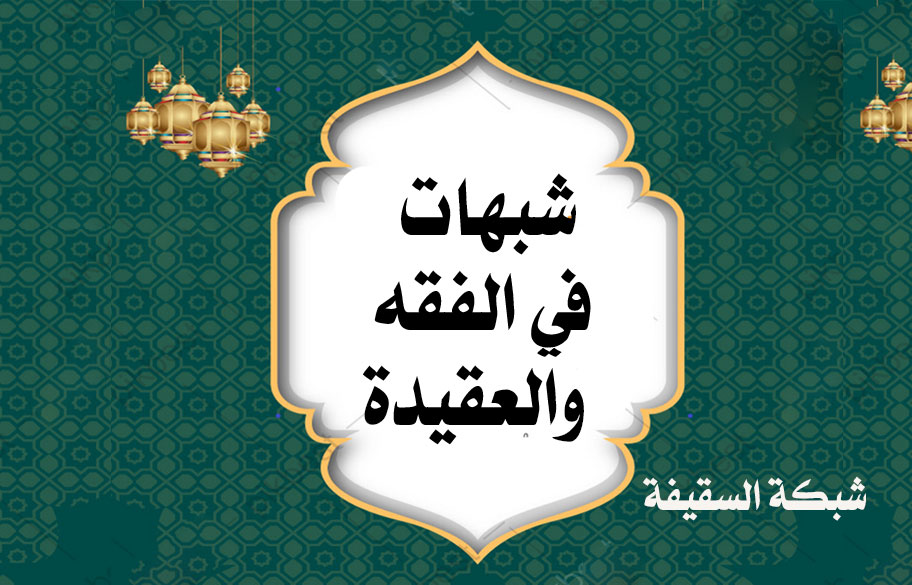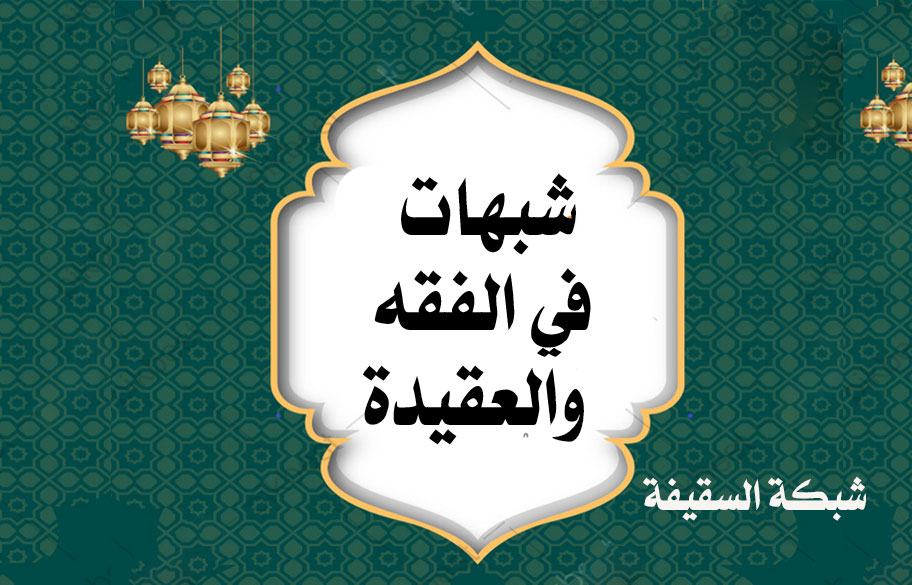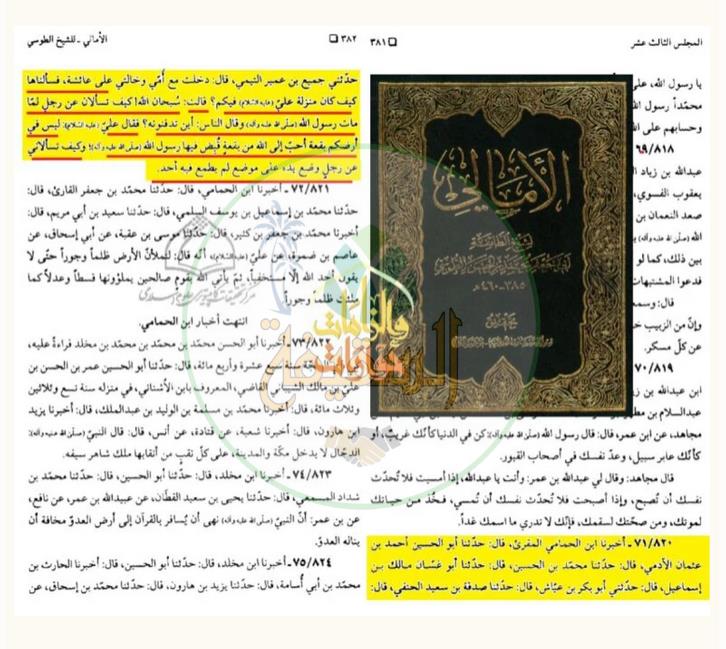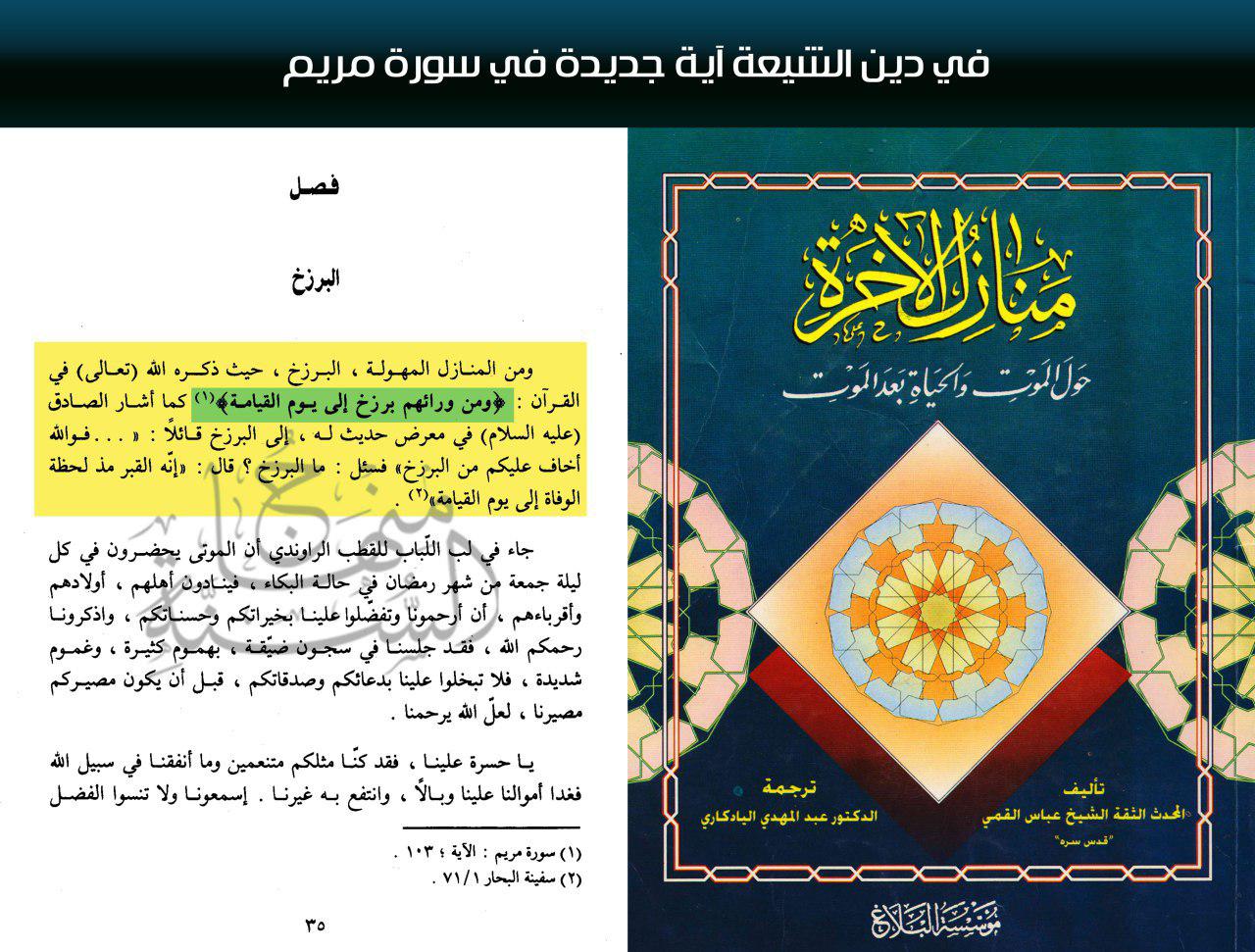إنَّ تاريخَ الأُممِ والشعوبِ حافلٌ بالأحداثِ المَفصليَّةِ التي ترسمُ ملامحَ مستقبلِها، وتُحدِّدُ مسارَها السياسيَّ والاجتماعيَّ. وفي تاريخِ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ، يبرزُ حدثُ "سقيفةِ بني ساعدةَ" كأحدِ أهمِّ هذه الأحداثِ على الإطلاقِ، فهو اللحظةُ التي انتقلتْ فيها قيادةُ الأُمَّةِ من النبوَّةِ إلى الخلافةِ، ووُضِعتْ فيها اللبنةُ الأولى لنظامِ الحكمِ الراشديِّ الذي ارتضاهُ الصحابةُ الكرامُ. ومع عِظمِ هذه الواقعةِ وأهميتِها في ترسيخِ مبدأِ الشورى، فقد كانتْ هدفًا دائمًا لسهامِ الطاعنينَ والمشكِّكينَ، وعلى رأسِهم "الفرقةُ الضالَّةُ" من الرافضةِ الاثني عشريَّةِ، الذين يتبنَّونَ سرديَّةً مُغايرةً تهدفُ إلى تشويهِ سيرةِ الصحابةِ والطعنِ في شرعيَّةِ الخلافةِ الراشدةِ. يزعمُ هؤلاءِ المشكِّكونَ، مدعومينَ ببعضِ المستشرقينَ المُغرضينَ، أنَّ اجتماعَ السقيفةِ لم يكنْ سوى صراعٍ سياسيٍّ بين أربعةِ أحزابٍ مُتناحرةٍ، وأنَّ بيعةَ الصدِّيقِ أبي بكرٍ -رضي اللهُ عنه- كانتْ "فلتةً" نتيجةَ تآمرٍ مُسبقٍ. هذا المقالُ يهدفُ إلى تفكيكِ هذه الشبهاتِ، وإجلاءِ الحقيقةِ التاريخيَّةِ لواقعةِ السقيفةِ من منظورِ "أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ"، مؤكِّدًا على أنَّ ما حدثَ كان تجسيدًا حيًّا لمبدأِ الشورى وحرصِ الصحابةِ على وحدةِ الأُمَّةِ وحمايةِ الدِّينِ.
"مضمونُ الشبهةِ وتفنيدُها:"
يدَّعي بعضُ المشكِّكينَ، وعلى رأسِهم "الفرقةُ الضالَّةُ" من الرافضةِ الاثني عشريَّةِ، أنَّ اجتماعَ السقيفةِ إثرَ وفاةِ النبيِّ -صلى اللهُ عليه وسلم- ضمَّ أربعةَ أحزابٍ سياسيَّةٍ تصارعتْ على الخلافةِ، وهي: المهاجرونَ، والأنصارُ، والشيعةُ (أصحابُ النصِّ والتعيينِ)، وحزبُ الأرستقراطيَّةِ الملكيَّةِ. ويزعمونَ أنَّ نتائجَ هذا الصراعِ استمرَّتْ حتى تمَّ ترشيحُ الصدِّيقِ لعمرَ بنِ الخطابِ للخلافةِ من بعدِه بناءً على اتفاقٍ مُسبقٍ بينهما. ويرمونَ من وراءِ ذلكَ إلى الطعنِ في أخلاقِ الصحابةِ الكرامِ، وإلى تشويهِ مؤتمرِ السقيفةِ، وما تخلَّلَهُ من نظرياتٍ سياسيَّةٍ، رسمتْ معالمَ الخلافةِ الإسلاميَّةِ في عهدِ الراشدينَ ومن تبعَهم.
"وجها إبطالِ الشبهةِ من منظورِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ:"
1- "الحكمةُ التشريعيَّةُ في تركِ النصِّ على الخليفةِ:"
أسَّسَ النبيُّ -صلى اللهُ عليه وسلم- الدولةَ الإسلاميَّةَ، وأقامَ لها كيانًا مُستقلًّا، بيدَ أنَّه -صلى اللهُ عليه وسلم- لم ينصَّ على خليفةٍ بعدَهُ؛ ليفتحَ المجالَ أمامَ المسلمينَ جميعِهم في الاجتهادِ، ويُرسيَ مبدأَ الشورى في اختيارِ من يتولَّى أمرَهم، خصوصًا وأنَّ المسلمينَ يُدركونَ أهميَّةَ الخلافةِ ووجوبَ إقامةِ خليفةٍ للمسلمينَ.
2- "حقيقةُ مؤتمرِ السقيفةِ:"
مؤتمرُ السقيفةِ من أهمِّ المؤتمراتِ في تاريخِ الإسلامِ كلِّه؛ ففيه تمَّ وضعُ دستورِ الخلافةِ الذي يُنظِّمُ حياةَ المسلمينَ بعدَ وفاةِ النبيِّ -صلى اللهُ عليه وسلم-، فلا غَرْوَ أنْ تُعرَضَ فيه وجهاتُ النظرِ بحريَّةٍ وشفافيَّةٍ طالما أنَّها تمسُّ حياةَ المسلمينَ، ولا صحَّةَ لما يدَّعيهِ المُتوهِّمونَ من أنَّ المؤتمرَ ضمَّ أربعةَ أحزابٍ سياسيَّةٍ تناحرتْ على خلافةِ المسلمينَ.
"التفصيلُ والردُّ على الشبهاتِ:"
"أولًا: لماذا لم ينصَّ النبيُّ -صلى اللهُ عليه وسلم- على خليفةِ المسلمينَ بعدَهُ؟"
"الإسلامُ وخلقُ الدولةِ الإسلاميَّةِ:"
تلكَ حقيقةٌ لا يُجادلُ فيها أحدٌ، فالإسلامُ هو الذي خلقَ الدولةَ الإسلاميَّةَ من العدمِ، ومدَّ أطرافَها في كلِّ الاتجاهاتِ، وجعلَ منها دولةً مرهوبةَ الجانبِ تدورُ في فلكِها الدولُ وتتقرَّبُ إليها الممالكُ. والقرآنُ هو الذي وجَّهَ المسلمينَ لتكوينِ هذه الدولةِ، حيثُ بشَّرَهم بها، ووعدَهم بقيامِها، ودفعَهم لأنْ يعملوا لقيامِ الدولةِ، وأنْ يُقيموها عندما تيسَّرتْ لهم سُبُلُ إقامتِها.
وكانَ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم- أولَ رئيسٍ لهذه الدولةِ الناشئةِ، فجمعَ برئاستِه للدولةِ بين صفتينِ:
أولاهما: صفةُ الرسولِ، فهو يُبلِّغُ عن ربِّه ما أُوحيَ إليهِ من الدِّينِ والتشريعِ ويُبيِّنُه للناسِ.
والثانيةُ: صفةُ الحاكمِ، فهو يرأسُ الدولةَ ويُديرُها، فيُجيِّشُ الجيوشَ ويُسيِّرُها ويُعلنُ الحربَ، ويَعقدُ الصلحَ ويُبرمُ المعاهداتِ، ويُعيِّنُ القُوَّادَ، والحُكَّامَ، والقُضاةَ، ويَقبلُهم، ويَصرفُ الشؤونَ الماليَّةَ، والقضائيَّةَ، والسياسيَّةَ، والإداريَّةَ.
وكانَ -صلى اللهُ عليه وسلم- يُؤدِّي وظيفتَه كحاكمٍ في حدودِ الإسلامِ، فما جاءتْ فيه نصوصٌ صريحةٌ طبَّقَ عليهِ تلكَ النصوصَ، وما لم يَرِدْ فيه نصٌّ طبَّقَ عليهِ ما يُوحَى بهِ إليهِ إنْ نزلَ فيهِ الوحيُ بشيءٍ، فإنْ لم ينزلْ فيهِ وحيٌ اجتهدَ في الحكمِ، ولم يخرجْ بالأمرِ عمَّا يقتضيهِ روحُ التشريعِ الإسلاميِّ واتجاهاتُه العُليا.
وبعدَ وفاةِ الرسولِ -صلى اللهُ عليه وسلم- انقطعَ الوحيُ، وتحدَّدَ الإسلامُ فلا زيادةَ، ولا نقصانَ، ولا تبديلَ، ولا تعديلَ، وأصبحَ السلطانُ الروحيُّ مُمثَّلًا فيما جاءَ بهِ الرسولُ -صلى اللهُ عليه وسلم- وهو الإسلامُ، كما أصبحَ الإسلامُ مُحدَّدًا بالقرآنِ والسُّنَّةِ. وكلُّ من يَخلفُ الرسولَ -صلى اللهُ عليه وسلم- على رئاسةِ الدولةِ ليسَ لهُ من سلطانٍ إلا السلطانُ الماديُّ الذي كانَ يُباشرُه الرسولُ -صلى اللهُ عليه وسلم- باعتبارِه رئيسًا للدولةِ، أمَّا السلطانُ الروحيُّ فهو للقرآنِ والسُّنَّةِ أيْ لما جاءَ بهِ الرسولُ -صلى اللهُ عليه وسلم-، على أنَّه لمَّا كانَ السلطانُ الماديُّ في الإسلامِ يقومُ على السلطانِ الروحيِّ ويندمجُ فيهِ، فإنَّ رئيسَ الدولةِ الإسلاميَّةِ حينَ يُباشرُ وظيفتَه إنَّما يُباشرُ سلطانًا ماديًّا وسلطانًا روحيًّا اندمجَ كلاهما في الآخرِ وامتزجَ بهِ.
"افتراءاتٌ حولَ تركِ النبيِّ -صلى اللهُ عليه وسلم- تحديدَ من يخلفُه في قيادةِ المسلمينَ وتفنيدُها:"
يُحاولُ بعضُ المستشرقينَ أنْ يجدَ تعليلًا لتركِ رسولِ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم- هذا الأمرَ، فيقولُ بعضُهم: لعلَّ مرضَه في أيَّامِه الأخيرةِ هو الذي منعَهُ من ذلكَ. ولكنْ يُنبغي أنْ يُسألَ: وماذا كانَ المانعُ طوالَ السنينِ العديدةِ قبلَ تلكَ الأيَّامِ الأخيرةِ؟ وهل كانَ المرضُ هكذا من الشدَّةِ، بحيثُ جعلَهُ غيرَ قادرٍ على التحدُّثِ لمن حولَهُ؟
ويرى الأستاذُ أرنولدُ أنَّ السببَ: هو أنَّ النبيَّ -صلى اللهُ عليه وسلم- لم يشأْ أنْ يُخالفَ التقاليدَ العربيَّةَ التي كانتْ مُتَّبعةً في عصرِه، ومن تلكَ التقاليدِ -كما زعمَ- أنَّ القبيلةَ كانتْ تُتركُ حُرَّةً لتختارَ من يَحكمُها! وهذا رأيٌ ظاهرُ البطلانِ؛ لأنَّه لم يكنْ هناكَ تقليدٌ مُعيَّنٌ واحدٌ بين العربِ، بل كانتْ هناكَ تقاليدُ عديدةٌ، وقد وُجدتْ بينَهم الحكوماتُ الوراثيَّةُ، كما عرفوا الفوضى وتركَ الأُمورِ على فِطرتِها؛ ولأنَّ المجتمعَ الإسلاميَّ قد قامَ على أساسِ الرابطةِ الدينيَّةِ لا القبليَّةِ، والشيءُ الذي عُنيَ بهِ الإسلامُ تمامًا هو محوُ التنظيمِ القبليِّ، وتنشئةُ مُجتمعٍ سياسيٍّ على نَسَقٍ جديدٍ.
وإنَّما السببُ الذي نراهُ حقيقيًّا -لأنَّه من الممكنِ أنْ يُقامَ عليهِ الدليلُ العقليُّ، ولأنَّه قياسٌ على ما ثبتَ تاريخيًّا عن الإسلامِ، واتجاهِه في تشريعاتِه وأنظمتِه- هو أنَّه كانتْ هناكَ "حكمةٌ تشريعيَّةٌ مقصودةٌ" من عدمِ تحديدِ هذا الأمرِ، وتلكَ هي عدمُ تقييدِ الجماعةِ بقوانينَ جامدةٍ، قد تُثبتُ الأيَّامُ أنَّها لا تتفقُ مع التطوراتِ التي تحدثُ، ولا تُلائمُ الظروفَ والأحوالَ، فإنَّ من الصفاتِ الظاهرةِ التي حرصَ عليها المُشرِّعُ أنْ تظلَّ القوانينُ الإسلاميَّةُ مرنةً، حتى تُعطيَ مُرونتُها الفرصةَ للعقلِ للتفكيرِ، وللجماعةِ أنْ تُشكِّلَ أوضاعَها حسبَ مصالحِها المُتجدِّدةِ.
وهذهِ إحدى الخصائصِ التي يُعرفُ بها التشريعُ الإسلاميُّ، فالتشريعُ السياسيُّ فيهِ لم يخرجْ عن هذه القاعدةِ، والذي يُرجِّحُه الذهنُ، بل يكادُ يقطعُ بهِ، أنَّ هذه الحكمةَ كانتْ مُراعاةً ومُتعمَّدًا تحقيقُها، وأنَّ هذا وحدَهُ هو التفسيرُ الذي يُنبغي أنْ يُقبلَ، لا أنْ يُنسبَ ذلكَ إلى عدمِ القدرةِ للمرضِ، أو لمجرَّدِ التركِ، أو لمتابعةِ التقاليدِ العربيَّةِ، إلى غيرِ ذلكَ ممَّا يزعمُه المستشرقونَ. والخلاصةُ أنَّ تركَ هذا الأمرِ بدونِ تحديدٍ هو في ذاتِه اعترافٌ بالرأيِ العامِّ للجماعةِ، أو كما نقولُ في تعبيرِنا الحديثِ "إرادةُ الأُمَّةِ".
"فرضيَّةُ الخلافةِ الإسلاميَّةِ وحرصُ الصحابةِ -رضي اللهُ عنهم- على إقامةِ خليفةٍ:"
الخلافةُ أو الإمامةُ موضوعةٌ لخلافةِ النبوَّةِ في حراسةِ الدِّينِ وسياسةِ الدنيا. وعن فرضيَّتِها ووجوبِها شرعًا وعقلًا يُحدِّثُنا الفقيهُ عبدُ القادرِ عودةَ، فيذكرُ أنَّ الخلافةَ أو الإمامةَ فريضةٌ شرعيَّةٌ يُوجبُها الشرعُ على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ، ويُخاطبُ الجميعَ بها، وعليهم أنْ يعملوا حتى تُؤدَّى هذه الفريضةُ، فإذا أُدِّيَتْ سقطتْ عنهم حتى تتجدَّدَ بعزلِ الخليفةِ أو موتِه.
هذا ما وعاهُ الصحابةُ وأدركوهُ من أنَّ الخلافةَ موضوعةٌ لخلافةِ النبوَّةِ وحراسةِ الدِّينِ والدنيا؛ لذا تحرَّكوا سريعًا نحو تنصيبِ خليفةٍ للمسلمينَ حتى وإنْ كانَ رسولُهم لم يُدفنْ بعدُ! وربَّما يطعنُ بعضُ الجاهلينَ قائلًا: فعلَ الصحابةُ ذلكَ حرصًا منهم على الخلافةِ، وكأنَّ نفوسَهم قد تاقتْ إلى ذلكَ ورغبتْ فيهِ، حتى أطلقوا لها العنانَ فورَ وفاتِه -صلى اللهُ عنهم-.
ولكنَّنا بدورِنا نُجلي خُبثَ أفكارِهم، بأنَّ ما فعلَهُ الصحابةُ لم يتعدَّ أنْ يكونَ تنفيذًا لسُنَّةِ النبيِّ -صلى اللهُ عليه وسلم- حتى في أصعبِ الظروفِ والأوقاتِ، وحرصًا منهم على ألَّا ينفرطَ عقدُ المسلمينَ. وهم يعلمونَ وجودَ المُتربِّصينَ بالإسلامِ ودولتِه، والذين ينتظرونَ مثلَ هذه الفُرصِ؛ لبثِّ نارِ العداوةِ، والشقاقِ، والخلافِ بين المسلمينَ. أضفْ إلى ذلكَ أنَّ الأمرَ لم يستغرقْ إلَّا وقتًا قصيرًا حُسمتْ فيهِ الأُمورُ، وعادَ المسلمونَ إلى فجيعتِهم في موتِ النبيِّ -صلى اللهُ عليه وسلم-، ولكنْ بعدَ أنْ أغلقوا أبوابَ الفتنةِ، وفوَّتوا الفرصةَ على أعدائِهم لاستغلالِ هذه الفرصةِ.
"ثانيًا: الأهميَّةُ التاريخيَّةُ لمؤتمرِ السقيفةِ، والردُّ على فِريةِ "الأحزابِ السياسيَّةِ الأربعةِ المُتصارعةِ":"
مؤتمرُ السقيفةِ من أهمِّ وأخطرِ المؤتمراتِ في تاريخِ الإسلامِ، ففيهِ دستورُ الخلافةِ الذي يُنظِّمُ حياةَ المسلمينَ، فلا عَجَبَ أنْ تُعرَضَ فيهِ وجهاتُ النظرِ بحريَّةٍ وشفافيَّةٍ ما دامتْ تمسُّ حياةَ المسلمينَ ومستقبلَهم.
"حيثيَّاتُ المؤتمرِ والنظريَّاتُ السياسيَّةُ التي برزتْ فيهِ:"
تمَّ عقدُ اجتماعِ "السقيفةِ" وحينَ بلغَ نَبْؤُه أبا بكرٍ وعمرَ -رضي اللهُ عنهما- وبعضَ المهاجرينَ أسرعوا إلى حضورِه، وغابَ عنهم بعضُ كبارِ الشخصيَّاتِ. وما درى الحاضرونَ في هذا الاجتماعِ أنَّهم كانوا يعقدونَ أهمَّ اجتماعٍ أو مؤتمرٍ في تاريخِ الإسلامِ كلِّه، وما أشبهَهُ بجمعيَّةٍ وطنيَّةٍ أو تأسيسيَّةٍ تبحثُ في مصيرِ أُمَّةٍ لأجيالٍ عديدةٍ لاحقةٍ، وتضعُ لها دستورًا، يكونُ أساسًا لحياتِها في المستقبلِ. وإنَّ أكبرَ نتيجةٍ لهذا الاجتماعِ أنَّه على أساسِه قامَ "نظامُ الخلافةِ" الذي بقيَ منذُ ذلكَ الوقتِ، في شكلٍ أو آخرَ، إلى القرنِ العشرينَ.
وتضمَّنَ قيامُها على الصورةِ التي أقرَّها المجتمعونَ معانٍ كانتْ لها نتائجُ دستوريَّةٌ خطيرةٌ. ونحنُ لا نريدُ أنْ نذكرَ الآنَ -أيضًا- ما جرى من مُناقشاتٍ في هذا الاجتماعِ بالتفصيلِ، وإنَّما يكفي أنْ نُقرِّرَ أنَّ مُساجلاتِ الرأيِ دارتْ في هذا الاجتماعِ بحريَّةٍ وفي صراحةٍ، بحيثُ مثَّلتْ وجهاتِ النظرِ المختلفةِ، حتى إنَّها دعتْ كاتبًا غربيًّا هو الأستاذُ ماكدونالدُ أنْ يشهدَ: "بأنَّ هذا الاجتماعَ يُذكِّرُ إلى حدٍّ بعيدٍ بمؤتمرٍ سياسيٍّ دارتْ فيهِ المُناقشاتُ وفقَ الأساليبِ الحديثةِ".
ونستطيعُ أنْ نُلخِّصَ أهمَّ النظرياتِ التي عُرضتْ في هذا الاجتماعِ على النحوِ الآتي:
"نظريةُ الدفاعِ عن حقِّ المهاجرينَ في الخلافةِ:" قامتْ هذه النظريةُ على الدفاعِ عن حقِّ المهاجرينَ، وإثباتِ أولويَّتِهم في استحقاقِ الخلافةِ على غيرِهم، على اعتبارِ أنَّهم -على حدِّ ما عبَّرَ أبو بكرٍ -رضي اللهُ عنه- في خطابِه: "أولُ من عبدَ اللهَ في الأرضِ، وهم أولياءُ الرسولِ وعشيرتُه، والذين صبروا معهُ على شدَّةِ أذى قومِهم وتكذيبِهم إيَّاهم، وكلُّ الناسِ لهم مُخالفٌ زارٌ، فلم يستوحشوا لقلَّةِ عددِهم وإجماعِ قومِهم عليهم". وجاءَ في ثنايا هذا الدفاعِ لأولِ مرَّةٍ فكرةُ التنويهِ بفضلِ قريشٍ: «الأئمَّةُ من قريشٍ»، وستكونُ أساسًا لنظريةِ أحقيَّةِ القُرشيِّينَ للخلافةِ أو انحصارِ هذا الحقِّ فيهم.
نظريةُ الدفاعِ عن حقِّ الأنصارِ في الخلافةِ:" قامتْ هذه النظريةُ على دعوى استحقاقِ الأنصارِ للخلافةِ على أساسِ أنَّهم هم الذين دافعوا عن الإسلامِ، وحَمَوهُ بأنفسِهم وأموالِهم، وهم الذين آوَوا ونصروا وأنَّهم أصحابُ الدارِ.
"نظريةُ تعدُّدِ الإمارةِ والسيادةِ: هذه النظريةُ دعا إليها الحُبابُ بنُ المُنذرِ بنِ الجَموحِ، وهي إمكانُ اقتسامِ السيادةِ أو تعدُّدِ الإمارةِ، أيْ بأنْ يكونَ هناكَ خليفتانِ، وذلكَ حينَ قالَ: «مِنَّا أميرٌ ومِنكم أميرٌ»، ولكنَّ المجتمعينَ على اختلافِ وجهاتِ نظرِهم، قد أقرُّوا مبدأً خطيرًا هو: أنَّ اختيارَ رئيسِ الجماعةِ أو الدولةِ إنَّما هو بالبيعةِ، أيِ الانتخابِ، ونبذوا جميعًا بسلوكِهم الفعليِّ مبدأَ الوراثةِ.
استقرَّ الرأيُ على انتخابِ أبي بكرٍ، وليسَ انتخابُه -كما يقولُ الأستاذُ أرنولدُ جريًا مع فكرتِه الخاطئةِ التي سبقَ أنْ أبَنَّا زيفَها من تشبيهِه هذا المجتمعَ الجديدَ بالتنظيمِ القبليِّ- مُتابعةً للتقاليدِ المألوفةِ عندَ العربِ منذُ القِدَمِ، من النظرِ إلى السِّنِّ والنفوذِ، ولكنْ لمَّا كانَ يتمتَّعُ بهِ أبو بكرٍ -رضي اللهُ عنه- بين الصحابةِ من مكانةٍ دينيَّةٍ عاليةٍ يُقرُّ لهُ بها الجميعُ، راجعةً إلى سَبْقِه في الإسلامِ، وحُسنِ بلائِه في سبيلِه، وطولِ صُحبتِه للرسولِ -صلى اللهُ عليه وسلم-، وإخلاصِه ورسوخِ إيمانِه، ثمَّ إلى صفاتِه العقليَّةِ والخُلُقيَّةِ النادرةِ التي جعلتْ من شخصيَّتِه المَثَلَ الكاملَ للمسلمِ، والتي عبَّرَ عنها عمرُ -رضي اللهُ عنه- في قولٍ مُوجزٍ: «ليسَ فيكمْ من تنقطعُ الأعناقُ إليهِ مثلُ أبي بكرٍ».
ولو جرتِ الأُمورُ وفقَ تقاليدِ العربِ لآثروا انتخابَ ابنِ عبادةَ زعيمِ الخزرجِ، أو أبي سفيانَ (رأسِ شيوخِ بني أُميَّةَ)، أو العباسِ (عميدِ الهاشميِّينَ)، وقد كانَ فيهم من هو أسَنُّ من أبي بكرٍ، ولمَّا عدلَ المُنتخبونَ عن هذهِ الأُسرِ القويَّةِ إلى فَرعِ تَيْمٍ البعيدِ الذي كانَ أقلَّ نفوذًا. وأيَّا ما كانَ الأمرُ، فقد اختارَ المسلمونَ الصدِّيقَ أبا بكرٍ خليفةً للمسلمينَ، ورضيتْ بهِ نفوسُهم وعقولُهم إمامًا وقائدًا لهم، وكيفَ لا ترضى هذهِ النفوسُ الزكيَّةُ والعقولُ الطاهرةُ برجلٍ لهُ من الفضائلِ الكثيرُ والكثيرُ، فهو صدِّيقُ هذهِ الأُمَّةِ، وهو ثاني اثنينِ في الشجاعةِ والرجولةِ، وهو من الدِّينِ مِلءُ السمعِ والبصرِ، وهو إمامُ المسلمينَ في الصلاةِ وقتَ مرضِ المصطفى -صلى اللهُ عليه وسلم-، وكأنِّي بهؤلاءِ الصحابةِ العظامِ يقولونَ: لقد اختارَهُ رسولُ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم- لإمامتِنا في الصلاةِ، فكيفَ لا نختارُه لإمامتِنا في الحياةِ!!.
"الردُّ على شبهةِ "الأحزابِ الأربعةِ" المزعومةِ:"
"1- تفنيدُ وجودِ "حزبِ الشيعةِ" في السقيفةِ:"
إنَّ القولَ بوجودِ حزبٍ للشيعةِ في مؤتمرِ السقيفةِ قولٌ عجيبٌ؛ إذْ إنَّ هذا المؤتمرَ على ما دارَ فيهِ من مُناقشاتٍ وآراءٍ لم يَرِدْ فيهِ ذكرٌ لترشيحِ الإمامِ عليٍّ -رضي اللهُ عنه- للخلافةِ، ولم يَدُرْ بخلدِ أحدٍ من المجتمعينَ في السقيفةِ أنْ تكونَ وراثيَّةً في بيتِ رسولِ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم-. لقد كانَ هناكَ من بينِ الصحابةِ من رأى عَقِبَ وفاةِ رسولِ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم- أنَّ عليًّا -رضي اللهُ عنه- أولى بالخلافةِ من غيرِه، فهو إلى جانبِ فضلِه وسَبْقِه يَمتازُ بقرابتِه من رسولِ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلم-، وكانَ من هؤلاءِ: جابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وحُذيفةُ بنُ اليمانِ، وسلمانُ الفارسيُّ، وأبو ذرٍّ الغفاريُّ. "ولكنَّ هؤلاءِ لم يكونوا حزبًا، ولم يُطلقْ عليهم مُصطلحُ الشيعةِ، ولم يُطالبْ عليٌّ -رضي اللهُ عنه- بالخلافةِ حتى يَظهرَ مدى تأييدِهم لهُ، ولم يَرَوْا الخلافةَ حقًّا مُقدَّسًا لعليٍّ أو لغيرِه، وكانوا يُدركونَ مكانةَ الشورى في الإسلامِ؛ ولذلكَ لم يُصرُّوا على رأيِهم وبايعوا أبا بكرٍ -رضي اللهُ عنه- كما بايعَهُ الإمامُ عليٌّ -رضي اللهُ عنه-، وصارَ الجميعُ يُؤيِّدُ أبا بكرٍ في حروبِه ويعملونَ إلى جانبِه." فالقولُ بوجودِ حزبٍ للشيعةِ ظهرَ في مؤتمرِ السقيفةِ قولٌ غيرُ صحيحٍ، وكذلكَ القولُ بوجودِ حزبٍ للشيعةِ بالمعنى الفنِّيِّ لكلمةِ "حزبٍ" في أيَّامِ أبي بكرٍ وعمرَ -رضي اللهُ عنهما- قولٌ غيرُ صحيحٍ؛ إذْ إنَّ الحزبَ الشيعيَّ بدأَ في التكوينِ بوصفِه حزبًا سياسيًّا منذُ أيَّامِ عليٍّ -رضي اللهُ عنه- أو في أواخرِ عهدِ عثمانَ.
"2- تفنيدُ وجودِ "حزبِ الأرستقراطيَّةِ الملكيَّةِ":"
ومن غرائبِ افتراءاتِ المستشرقينَ ما يدَّعونَهُ بحزبِ الأرستقراطيَّةِ الملكيَّةِ. ويتساءلُ د. ضياءُ الدِّينِ الريسُ: ما هذا الحزبُ الذي يُسمَّى حزبَ "الأرستقراطيَّةِ الملكيَّةِ"؟ إنَّ الذي يبدو أنَّه يَعني هذا النفرَ من كفَّارِ قريشٍ الذين لم يُسلموا إلَّا عندَ الفتحِ، وعلى رأسِهم أبو سفيانَ. ولكنْ لماذا يُقصرُ وصفَ "الأرستقراطيَّةِ" عليهم؟ ألم يكنْ في المهاجرينَ أيضًا من بني أُميَّةَ، ومن بني مخزومٍ، وبني عديٍّ، وبني أسدٍ، ومن أشرافِ قريشٍ والعربِ وأثريائِهم؟ وأليسَ بنو هاشمٍ وبنو أُميَّةَ فرعينِ من أصلٍ واحدٍ