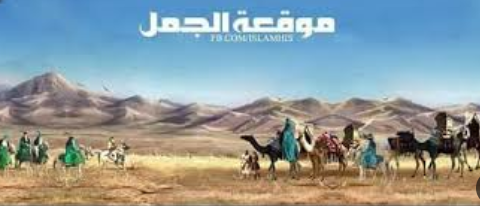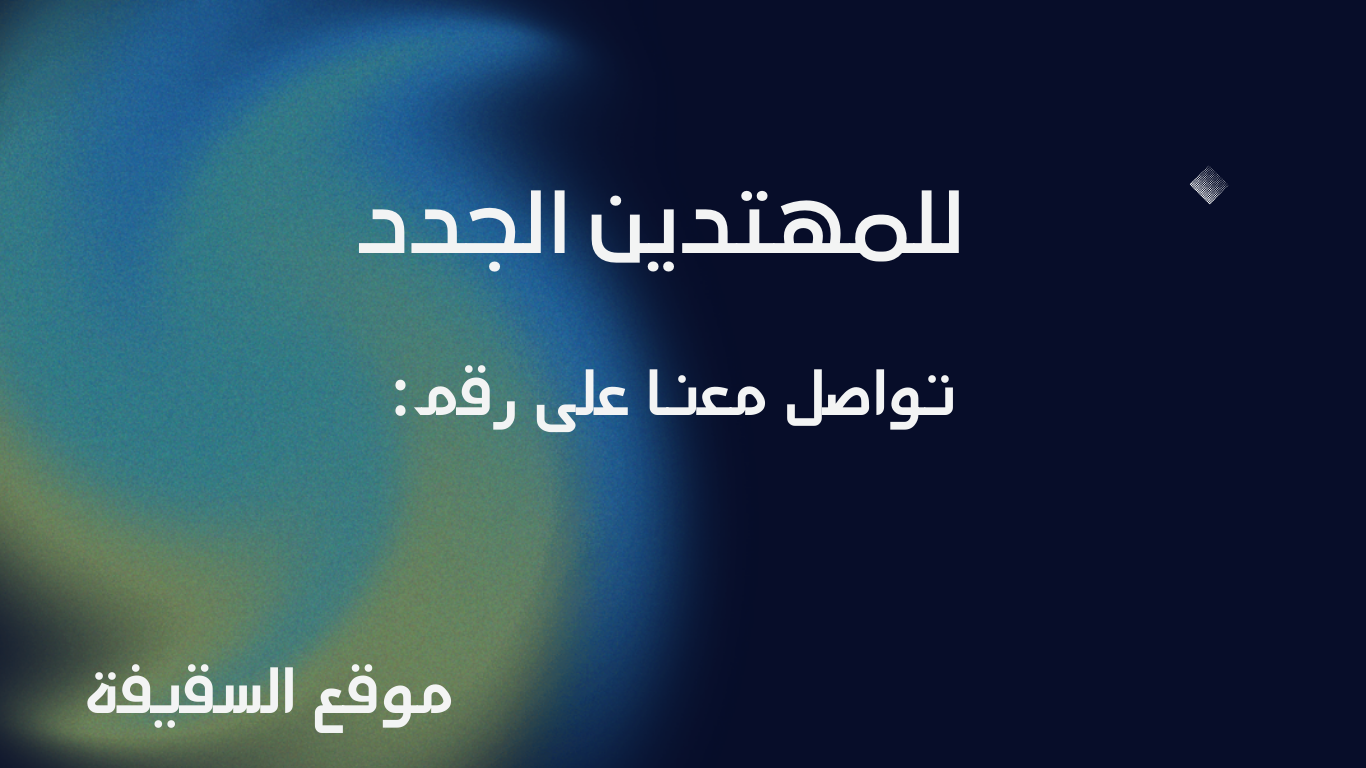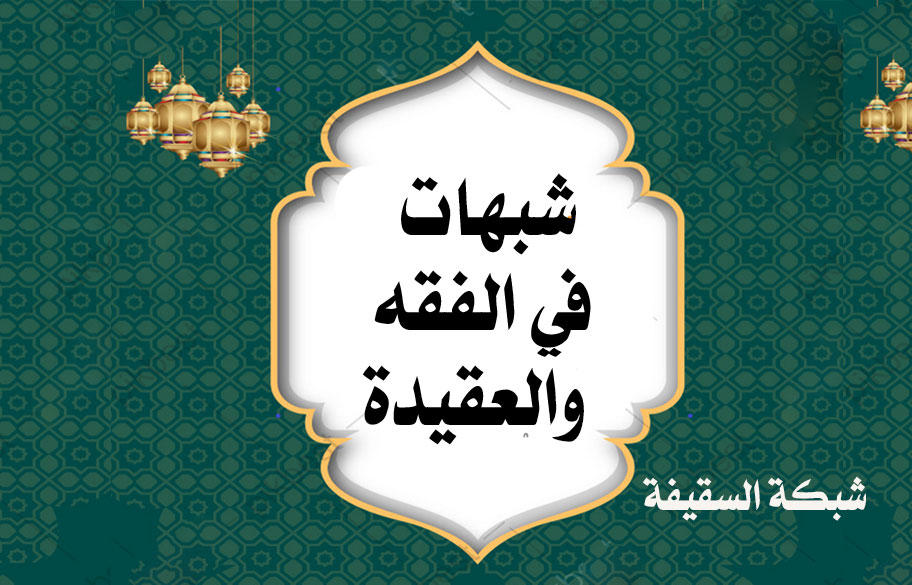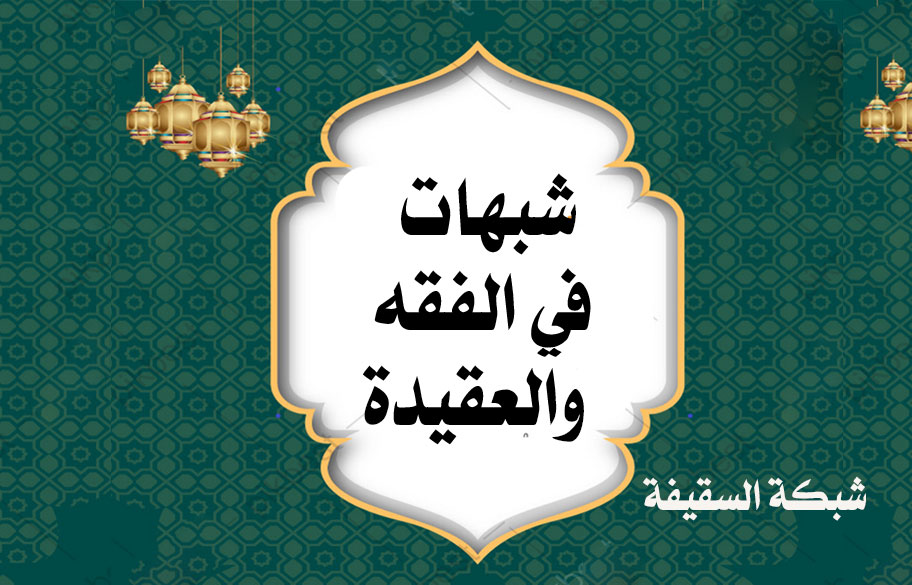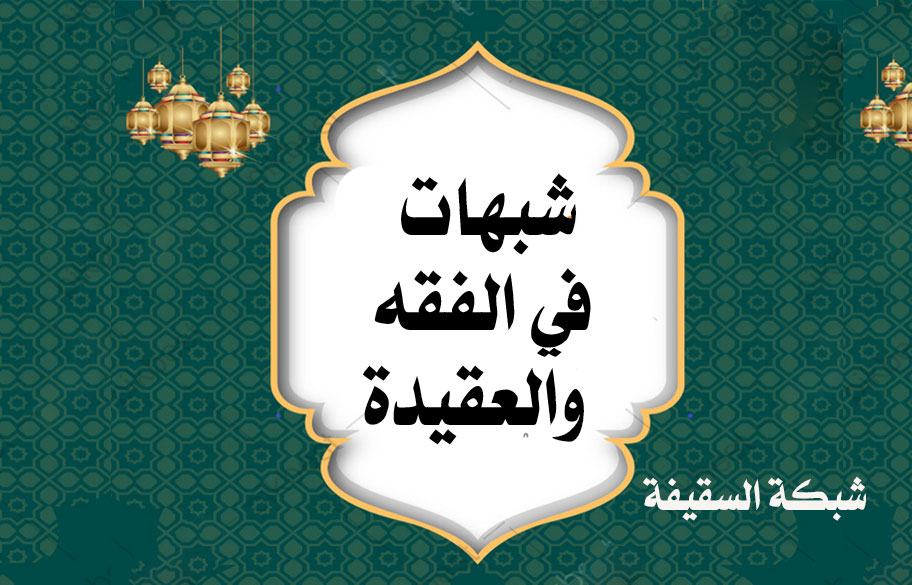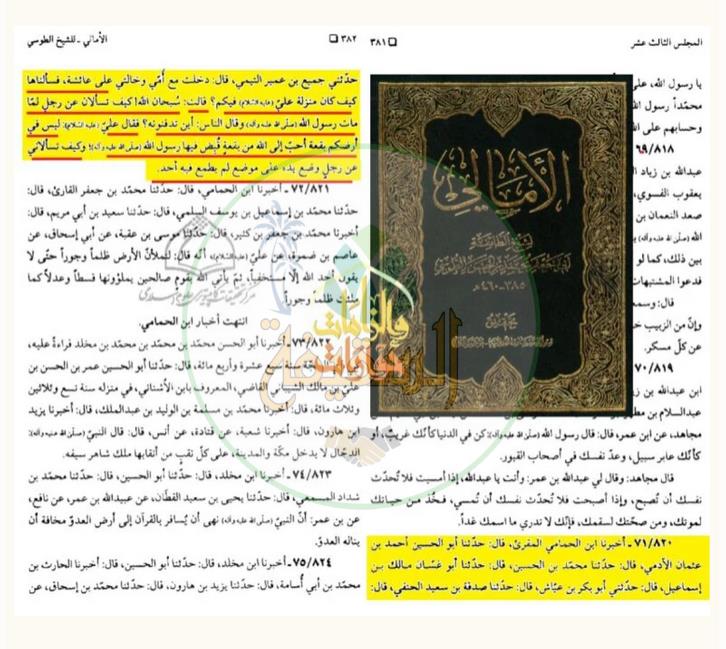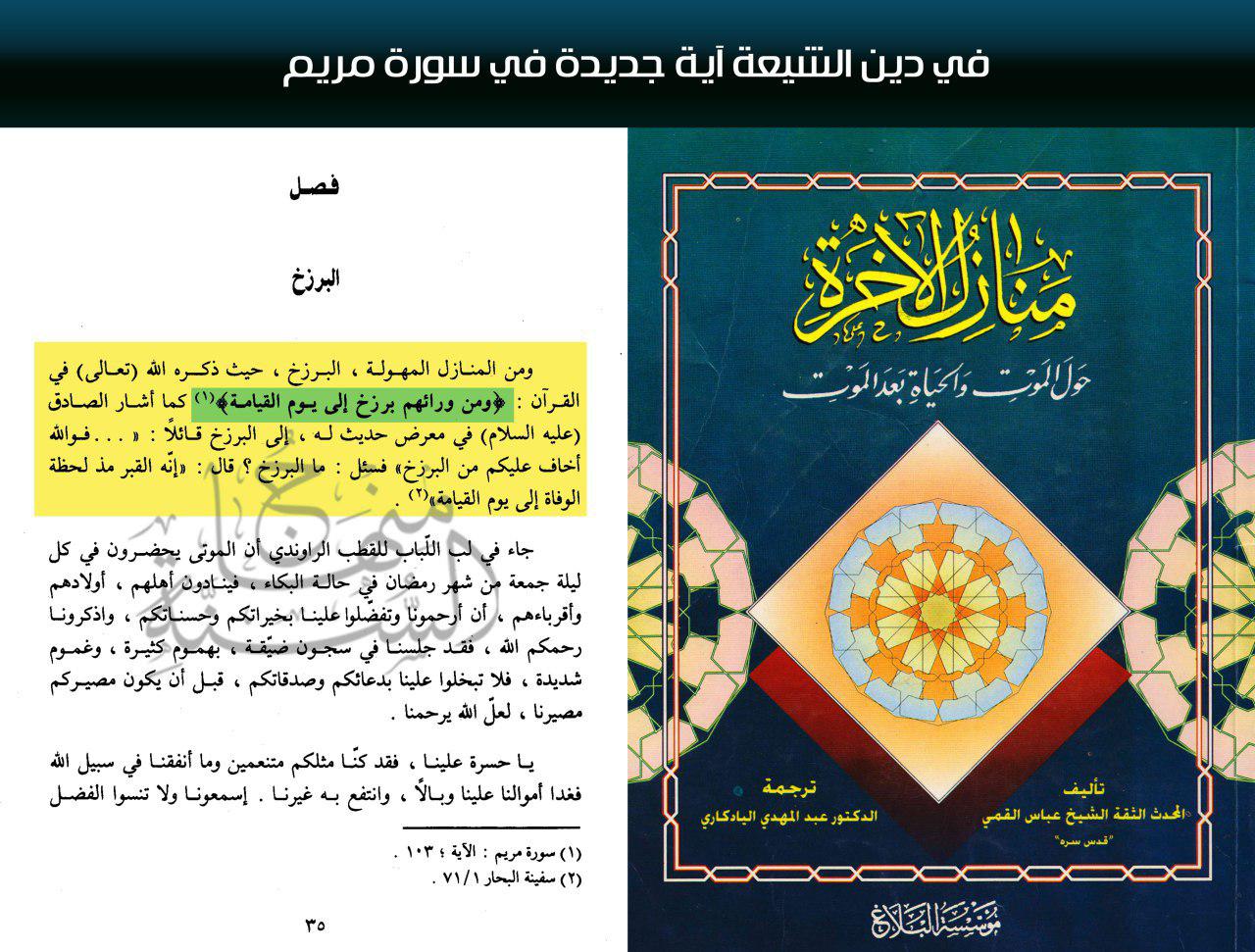تُعدُّ أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها- من أجلّ نساء الأمة وأكثرهن علمًا وفضلاً، وقد خصها الله بمكانة لم تبلغها امرأة سواها، فهي زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة، والمبرأة من فوق سبع سماوات. وعلى الرغم من هذه المنزلة الرفيعة، لم تسلم أم المؤمنين من سهام الطاعنين والمغرضين، وعلى رأسهم "الفرقة الضالة" التي اتخذت من الطعن في الصحابة الكرام وسيلة لهدم أصول الدين. ومن أبرز الشبهات التي يثيرونها هي اتهامها بمخالفة أمر الله والتبرج تبرج الجاهلية بخروجها إلى البصرة للمطالبة بدم الخليفة عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، وهو الخروج الذي أدى إلى وقوع موقعة الجمل. يهدف هذا المقال إلى تفكيك هذه الشبهة وبيان زيفها، من خلال إثبات أن خروجها كان اجتهادًا شرعيًا خالصًا لغاية الإصلاح بين المسلمين، وأن هذا الخروج لم يكن تبرجًا بأي حال من الأحوال، بل كان مع محرم، كما سيوضح المقال العلاقة الطيبة التي كانت تربط أم المؤمنين بالإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، مما ينفي تهمة العداوة التي يروج لها الطاعنون، مؤكدًا على عدالة أم المؤمنين وصحة مروياتها التي هي جزء أصيل من السنة النبوية المطهرة.
أولاً: الشبهة
يزعم بعض الطاعنين أن السيدة عائشة -رضي الله عنها- خالفت أمر ربها وتبرجت تبرج الجاهلية، حين خرجت تطالب بدم عثمان -رضي الله عنه-، وقد أمرها ربها بالاستقرار في البيت في قوله سبحانه وتعالى: "﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾" (الأحزاب: 33)، وجعل خروجها من بيتها تبرجًا من تبرج الجاهلية الأولى: "﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾" (الأحزاب: 33). وقد أدى خروجها إلى وقوع الفتنة بين المسلمين، متوهمين أنها ما خرجت إلا عداءً لعلي -رضي الله عنه-، إذ إنها كانت حريصة على تدعيم موقفها السياسي، وإن استوجب ذلك وقوع خلاف بينها وبين بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كما حدث بينها وبين علي -رضي الله عنه-. يرمون من وراء ذلك كله إلى الطعن في عدالتها -رضي الله عنها- تمهيدًا للطعن فيما آتانا عنها من السنة.
ثانيًا: الرد على الشبهة
السفر لضرورة شرعية لا ينافي القرار في البيت
إن أصحاب هذه الشبهة قد استخدموا الدليل في غير موضعه؛ إذ يجدر بنا في البداية أن نفهم معنى "التبرج" الوارد في الآية، ثم نُمعن النظر في موقف السيدة عائشة -رضي الله عنها- لنستطيع الحكم بإنصاف ونجيب على سؤال مهم وهو: هل حقًا خالفت السيدة عائشة -رضي الله عنها- أمر ربها وتبرجت؟!! أم أنه ادعاء واهٍ يفتضح أمره من أول وهلة.
يقول ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله سبحانه وتعالى: "﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾": "أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة" [1]، وخاطبهن بذلك تشريفًا لهن [2].
ويقول الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله سبحانه وتعالى: "﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾" (الأحزاب: 33): هذا أمر خُصصن به، وهو وجوب ملازمتهن بيوتهن توقيرًا لهن، وتقوية لحرمتهن، فقرارهن في بيوتهن عبادة... ومحمل هذا الأمر على ملازمة بيوتهن فيما عدا ما يُضطر فيه الخروج مثل موت الأبوين [3].
وقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "«قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن»" [4]، يريد حاجات الإنسان.
وقد أشكل على الناس خروج عائشة إلى البصرة في الفتنة التي تُدعى: وقعة الجمل. والذي عليه المحققون مثل أبي بكر بن العربي أن ذلك كان منها "اجتهادًا"، فإنها رأت أن في خروجها إلى البصرة مصلحة للمسلمين لتسعى بين فريقي الفتنة بالصلح؛ فإن الناس تعلقوا بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة، ورجوا بركتها أن تخرج فتُصلح بين الفريقين، وظنوا أن الناس يستحيون منها، فتأولت لخروجها مصلحة تفيد إطلاق القرار المأمور به في قوله سبحانه وتعالى: "﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾"، وأخذت بقوله سبحانه وتعالى: "﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ ۖ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾" (الحجرات: 9)، ورأت أن الأمر بالإصلاح يشملها وأمثالها ممن يُرجى سماع الكلمة، فكان ذلك منها عن اجتهاد [3].
"التبرج" هو التكشف والظهور للعيون، أو هو: إظهار المرأة محاسن ذاتها وثيابها وحليها بمرأى الرجال [5]، وحقيقته إظهار ما ستره أحسن. والمقصود بـ ""تبرج الجاهلية الأولى"" ما كان يحدث من النساء؛ إذ كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال، أو هو: كون النساء يتمشين بين الرجال [6].
فهل يصدق عاقل أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وهي المرأة الطاهرة النقية تفعل مثل هذا، وهي التي برأها الله -سبحانه وتعالى- بوحي من السماء يُقرأ إلى يوم القيامة؟!
وقد رد ابن تيمية على الذين يزعمون أن أم المؤمنين عائشة تبرجت تبرج الجاهلية الأولى عندما خرجت من دارها، حيث يقول: "فهي -رضي الله عنها- لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج والعمرة، أو خرجت مع زوجها في سفره... فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت في ذلك" [7].
ومما يدعم هذه الرؤية: ما رواه الطبري أن عثمان بن حنيف -والي البصرة من قبل علي- أرسل إلى عائشة -رضي الله عنها- يسألها عن سبب قدومها البصرة، فقالت: "والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم... فخرجت في المسلمين أُعلمهم ما أتى هؤلاء القوم، وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا، وقرأت: "﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾" (النساء: 114)، فنهض في الإصلاح ممن أمر الله -عز وجل- وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- الصغير والكبير، والذكر والأنثى" [8].
خروجها كان بدافع الإصلاح لا العداوة لعلي -رضي الله عنه-
لقد تبين أن موقف السيدة عائشة، وكذلك باقي الصحابة -رضي الله عنهم- من علي -رضي الله عنه-، وخروجهم إليه في البصرة لم يكن المراد منه قتال علي، بل كان مرادهم الإصلاح والطلب بدم عثمان.
ومما يرد القول بوجود عداء بينها -رضي الله عنها- وبين علي -رضي الله عنه- ما ثبت عن أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- من أنه أقر عائشة -رضي الله عنها- على قولها إثر معركة الجمل؛ حيث قالت تصف علاقتها بالإمام علي: ""والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها"" [9]، فقال علي -رضي الله عنه-: ""صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك"" [10].
"ومن الأدلة على العلاقة الطيبة بينهما:"
◘ روت حديث الكساء في فضل علي، وفاطمة، والحسن، والحسين -رضي الله عنهم- [11].
◘ كثيرًا ما كانت تُحيل السائل إلى علي -رضي الله عنه- ليجيبه؛ فقد أحالت شريح بن هانئ لما سألها عن المسح على الخفين إلى علي -رضي الله عنه- وقالت له: "«عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم»" [12].
◘ طلبت من الناس بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- أن يلزموا عليًا -رضي الله عنه- ويبايعوه [13].
ولذلك قال الأحنف بن قيس: لقيت طلحة والزبير -رضي الله عنهما- بعد حصر عثمان -رضي الله عنه- فقلت: ما تأمراني فإني أراه مقتولًا؟ قالا: "عليك بعلي". قال: ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكة، فقلت: ما تأمريني؟ قالت: "عليك بعلي" [14].
ولقد كان علي -رضي الله عنه- على علم بهذا الأمر؛ لذا فقد ردها إلى مأمنها معززة مكرمة، وجهزها بكل شيء ينبغي لها، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وقال علي -رضي الله عنه- وهو يودعها: ""يا أيها الناس، صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة"" [15].
براءة عائشة من تهمة العداء لعلي بسبب حادثة الإفك
وقد خالف الصواب من ظن أن خروج أم المؤمنين إلى البصرة كان لشيء في نفسها من علي، لموقفه منها في حديث الإفك، حين رماها المنافقون بالفاحشة فاستشاره النبي -صلى الله عليه وسلم- في فراقها، فقال: "«يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك»" [16].
وهذا الكلام الذي قاله علي إنما حمله عليه ترجيح جانب النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان شديد الغيرة، فرأى علي -رضي الله عنه- في بادئ الأمر أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها، إلى أن تتحقق براءتها، فيمكن رجعتها [17].
وبظهور براءة عائشة -رضي الله عنها- بوحي نزل من السماء وقرآن يُتلى إلى يوم القيامة، تطيش هذه الشبهة، كما تتأكد عندنا عدالة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وصحة مروياتها؛ إذ إنها المُبرأة من قبل الله -عز وجل- ومن قبل جميع الصحابة وعلى رأسهم علي -رضي الله عنه- الذي قال لها وهو يودعها بعد موقعة الجمل المشهود لها: ""إنها لزوجة نبيكم -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة"".
الخلاصة
◘ إن خروج السيدة عائشة -رضي الله عنها- كان من أجل "الإصلاح بين الناس"، وليس في هذا تعارض مع الآية الكريمة: "﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾"، إذ إن معناها: الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، والإصلاح في هذا الوقت كان من أهم الضرورات والحاجات.
◘ لم تخرج السيدة عائشة -رضي الله عنها- لقتال، وإنما ظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، وقد خرجت مع "محرم لها" (عبد الله بن الزبير ابن أختها)، ثم إنها رجعت في ثلاثين أو أربعين امرأة قرنهن بها الإمام علي -رضي الله عنه-، وهذا ينفي عنها تهمة التبرج.
◘ لقد كانت السيدة عائشة -رضي الله عنها- على "علاقة طيبة بعلي" أمير المؤمنين -رضي الله عنه-، ولم يحدث قط أنها أبطلت خلافته ولا طعنت عليه، بل كانت تروي فضائله وتحيل السائلين إليه.
المصادر والحواشي:
[1] تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، 1400هـ/ 1980م، (6/ 245).
[2] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (4/ 79).
[3] التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (22/ 10: 12).
[4] صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: خروج النساء لحوائجهن، (9/ 249)، رقم (5237). صحيح مسلم (بشرح النووي) كتاب: السلام، باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، (8/ 3290، 3291)، رقم (55649).
[5] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (12/ 309). التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (22/ 12) بتصرف.
[6] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (14/ 179، 180).
[7] منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، ابن تيمية، تحقيق: محمد أيمن الشبراوي، دار الحديث، القاهرة، 1425هـ/ 2004م، (4/ 144).
[8] أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب، علي محمد محمد الصلابي، دار الإيمان، مصر، 2003م، ص460، 485، 486 بتصرف.
[9] تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، (3/ 31).
[10] تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص61.
[11] صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، (8/ 3556)، رقم (6144).
[12] صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين، (2/ 809)، رقم (627).
[13] حقبة من التاريخ، عثمان بن محمد الخميس، مكتبة الإمام البخاري، القاهرة، ط3، 1427 هـ/ 2006م، ص176 بتصرف.
[14] فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (13/ 38).
[15] أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، د. علي محمد محمد الصلابي، دار الإيمان، مصر، 2003م، ص532.
[16] صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: التفسير، باب: ﴿لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا﴾، (8/ 306)، رقم (4750).
[17] دور المرأة السياسي في عهد النبي والخلفاء الراشدين، أسماء محمد أحمد، نقلاً عن: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، د. علي محمد محمد الصلابي، دار الإيمان، مصر، 2003م، ص532.