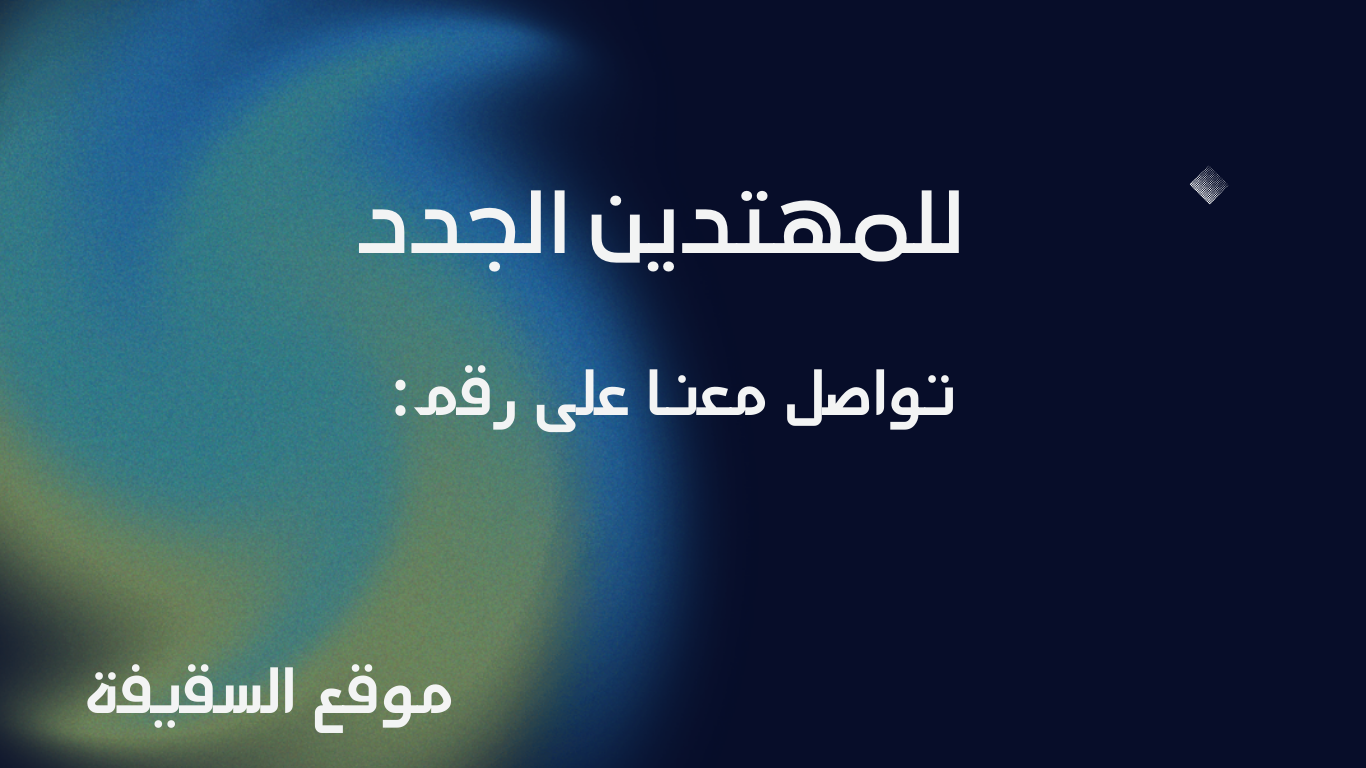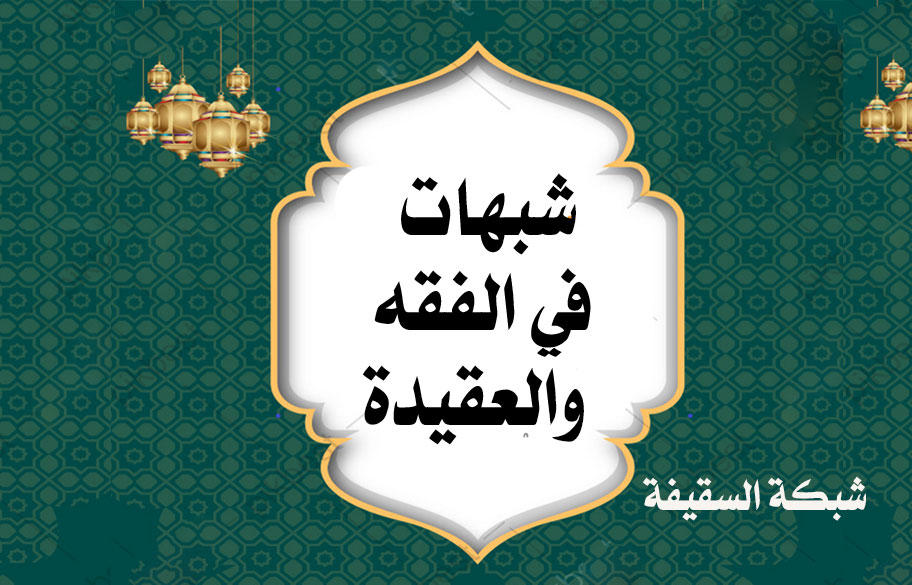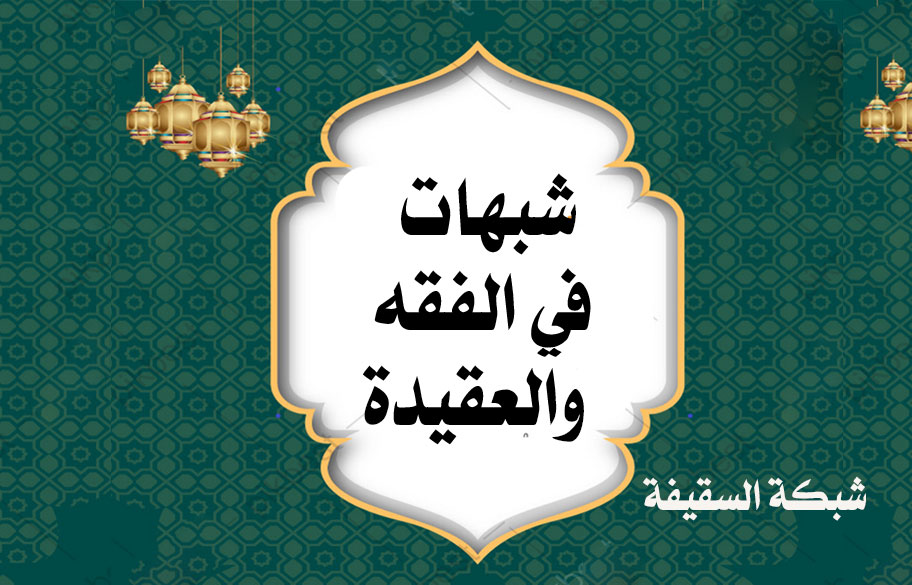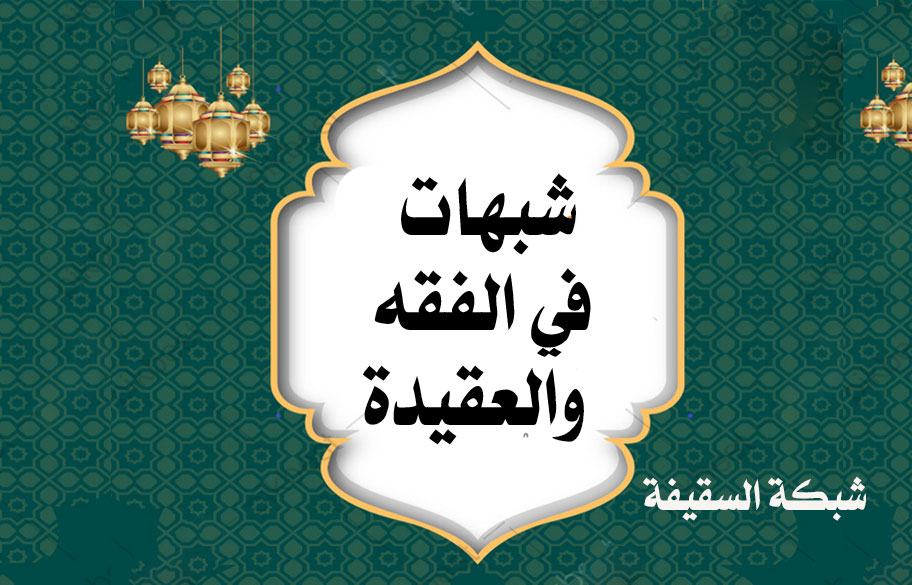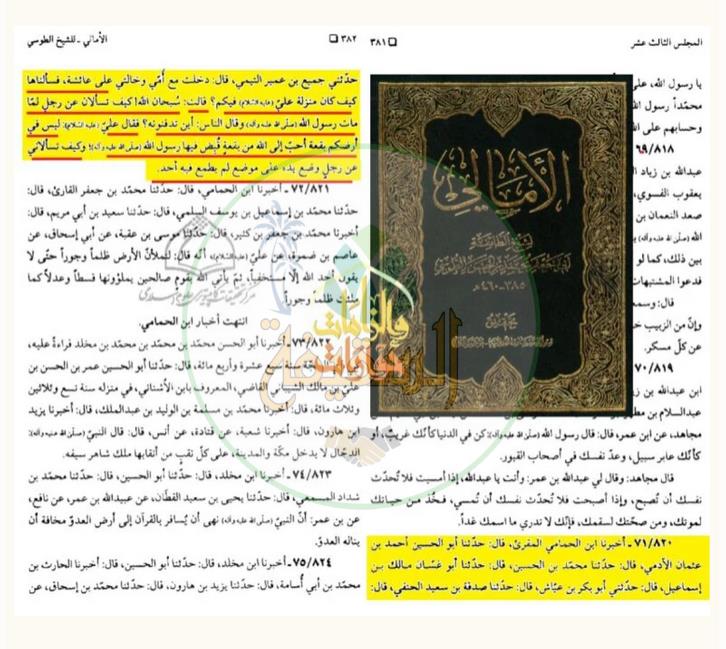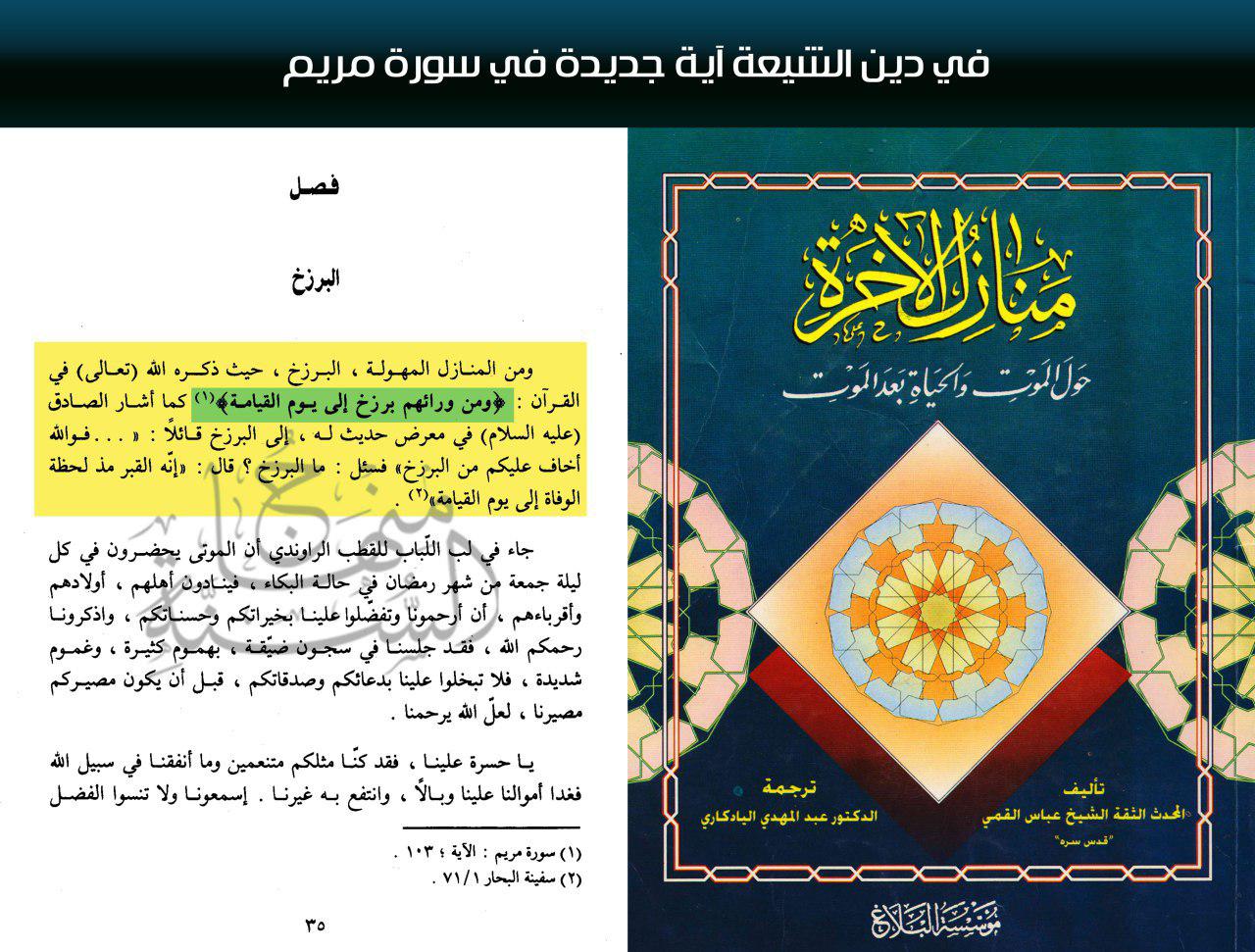كثُر في الأزمنة المتأخرة مَن يطعن في أصحاب النبيِّ ﷺ، ويتَّخذ من أحداث الفتنة التي وقعت بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه سبيلًا للتشكيك في عدالتهم وأمانتهم في نقل الدين. وهذه الدعوى القديمة الجديدة يروِّجها أصحاب الأهواء والفرق الضالَّة – وفي مقدمتهم الشيعة – بغيةَ النَّيل من الصحابة الذين حملوا إلينا القرآن والسنة.
وحقيقةُ الأمر أن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلافٍ سياسيٍّ بعد مقتل عثمان كان من مسائل الاجتهاد التي لا تمسُّ عدالتهم، إذ لم يكن تنازعًا على سلطانٍ أو دنيا، بل اجتهادًا في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. وقد أجمع أهل السنَّة على عدالتهم، وعدُّوا ما وقع بينهم من الفتن داخلًا في باب الاجتهاد المغفور خطؤه، بل المأجور عليه.
مضمون الشبهة
يدَّعي بعض المغرضين أنَّ أكثر الصحابة ليسوا عدولًا، مستدلين بما حدث بينهم من خلافاتٍ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، خصوصًا ما جرى بين عليٍّ ومعاوية رضي الله عنهما من قتالٍ، زاعمين أنَّه كان تنافسًا على السُّلطة، وأنَّ وقوع القتال يستلزم خطأ بعضهم، ومن ثمَّ انتفاء عدالتهم.
وغايةُ هذه الشبهة: إسقاط الثقة بالصحابة، تمهيدًا للطعن في السنة النبوية التي نُقلت عن طريقهم.
وجها إبطال الشبهة
الوجه الأول: اختلاف الصحابة كان عن اجتهاد وتأويل
إنَّ ما وقع من خلافٍ بين الصحابة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان اختلافًا في تقدير المصلحة الشرعية، لا طعنًا في الدين ولا طلبًا للدنيا. فقد اجتهد كلٌّ منهم فيما رآه أقرب إلى الحق، والمجتهد مأجورٌ على كل حال، كما قال النبي ﷺ:
«إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (رواه البخاري رقم 7352).
ففريق عليٍّ رضي الله عنه كان مصيبًا في اجتهاده، وفريق معاوية رضي الله عنه كان مجتهدًا مأجورًا وإن أخطأ.
وكان سبب الخلاف أنَّ معاوية – وهو والي الشام وابنُ عم عثمان – رأى وجوبَ الاقتصاص من قتلة عثمان قبل مبايعة عليٍّ، بينما رأى عليٌّ رضي الله عنه تأخير القصاص حتى تهدأ الفتنة وتستقر الدولة، لأن قتلة عثمان لم يُعرفوا بأعيانهم بعد، وخشي أن يؤدِّي التعجُّل إلى مفسدةٍ أعظم.
وقد أوضح ابن حزم ذلك فقال:
"قاتل عليٌّ معاويةَ لامتناعه من تنفيذ أوامره في الشام، وهو الإمام الواجب طاعته، ولم ينكر معاوية فضل عليٍّ واستحقاقه الخلافة، وإنما رأى تقديم أخذ القِصاص على البيعة، فأخطأ في التقديم فقط" [2].
وقال ابن حجر:
"اتَّفق أهل السنَّة على منع الطعن في أحدٍ من الصحابة بسبب ما وقع بينهم، لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهادٍ، وقد عفا الله عن المجتهد المخطئ" [6].
ومن شواهد ذلك أن عليًّا نفسه صرَّح بأنَّ خروجه كان عن رأيٍ واجتهاد، لا عن أمرٍ خاصٍّ من النبي ﷺ، فقال لما سُئل: «أعهدٌ عهدَه إليك رسول الله ﷺ أم رأيٌ رأيتَه؟ قال: ما عهد إليَّ رسول الله شيئًا، ولكنه رأيٌ رأيتُه» (رواه أبو داود وصححه الألباني) [3].
وكذلك معاوية رضي الله عنه قال لأبي مسلم الخولاني:
"إني أعلم أن عليًّا أفضل وأحقُّ بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلومًا، وأنا ابنُ عمِّه، أطلبُ بدمه؟" [4].
فلم يكن الخلاف على الخلافة، بل على تقدُّم القصاص أو تأخيره، وكلٌّ منهما اجتهد في أمرٍ محتملٍ شرعًا.
وقد بيَّن ابن تيمية أنَّ القتال في مثل هذه الفتن لا يخرج الصحابة عن العدالة، لأنهم ما أرادوا إلا نُصرةَ الدين بحسب ما ظهر لهم، وأن الله تعالى قال:
﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (سورة النساء: 94).
فدلَّ على أنَّ الخطأ في التأويل لا يرفع عن صاحبه وصفَ الإيمان ولا العدالة.
كما أنَّ كثيرًا من أكابر الصحابة اعتزلوا الفتنة؛ قال محمد بن سيرين:
"هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ عشرة آلاف، فما حضرها منهم مائة، بل لم يبلغوا ثلاثين" [17].
فكان جمهور الصحابة بعيدين عن القتال، وحاضرُوه اجتهدوا فيما رأوا.
الوجه الثاني: الخلافات السياسية لم تؤثر في رواية الحديث
لم يؤثر ما وقع من الفتن بين الصحابة على نقلهم للسنَّة، إذ ثبت بالاستقراء أنَّ روايات من شاركوا في الفتنة لا تختلف في شيءٍ عمَّا رواه غيرهم من الصحابة.
وقد تتبَّع العلَّامة محمد بن الوزير اليماني أحاديثَ معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، فوجد أنهم لم ينفردوا برواية ما يخالف ما ثبت عن غيرهم، بل كانت أحاديثهم مؤيدةً للسُّنة الثابتة [12][13].
قال ابن الوزير:
"هذه عامة أحاديث معاوية التي في الكتب الستة، وهي موافقة لمذهب الفقهاء، وليس فيها ما لم يذهب إليه جمهور العلماء" [13].
وأضاف: "لم يروِ معاوية شيئًا قط في ذمِّ عليٍّ، ولا في استحلال حربه، مع شدَّة الحاجة إلى ذلك لو كان باطلًا، فدلَّ على صدقه وعدالته" [14].
وهذا برهانٌ عقليٌّ قاطع على أنَّ اختلافهم السياسي لم يمسَّ دينهم، ولا نزاهتهم في نقل السنة، وقد روى عن معاويةَ عددٌ من أكابر الصحابة والتابعين، مثل ابن عباس وابن الزبير وسعيد بن المسيَّب، ولو كان عندهم متَّهمًا بالكذب لما رووا عنه.
ولهذا قال الإمام الجويني رحمه الله:
"التوقُّف في تعديل من لابس الفتنة باطلٌ من دين الأمة، لأن إجماع العلماء على تحسين الظنِّ بهم وردِّهم إلى سوابقهم في الإسلام" [16].
فالعدالة التي أثبتها الله ورسوله للصحابة لا تزول بخطأٍ اجتهاديٍّ ولا باجتهادٍ سياسيٍّ في ظروفٍ معقَّدة، قال تعالى:
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (سورة الفتح: 18).
وقال أيضًا: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (سورة الفتح: 29).
فإذا شهد الله لهم بالإيمان والرضا، فكيف يُظنُّ بهم الكذب في نقل الوحي؟!
خلاصة القول
1- ما وقع بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كان عن اجتهادٍ وتأويلٍ، لا عن طلب دنيا.
2- كان عليٌّ رضي الله عنه مصيبًا في اجتهاده، ومعاوية رضي الله عنه مخطئًا مأجورًا.
3- الخطأ في الاجتهاد لا يُنافي العدالة؛ إذ العدالة لا تعني العصمة من الخطأ.
4- الخلافات السياسية لم تؤثر في الرواية عن النبي ﷺ، ولم تتضمَّن أي كذبٍ أو تحريفٍ للسُّنة.
5- أحاديث معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة رضي الله عنهم موافقةٌ لما رواه غيرهم، ولم ينفردوا بشيءٍ يخالف الشريعة.
6- إجماع الأمة على عدالة الصحابة شاملٌ لكلِّ من شارك في الفتنة أو اعتزلها.
7- من طعن في الصحابة إنما يطعن في الدين كلِّه، لأنهم حملة الوحي وشهود التنزيل.
الخاتمة
إنَّ الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم كانت فتنةَ اجتهادٍ وتأويلٍ، لا فتنةَ دنيا أو جاه. وقد عذر الله المخطئ فيها، وأثاب المصيب، كما قال النبي ﷺ في المجتهدين.
وعدالتهم ثابتةٌ بنصوص الكتاب والسنة، وبإجماع الأمة على تعديلهم. وقد بيَّنت الدلائل العقلية والنقلية أنَّ ما جرى بينهم لا يُنقص من مكانتهم، بل يُثبت عظيم إخلاصهم وحرصهم على الحقِّ.
ولئن أخطأ بعضهم في اجتهاده، فذلك لا يُسقط عدالته ولا يُضعف أمانته، بل يظلُّ الصحابة جميعًا رضوان الله عليهم خيرَ القرون، قال ﷺ:
«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (متفق عليه).
المصادر:
- ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل.
- ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري.
- الذهبي، تاريخ الإسلام.
- ابن الوزير اليماني، الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم.
- الجويني، البرهان في أصول الفقه.
- ابن تيمية، منهاج السنة النبوية.
- نور الدين عتر، السنة المطهرة والتحديات.
- عثمان الخميس، حقبة من التاريخ.
- محمد أمحزون، تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة.
- محمد عجاج الخطيب، السنة قبل التدوين.
- أحمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث.
_______________________________________
[1] تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة، محمد أمحزون، ص 517–518.
[2] الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، 4/240–241.
[3] سنن أبي داود، رقم (4652)، وصححه الألباني.
[4] تاريخ الإسلام، الذهبي، 3/540.
[5] حقبة من التاريخ، عثمان الخميس، ص 186.
[6] فتح الباري، ابن حجر، 13/37.
[7] السنة المطهرة والتحديات، نور الدين عتر، ص 24.
[8] فتح الباري، 13/37.
[9] صحيح البخاري، رقم (4141).
[10] حقبة من التاريخ، ص 183–184.
[11] صحيح البخاري، رقم (7352).
[12] السنة المطهرة والتحديات، ص 24–25.
[13] الروض الباسم، ابن الوزير، 2/118.
[14] الروض الباسم، 2/119.
[15] الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، 2/315.
[16] البرهان في أصول الفقه، الجويني، 1/406.
[17] منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، 6/129.
[18] الباعث الحثيث، أحمد شاكر، ص 155.
[19] السنة قبل التدوين، محمد عجاج الخطيب، ص 404.