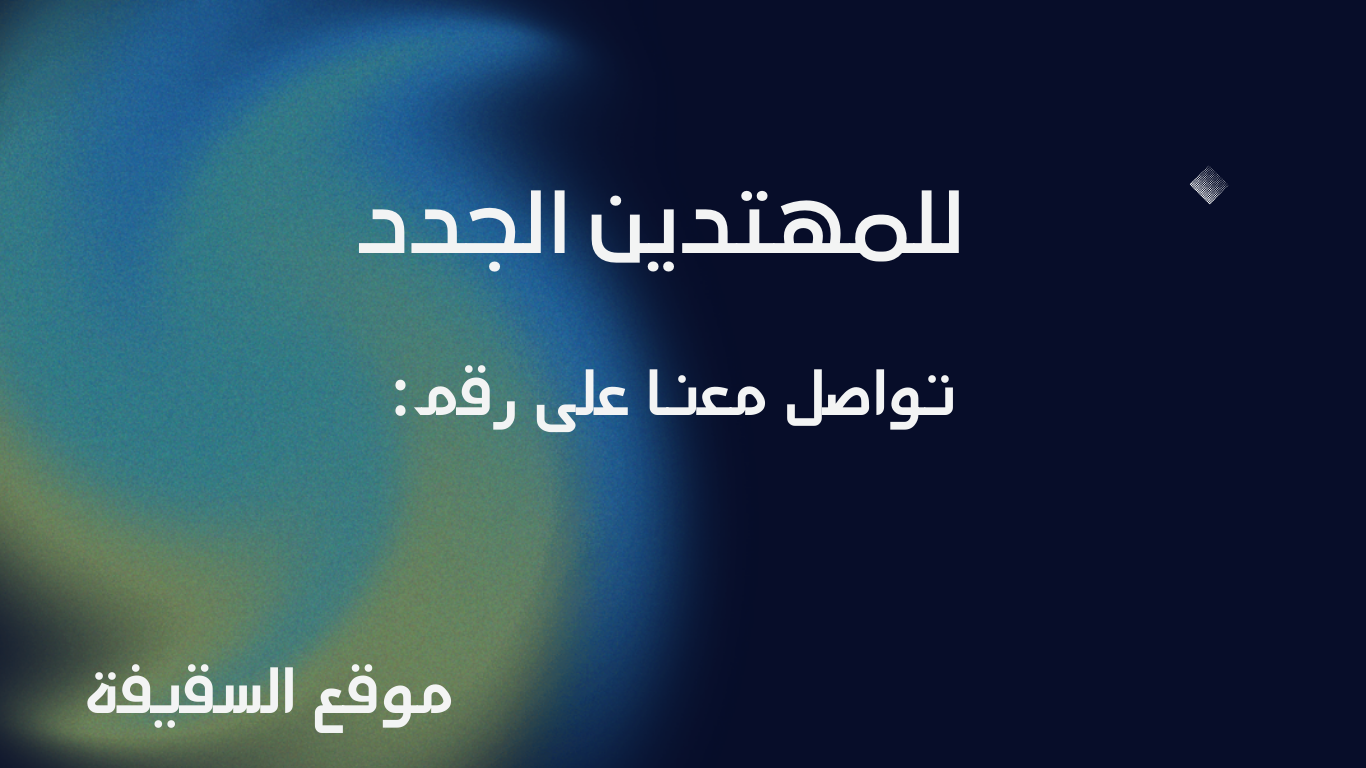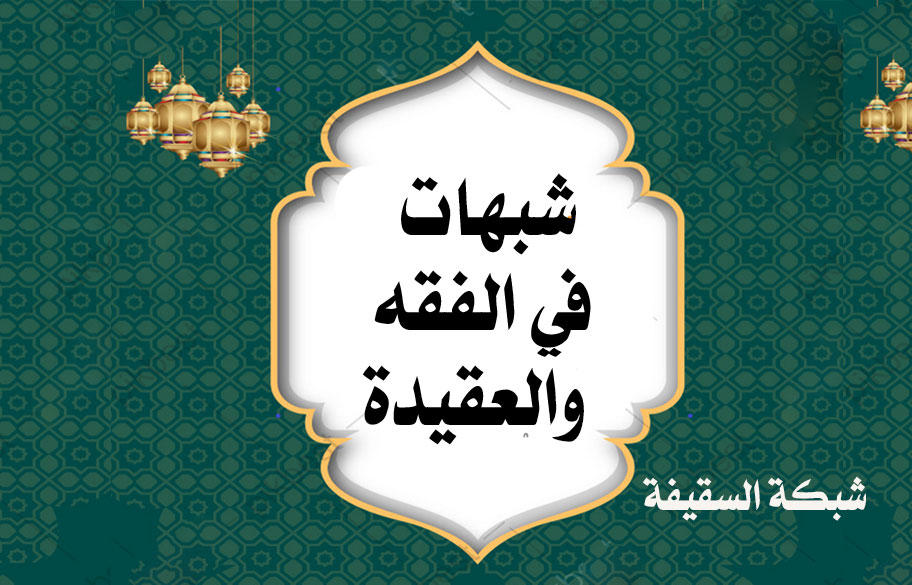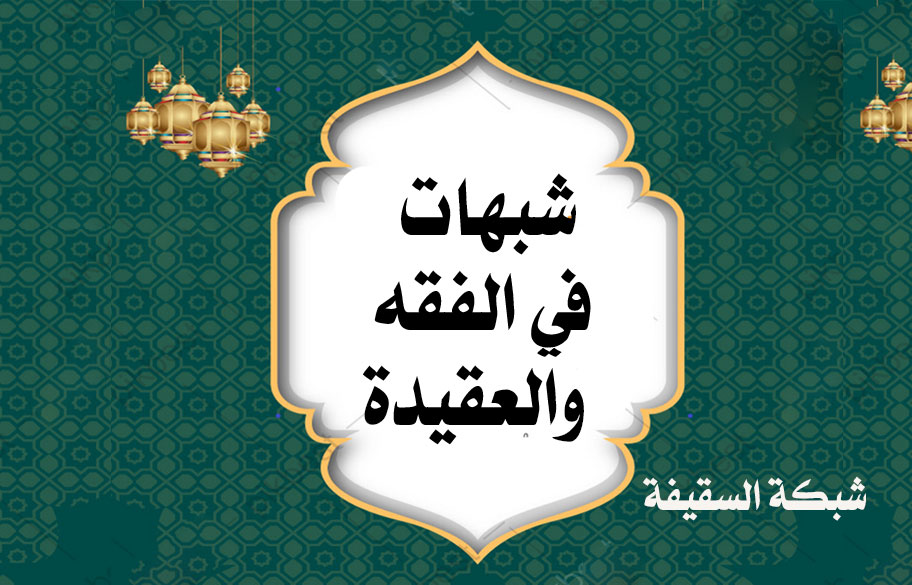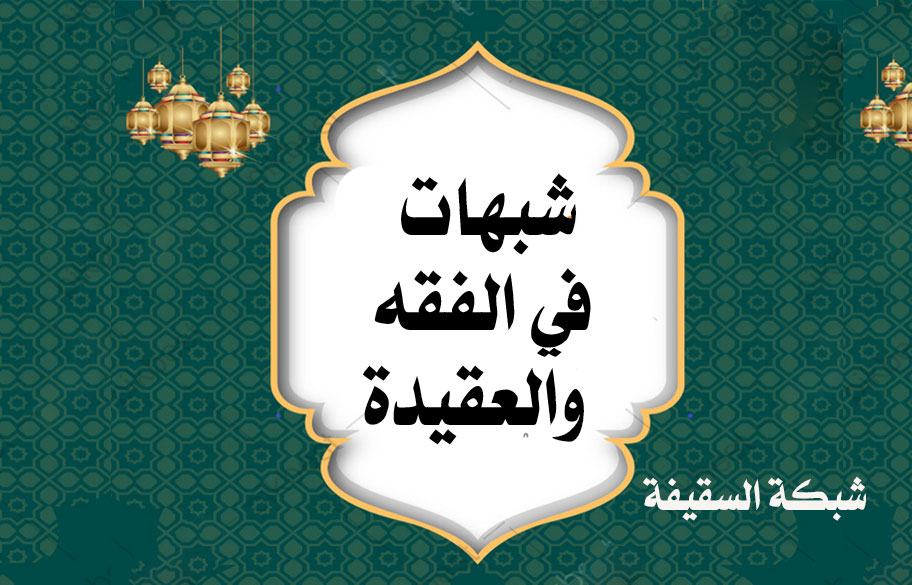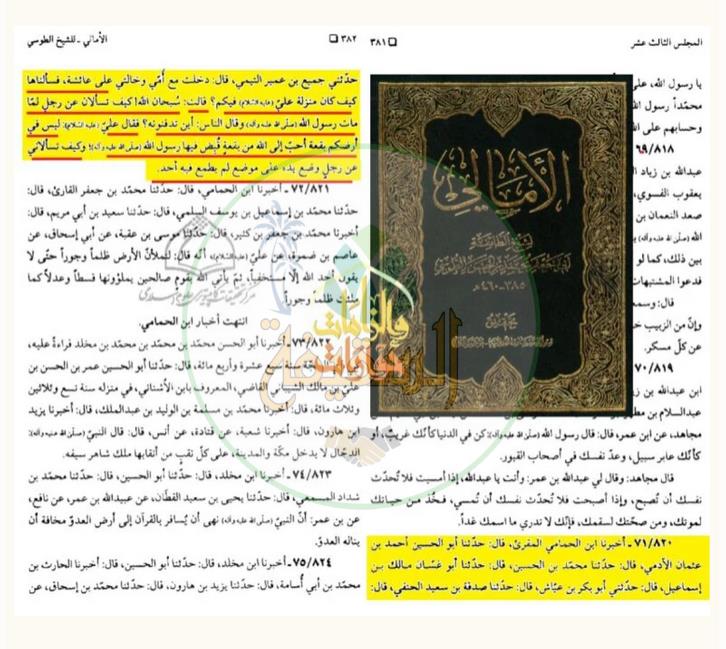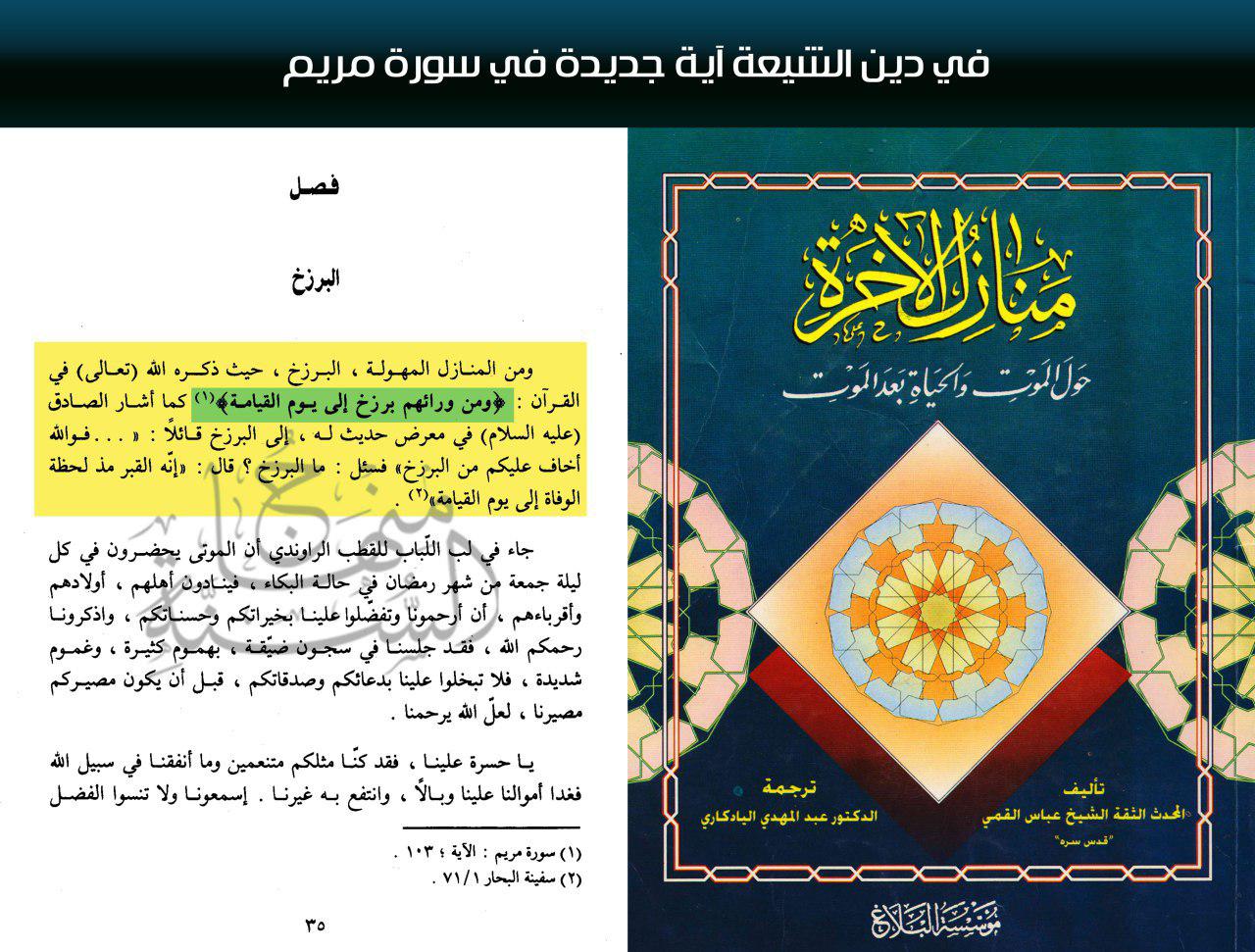"الشيعة بين الواقع والنص: فضح الأكاذيب حول العصمة والإمامة"
تستمر فرقة الشيعة في صناعة أحاديث موضوعة وغير صحيحة لتحقيق أهداف سياسية ودينية، محاولةً فرض عقائد مخالفة للقرآن والسنة. هؤلاء لا يمثلون المسلمين الصحيحين، بل يُصنفون كفرقة ضالة تبني معتقداتها على الاستنتاجات الظنية والتكلف في التأويل، بعيداً عن نصوص الكتاب والسنة. في هذا المقال نكشف زيف هذه الادعاءات، ونتناول بالأدلة القرآنية والمنطقية كيف أن الاحتجاج بالآيات على العصمة المطلقة أو الإمامة الخاصة لأحد الأشخاص، مثل علي بن أبي طالب، لا أساس له في القرآن، وأنه مجرد استنتاج باطل يهدف لتزوير التاريخ الإسلامي وإسقاط مكانة الخلفاء الراشدين.
وهذا التقرير استنتاج وليس نصاً صريحاً. والأصول مبناها على النصوص الصريحة وليس على الاستنتاج أو الاستنباط.
إن هذا المعنى بعيد جداً عن النص ولا يخطر على البال مهما تفكر فيه القارئ إلا إذا كان في ذهنه من البداية وهو يلف ويدور يبحث له عما يؤيده من النصوص المشتبهة والمحتملة ولو بتكلف شديد.
إن الأمر مبني على أن لفظ (الظالمين) يشمل كل من كان قد سبق منه ظلم
-شركاً كان أم معصية- وإن تاب وأصلح.
يقول محمد حسين الطباطبائي في تفسيره (الميزان):
أن المراد بالظالمين في قوله تعالى: ﴿ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾ مطلق من صدر عنه ظلم ما من شرك أو معصية. وإن كان منه في برهة من عمره ثم تاب وصلح. أهـ
إن أول ما يبطل هذا القول أن تعرف أنه دعوى بلا دليل. فإن لفظ (الظالمين) جمع (ظالم) والظالم اسم للمتلبس بالظلم المقيم عليه أما من تاب وانخلع منه فلا يسمى ظالما وإلا لم يدخل أحد من التائبين الجنة لأنهم (ظالمون)، والله تعالى يقول: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾ (هود/18) وتوعدهم بالعذاب فقال: ﴿إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها﴾ (الكهف/29) ومثله في القرآن كثير.
فكيف يصح أن يقال: (إن المراد بالظالمين في هذه الآية مطلق من صدر عنه ظلم ما من شرك أو معصية وإن كان منه في برهة من عمره ثم تاب وصلح)؟! إذن كل المسلمين في النار!
ولا شك أن قولاً هذه نتيجته هو من أفسد الأقوال وأبطلها. فبطل ما بني عليه من (العصمة) و(الإمامة) عموماً. و(عصمة) و(إمامة) أحد من الناس بعينه خصوصاً.
إن هذا لا نعرفه من شرعنا ولا لغتنا ولا العقل يقر به:
إن التائب من الذنب -في شرعنا- كمن لا ذنب له، والله تعالى يقول: ﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيماً﴾ (الفرقان/70).
فهل يصح أن يطلق على هؤلاء اسم (الظالمين) حتى يصح أن نسمي بذلك (مطلق من صدر عنه ظلم ما من شرك أو معصية وان كان منه في برهة من عمره ثم تاب وصلح)؟!
إنه ليس أكثر من محاولة يائسة لإخراج أبي بكر الصديق وغيره من الخلفاء من شرف الإمامة واستحقاق الخلافة بدعوى أنه كان مشركاً فهو من (الظالمين) وإن تاب، (لأن المراد بالظالمين في الآية مطلق من صدر عنه ظلم ما …الخ).
إن (الظالم) اسم مشترك بين المشرك أو الكافر الخارج عن الملة، وبين الفاسق أو العاصي المسرف على نفسه من أهل الملة ما دام مقيماً على فسقه وعصيانه.
وهو اسم يشمل من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وغلبت سيئاته على حسناته وهؤلاء لا يكونون أئمة يقتدى بهم ما داموا مقيمين على ما هم عليه.
- وذلك كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾: وهو الذي اجترح من السيئات، وترك من الواجبات ما صار به مقصراً عن درجة النجاح.
- ﴿ومنهم مقتصد﴾: وهو من ترك ما استطاع من السيئات، وعمل بما استطاع من الواجبات.
- ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ (فاطر/32) وهو الذي عمل على قدر استطاعته فأتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والشبهات والمكروهات.
فالإمامة مقصورة على الصنفين الأخيرين دون الصنف الأول.
- ومثله قوله تعالى وهو يذكر إبراهيم عليه السلام: ﴿وباركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين﴾ (الصافات/113).
هذا هو مقصود آية إبراهيم. فما علاقة (العصمة) بها؟!
إن الله تعالى لم يقل: ﴿لا ينال عهدي من ظلم﴾ حتى يمكن أن يحمل –ولو بتكلف- على من ظلم ولو مرة واحدة على اعتبار أن الفعل الماضي يفيد الحدوث مرة واحدة، بينما الفعل المضارع يفيد تكرار الحدوث.
إنما قال: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ والاسم في اللغة يفيد الثبوت والدوام فلا يشمل إلا من ثبت وداوم على ظلمه دون من تاب وأصلح. فأبو بكر وعمر وعثمان حينما تولوا أمر الأمة لم يتولوه وهم ظالمون، وإنما تولوه وهم مؤمنون صالحون، سماهم الله تعالى بالسابقين الأولين والصادقين والمفلحين والفائزين …الخ.
الخطيئة السابقة لا تناقض الإمامة:
ويؤيد ذلك أن آدم عليه السلام نصص الله على (جعله) خليفة بقوله تعالى:﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة/30) وهو يشمل آدم قطعاً، فآدم أول خليفة وأول إمام، وقد أسجد الله تعالى له ملائكته، فالملائكة -فما دون- تبع لآدم. وهذه الإمامة هي السبب في حسد إبليس وعداوته له، كما حسد الفرس العرب على إمامتهم ورئاستهم التي ابتدأت بالصديق.
وقد اصطفاه الله تعالى فقال: ﴿إن اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبراهيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران/33). والاصطفاء مما يحتج بها الإمامية على (الإمامة) ومع هذا صرح الله تعالى بذكر ظلمه ومعصيته، وأنه كان وزوجه من (الظالمين) في عدة مواضع من القرآن:
◘ منها ما جاء في سياق ذكر خلافته وهو قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ (البقرة/35).
وقد أكلا من الشجرة فكانا من الظالمين واعترفا صراحة بتحقق وصف الظلم فيهما، وذلك في قوله تعالى عنهما: ﴿قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف/23).
◘ وقال أيضاً: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (طه/121).
◘ وقال: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما﴾ (طه/115).
وفيه ذكر العهد. فالعهد نال آدم رغم ظلمه السابق لأنه تاب واستغفر وأناب كما قال سبحانه: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة/37).
فهو ليس من (الظالمين) الذين لا ينالهم عهد الله.
وكذلك داود عليه السلام الذي صرح الله تعالى بـ (جعله) خليفة في قوله: ﴿يَا دَاُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق ﴾ (ص/26). ولقد جاء هذا القول مباشرة بعد ذكر ارتكاب داود عليه السلام للخطيئة المذكورة في سورة (ص). والتي تبتدئ بقصة الخصمين اللذين تسورا عليه المحراب، وتنتهي بقوله تعالى: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (ص/24-25).
وكذلك سليمان عليه السلام وقد قال الله عنه: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ (ص/34-35).
وقبلها ذكر قصة انشغاله بالخيل حتى فاتته صلاة العصر. وجاء ذلك مصرحاً في رواية لابن بابويه القمي عن جعفر الصادق أنه قال: أن سليمان بن داود عليه السلام عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة ردوا الشمس علي حتى اصلي صلاتي في وقتها[1]. ما يدل على أن التوبة بعد الخطيئة لا تحرم العبد من الفضل أو الفضيلة. بل ترتفع به فيكون أقرب إلى الرب الذي ﴿يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾. ولولا الذنب لما حصلت التوبة والتطهر الذي به ينال العبد حب الرب. (ومن المعلوم أنه قد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع منه. ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضلاله وتاب بعد ذنوبه، فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام. فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولاده، وهل يشبِّه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل؟) [2] وهذا كله يتناقض مع تفسير علماء الإمامية للفظ (الظالمين) الذي بنوا عليه القول باشتراط العصمة من الآية.
مخالفة (العصمة) الشيعية لظاهر القرآن:
ثم أن عصمة الأنبياء المطلقة من الأخطاء والذنوب مخالفة لظاهر القرآن، ولا يمكن القول بها إلا على سبيل الظن بعد التكلف الشديد والتعسف الواضح في تأويل النصوص القرآنية لإخضاعها وجعلها ذيلاً تابعاً للآراء محكوماً بها لا حاكما عليها.
إنها قضية قالوها أولاً بعقولهم دون سند من صريح القرآن، ثم بحثوا لها فيه عما عساه يؤيدها. فجعلوا القرآن -كمتأخري خلفاء بني العباس- ليس له من الحكم والخلافة إلا الاسم والتاج والتواقيع التي تخرج باسمه. أما الحكم الحقيقي فهو للوزير والسلطان الأعجمي. فالخليفة تابع في صورة متبوع، وأما القرار فيتخذ من دونه، وهو لا أمر له ولا نهي سوى أنه -آخر الأمر- يضع عليه التوقيع ليخدعوا بتوقيعه الجمهور.
والشيء نفسه فعلوه مع القرآن: عقائدهم وقراراتهم تتخذ من دونه، وليس للقرآن أمر ولا نهي سوى أنهم يضعون لها -في آخر المراحل- توقيعاً باسمه ورسمه ليخدعوا بتوقيعه الجمهور. فالقرآن تابع في سورة متبوع، والله تعالى يقول: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ (الأعراف/3).
اقرأ قوله تعالى عن موسى عليه السلام حين قتل نفساً لا يحل قتلها: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (القصص/15-16). والآيات تصرح بارتكاب موسى عليه السلام لظلم قتل النفس وتوبته منه فكيف اختاره الله رسولاً إماما؟! وهل هناك أعظم ذنبا بعد الشرك من القتل؟!
فأين: العصمة المطلقة؟
وأين: من ارتكب ظلما في برهة من عمره فهو من (الظالمين) وإن تاب وصلح؟!
فموسى إذن لا ينبغي أن يناله عهد الله لأنه من (الظالمين)!
والقرآن فيه الكثير من الآيات التي تذكر للأنبياء أحوالا وأخطاء عاتبهم الله أو عاقبهم عليها ليس أقلها ذنب ذي النون عليه السلام الذي عاقبه الله عليه ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ (الصافات/142) أي مرتكب ما يلام عليه. وقد صرح الله بأنه صار بذلك من الظالمين فقال: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أن لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أن لاَ إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء /87). لكنه لما تاب رفعه وجعله إماماً لمائة ألف أو يزيدون. وبهذا يتبين بوضوح تام بطلان قولهم بأن الظالم من صدر عنه مطلق الذنب برهة من عمره وإن تاب وصلح.
بل أن كبار علماء ومفسري الإمامية أجازوا صدور الكفر والشرك من الأنبياء أول حياتهم معتمدين على ظاهر معنى بعض الآيات. من ذلك قوله تعالى:﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إبراهيم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِين فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (الأنعام/75-78).
ذكر الطوسي في تفسيره (التبيان) أربعة أوجه لمعنى الآية:
ملخص الوجه الأول والثاني بالنص: (إن هذا القول كان من إبراهيم في زمن مهلة النظر …فلما أكمل الله عقله وخطر بباله ما يوجب عليه النظر وحركته الدواعي على الفكر والتأمل له قال ما حكاه الله لأن إبراهيم عليه السلام لم يخلق عارفاً بالله وإنما اكتسب المعرفة لما أكمل الله عقله) أو (إن ما حكى الله عن إبراهيم في هذه الآية كان قبل بلوغ وكمال عقله ولزوم التكليف له غير أنه لمقاربته كمال العقل خطرت له الخواطر وحركته الشبهات والدواعي على الفكر فيما يشاهده من هذه الحوادث).
وملخص الوجه الثالث والرابع بالنص: (إنما قال ذلك على سبيل الإنكار على قومه) أو (على وجه المحاجة لقومه بالنظر). ولم يرجح واحداً من هذه الوجوه. بل أبقى الأمر معلقاً محتملاً.
وممن يرى أن إبراهيم عليه السلام إنما قال ذلك تفكراً وبحثاً في سبيل الوصول إلى الإله الحق- الشريف المرتضى الذي يقول:(إن إبراهيم (ع) لم يخلَق عارفاً بالله تعالى، وإنما اكتسب المعرفة لما أكمل الله تعالى عقله[3].
وكذلك الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان)[4].
وأما الفيض الكاشاني فيحتمل الاتجاهين معاً: اتجاه النظر والاستدلال، واتجاه المناظرة والمحاججة مع قومه[5].
ويصرح مكارم الشيرازي صاحب تفسير (الأمثل):
أن كلاً من الاتجاهين قد اختاره عدد من المفسرين. كما إنهما مؤيدان بشواهد من المصادر الحديثة. ثم يستعرض اتجاه (النظر) ولا يرى مانعاً منه. بل يؤيده بشاهد قرآني وآخر روائي[6].
ومن الروايات التي أسندوا بها هذا الاتجاه ما رواه العياشي في تفسيره [1/364] عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: في إبراهيم إذ رأى كوكباً قال: إنما كان طالباً لربه ولم يبلغ كفراً.
وما رواه القمي في تفسيره [1/207] قال: وسئل أبو عبد الله (ع) عن قول إبراهيم (ع):" هذا ربي"، هل أشرك في قوله: هذا ربي؟ فقال: من قال هذا اليوم فهو مشرك. ولم يكن من إبراهيم شرك، وإنما كان في طلب ربه وهو من غيره شرك.
وإذن اشتراط (العصمة) التكوينية المطلقة، والقول بأنها ذكرت في الآية لا مستند له سوى الظن: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾.
ومن الآيات التي يمكن أن يحتج بها أصحاب هذا الاتجاه قوله تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (العنكبوت/26).
وكذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ الْملأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أن عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا﴾ (الأعراف/88-89) على اعتبار أن ظاهر النص يمكن أن يفهم منه أن شعيباً عليه السلام كان متبعاً لملة قومه ثم نجاه الله منها.
وعلى كل حال فإن القطع باتصاف الأنبياء عليه السلام بالعصمة المطلقة غير ممكن.
أما استنتاج هذه العصمة من الآية فتكلف سمج. وأسمج منه إطلاق صفة (الظالمين) على من صدر منه الظلم ولو برهة من الزمن وإن تاب وصلح. بل هو لغو ينبغي أن ينزه عنه العقلاء. بل سوءة يجب أن تطوى ولا تحكى.
انهيار الحجة:
وبانهيار هذه المقدمات تنهار النتيجة المبنية عليها كما ينهار البناء إذا انهار أساسه.
إن الاحتجاج بالآية على (الإمامة) عموماً يحتاج إلى الإثبات القطعي لهذه المقدمات. وذلك مستحيل لأن الأمر في أحسن أحواله راجع إلى الظن والاحتمال. وأصول الاعتقاد مبناها على أساس القطع واليقين. وحيث لم يثبت الأساس فلا بناء. فبطل الاحتجاج بالآية على (الإمامة).
لا ذكر لعلي ولا أحد من (الأئمة) الاثني عشر في الآية!
وعلى افتراض صحة هذه المقدمات جدلاً، فإنه لا يتحصل منها إلا إثبات (إمامة) عامة ليست متعلقة قطعاً بأحد من (الأئمة) الاثني عشر، فالاحتجاج بها على إمامة علي بخصوصه أو غيره ممن ادعيت لهم (الإمامة) دعوى فارغة.
وهذا يتوضح أكثر بالنقاط الآتية:
1- أن هؤلاء غير مذكورين صراحة في نص الآية، بل ولا إشارة! فالآية تتكلم عن إمامة إبراهيم وليس عن إمامة علي أو أحد غيره فإقحامهم فيها محض تخرص وافتراض لا سند له إلا شبهات لا يمكن بحال أن ترقى إلى اليقين الذي هو أساس ابتناء الأصول.
ولقد نص الله تعالى في كتابه على خلافة داود عليه السلام ، بينما الأمة بحاجة إلى النص على إمامة علي وخلافته أكثر من النص على إمامة إبراهيم وخلافة آدم وداود. فلا يعقل أن ينص الله على أمر كمالي ويترك النص على أمر أساسي أصولي!
ومن الملاحظ أن كل الأمور العظيمة المشتركة بين الشرائع القديمة وشريعة الإسلام -كالتوحيد والنبوة والمعاد والصلاة والزكاة والصيام وحرمة القتل والزنا والسرقة- يصرح الله بذكرها في تلك الشرائع. ثم يعود ليؤكد ذكرها صراحة مرة أخرى في شريعة الإسلام بالنصوص القرآنية الواضحة. فلو افترضنا جدلاً أن (الإمامة) موجودة في الشرائع القديمة فلماذا لم يؤكد الله تعالى ذكرها في شرعنا بالنصوص القرآنية التي تصرح بذكر (الإمامة) عموماً، و(إمامة) علي و(الأئمة) من بعده خصوصاً؟!
فعاد القول (بإمامة) علي احتجاجاً بالآية إلى المتشابه لا إلى المحكم. وذلك دليل بطلانه.
2- أن استنباط (إمامة) علي من الآية -بناءاً على أن علياً لم يقع منه شرك أو ذنب- لا يمكن القطع به وإنما هو دعوى -ودعوى عظيمة- تحتاج إلى دليل قطعي من خارج الآية، وإلا فإن الآية لا تنص على علي ولا على عصمته، فضلاً عن غيره، فاحتاجت الآية إلى حجة من خارجها فبطل الاستدلال بها.
3- أن القول بـ(عصمة) علي دعوى تحتاج -كما قلت- إلى نص قرآني صريح. وذلك مفقود -وسيأتي لاحقاً مناقشة هذه القضية مفصلاً في مبحث (العصمة)- والأمر مبناه على الافتراض الظني وذلك لا ينفع في الأصول.
بل يمكن الطعن حتى في دعوى أن علياً لم يقع منه شرك في بداية حياته. وذلك بأن نقول:
ما الدليل القطعي على هذه الدعوى؟
قد يقال: إنه أسلم وهو صبي صغير ولكن هذا القول لا يكفي فقد يكون وقع منه الشرك قبل أن يسلم، ولا يبعد أن أباه -وهو مشرك- كان يأخذه إلى الكعبة ويلقنه عبادة الأصنام، بل يقال: إنه ولد في الكعبة، والكعبة حين ولادته كانت مليئة بالأصنام. فهو قد ولد بين الأصنام! ولقد ولد غير واحد من قريش في الكعبة كحكيم بن حزام. ويظهر أن المرأة إذا أعسرت أدخلوها الكعبة مستغيثين بالآلهة لكي ييسروا أمر ولادتها.
وليس في هذا ذم ولا مدح، لأن الذم والمدح يبنى على الفعل الاختياري، والطفل لا اختيار ولا قصد له في الخير والشر.
وكلمة (أسلم علي وعمره كذا) تستلزم أنه لم يكن قبل ذلك مسلماً.
ودعوى انفراد علي بأنه لم يسجد لصنم غير مسلَّم بها: فإن أبا بكر لم يسجد كذلك لصنم. وهذا أدعى للفضل لأنه ترك اختياري عن تفكر وتدبر. فليس هو كترك طفل لم يوضع بعد على المحك. فلا ندري لو عاش حتى بلغ مبلغ الرجال ما ستؤول إليه الحال؟
وقد حكى لنا التاريخ عن مجموعة ممن كانوا يسمون بالأحناف لم يشركوا بصنم كأبي بكر الصديق، وأبي ذر الغفاري، وزيد بن نفيل، وورقة بن نوفل. ولا شك أن الفضل لهؤلاء أولى وأكمل.
والنتيجة أن إثبات أن علياً لم يسبق منه شرك أمر ظني. وثبوت هذا لمن ولد في الإسلام، ونال الخلافة كعبد الله بن الزبير مقطوع به.
وأخيراً:
وأخيراً نقول: هل يعقل أن تكون هذه الآية المحتملة لهذه الوجوه التي لا تحصى من الاختلافات- حجة على العباد في أصل من أصول الدين يتوقف على ثبوته الإيمان، ويلزم من إنكاره الكفر؟!
أعط الآية لرجل دخل في الإسلام لأول وهلة لم يسمع بموضوع (الإمامة) و(العصمة) وعلي والحسن والحسين………الخ، غير أنه يحسن العربية، ثم انظر هل يمكن أن يفهم منها (إمامة) شخص هو علي؟ أو (إمامة) اثني عشر معصوماً أوجب الله الإيمان بإمامتهم؟!
يستحيل ذلك ولو قرأ الآية ألف مرة!
لكن أعطه هذه الآية مثلاً: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (الأنفال/74).
إنه سيقول لك بداهة:
أن الآية تتحدث عن إيمان حقيقي مصرح به لصنفين من الناس: صنف آمن وهاجر وجاهد، وصنف آوى ونصر -أي المهاجرين والأنصار- وستكون النهاية المغفرة لهم، والجزاء بالرزق الكريم.
بل أعطه هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحْ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (المجادلة/11) هل يمكن أن لا يفهم منها الإرشاد إلى التفسح في المجالس؟! أو هذه الآية: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا أن اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ (النساء/86) ألا يفهم منها بوضوح الأمر برد التحية وآدابها؟!
أفيأتي التفسح في المجالس والتحية بالنصوص الواضحة الجلية وهما أمران فرعيان –بل من فروع الفروع- ولا تأتي كذلك (إمامة) علي؟! وهي أعلى شأناً من النبوة ﴿ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * أن لكم فيه لما تخيرون﴾ (القلم/36-38).
ولو كانت هذه الآية -وغيرها من الآيات التي يحتج بها الإمامية- دالة على (إمامة) علي لكان هو أول المحتجين بها. وتلك الآثار الواردة عنه في جميع الكتب تصمت صمتاً كاملاً عن ذلك، ما يوضح بجلاء أن هذه العقيدة استنبطوها بعيداً عن نصوص القرآن، ثم جاءوا إلى القرآن ليجعلوا منه تابعاً ومحكوماً يوقّع على ما يقولون وبه يحكمون.
[1] فقيه من لا يحضره الفقيه 1/129.
[2] منهاج السنة النبوية – شيخ الإسلام ابن تيمية 1/302- 303 – انظر: أصول مذهب الشيعة 2/786 – د. ناصر عبد الله علي القفاري.
[3] [تنزيه الأنبياء/47] – مراجعات في عصمة الأنبياء من منظور قرآني – عبد السلام زين العابدين ص118.
(2) المصدر نفسه ص 120
[5] أيضا ص 121.
[6] أيضا ص 121، 122.