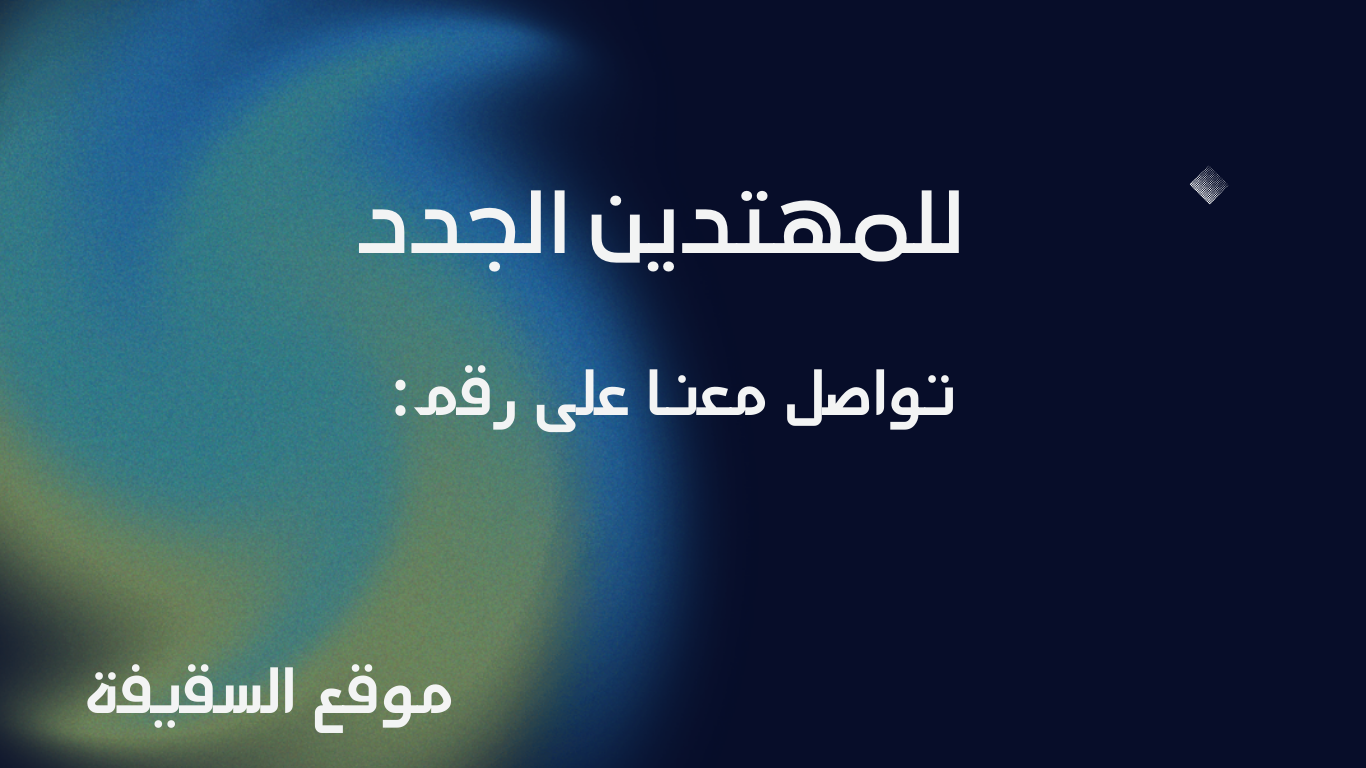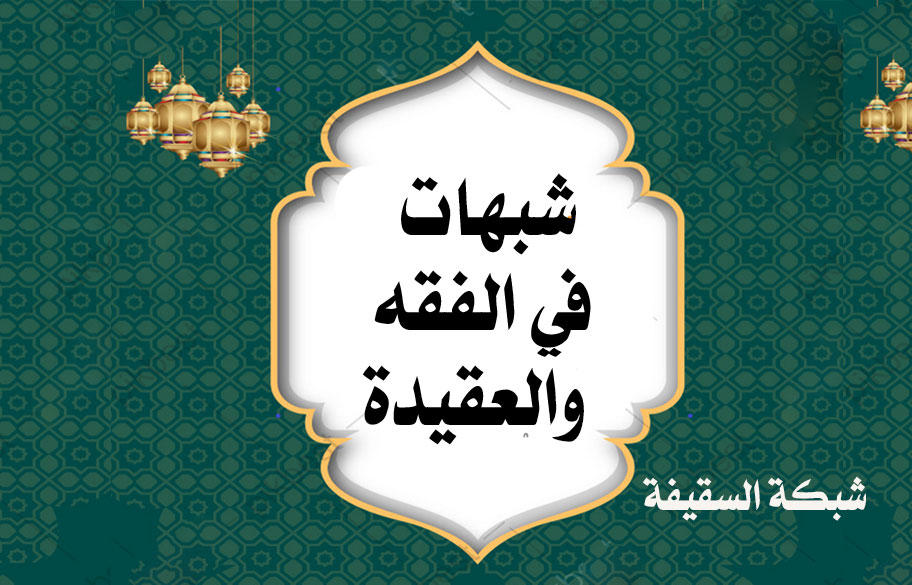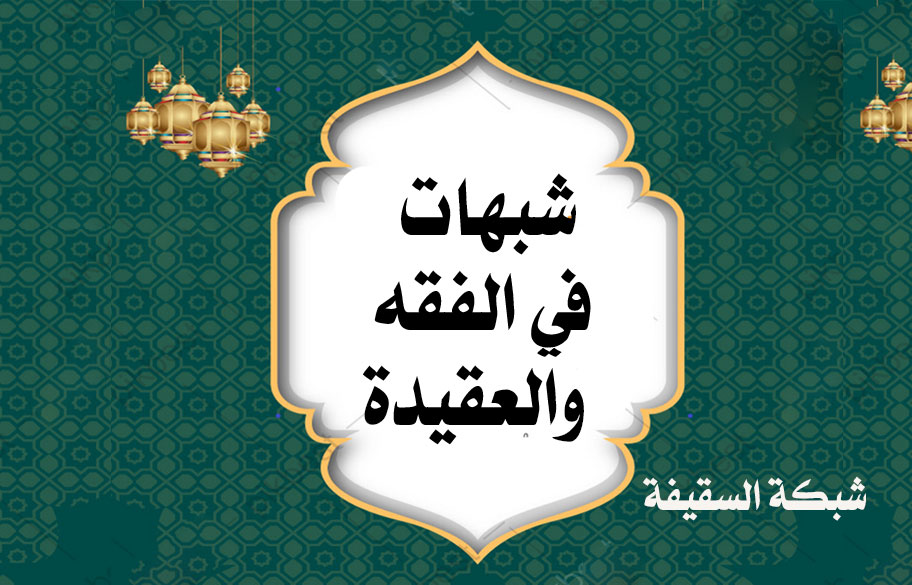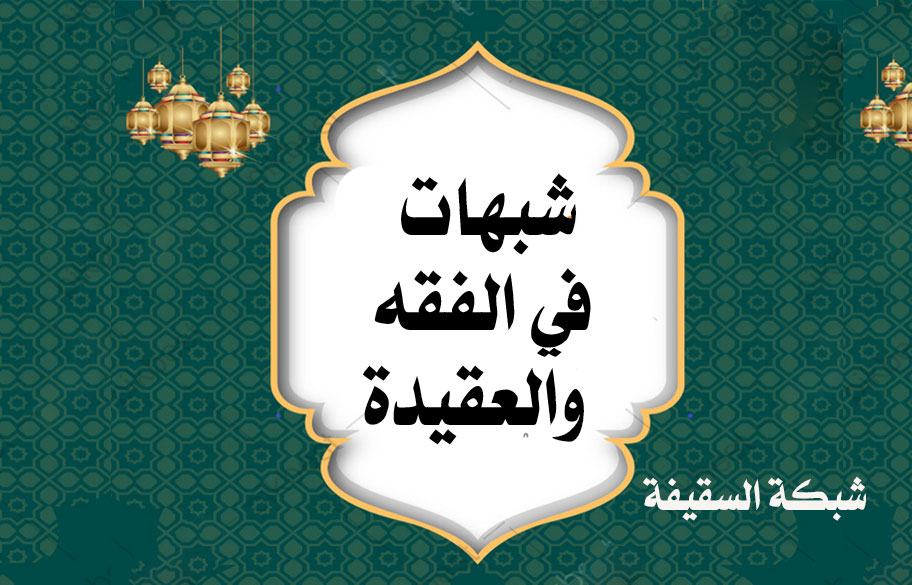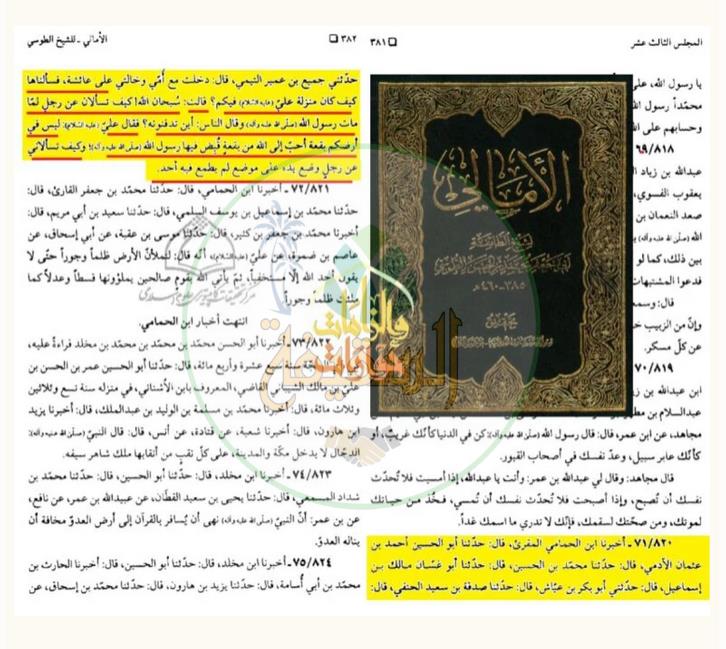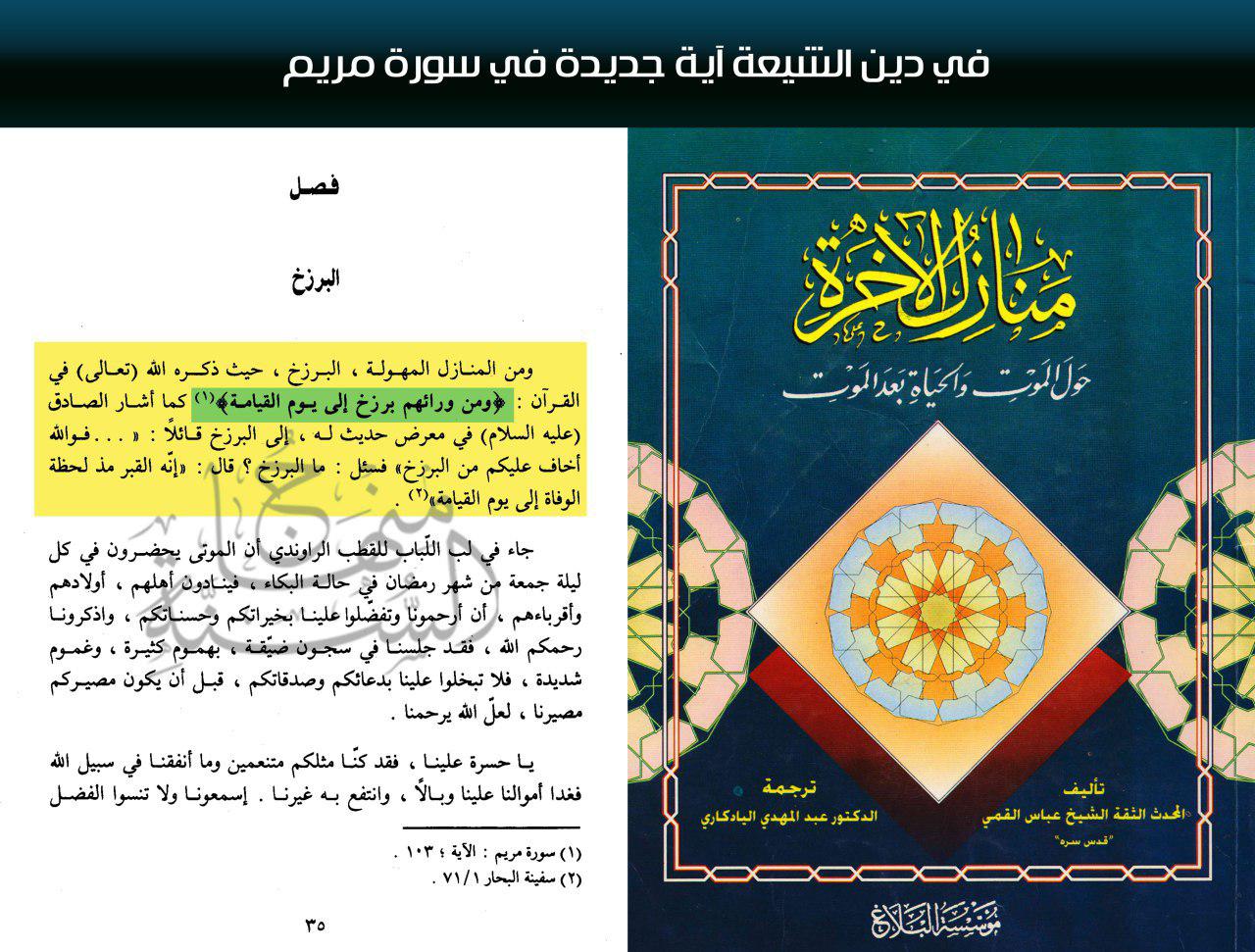من أعظم العقائد التي استقرت في قلوب أهل السنة والجماعة: إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين. غير أن بعض الفرق المنحرفة أنكرت هذه العقيدة الثابتة، مستدلين بآيات أُسيء فهمها، كقوله تعالى: {قَالَ لَنْ تَرَانِي}، وقوله: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَار}. وفي هذا المقال نرد على هذه الشبهات ردًا علميًا دقيقًا، مع بيان دلالات الآيات، وموقف الأنبياء، وفهم السلف الصالح.
الرد على المنكرين في نفي الرؤية:
قَالَ المُصنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى:
وأما استدلال المنكرين بقوله تعالى: {قَالَ لَنْ تَرَانِي} [الأعراف:143] وبقوله تعالى: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصار} [الأنعام:103] فالآيتان دليل عليهم:
أما الآية الأولى: فالاستدلال منها عَلَى ثبوت رؤيته من وجوه:
الأول: أنكم إذا قلتم إن رؤية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى محال كما هو مذهبكم، فيُقَالُ: هل يظن بنبي الله وكليم الله وأعلم الخلق بالله في زمانه وهو موسى عَلَيْهِ السَّلام أن يسأل أمراً محالاً في حق الله عَزَّ وَجَلَّ. فسؤال موسى عَلَيْهِ السَّلام دليل عَلَى الإمكان، والأنبياء هم أعلم النَّاس وأعرفهم بصفات ربهم عَزَّ وَجَلَّ، أرسلهم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ليعلموا النَّاس صفات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وما ينبغي له وما لا يجوز أن يطلق عليه وما لا يجوز أن يقال في حقه، فإذا جَاءَ النبي وسأل ربه ذلك، فهذا في ذاته دليل عَلَى أنه ليس بمحال، ومنكرو الرؤية لا يجعلونه ممكن، بل يجعلونه محال استحالة مطلقة، فكأنهم أعرف بالله عَزَّ وَجَلَّ وبما يليق به وما لا يليق من نبيه موسى عَلَيْهِ السَّلام!!.
الثاني: أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم ينكر عَلَى موسى عَلَيْهِ السَّلام سؤال الرؤية، بينما نجد أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ينكر ولو عَلَى الأَنْبِيَاء إذا سألوه وطلبوه أمراً محالاً، لا نقول: إحالة كلية لأن المحال بالمرة لا يسأله الأنبياء، ولكن إذا سألوا أمراً يظنون أنه ممكن وهو مما لم يشأ الله عَزَّ وَجَلَّ أن يفعله، كما سأل نوح عَلَيْهِ السَّلام ربه نجاة ابنه { فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود:45] يستعطف ويسترحم ويسأل ربه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن ينجي ابنه، فرد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عليه بقوله: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [هود:46] فسؤال الله عَزَّ وَجَلَّ أمراً قد قطع الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأنه لا يتحقق هذا مما يفعله الجاهلون، ولهذا قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لنوح عَلَيْهِ السَّلام: {إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}، فهو ليس من الجاهلين عَلَيْهِ السَّلام، ولكن الرحمة والشفقة الفطرية جعلته يدخل الابن في عموم من ينجو من الأهل {فقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَق} ولكن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذكر أن الابن خارج عن الوعد وليس داخل فيه، ووعظ نبيه نوحاً أن يسأله مثل ذلك، فلو كَانَ سؤال نبي الله تَعَالَى موسى الكليم من هذا القبيل لقال له أيضاً، لا تفعل ذلك ولا تسألني مثل هذا ولا تطلب مني شيئاً من هذا، وهذا لم يقع ولم يحصل في سؤال الكليم موسى عَلَيْهِ السَّلام.
الثالث:أنه تَعَالَى قَالَ: {لَنْ تَرَانِي} ولم يقل: إنني لا أُرى، أو إنني لا تجوز رؤيتي، أو إنني لست بمرئي، ففرق بين هذا وبين قوله: {لَنْ تَرَانِي} فهو مجرد نفي لوقوع الفعل، ليس نفياً لإمكان الوقوع مطلقاً.
الرابع : أن {لن} لو كانت للتأبيد لما جاز أن يحدد الفعل بعدها، فلو كانت هذه الأداة في لغة العرب كما يزعمون للتأبيد المطلق لما صح أن يقع بعدها استثناء أو تحديد للفعل، بينما نجد أنه قد جَاءَ ذلك في القرآن،كما في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لسان أخي يوسف: {فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي} [يوسف:80] إذا حصل الإذن من أبيه فإنه سيبرح الأرض، فحصل النفي بـ {لن} وحصل معه التحديد، فالنفي يستمر إِلَى حالة حصول الإذن، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي.