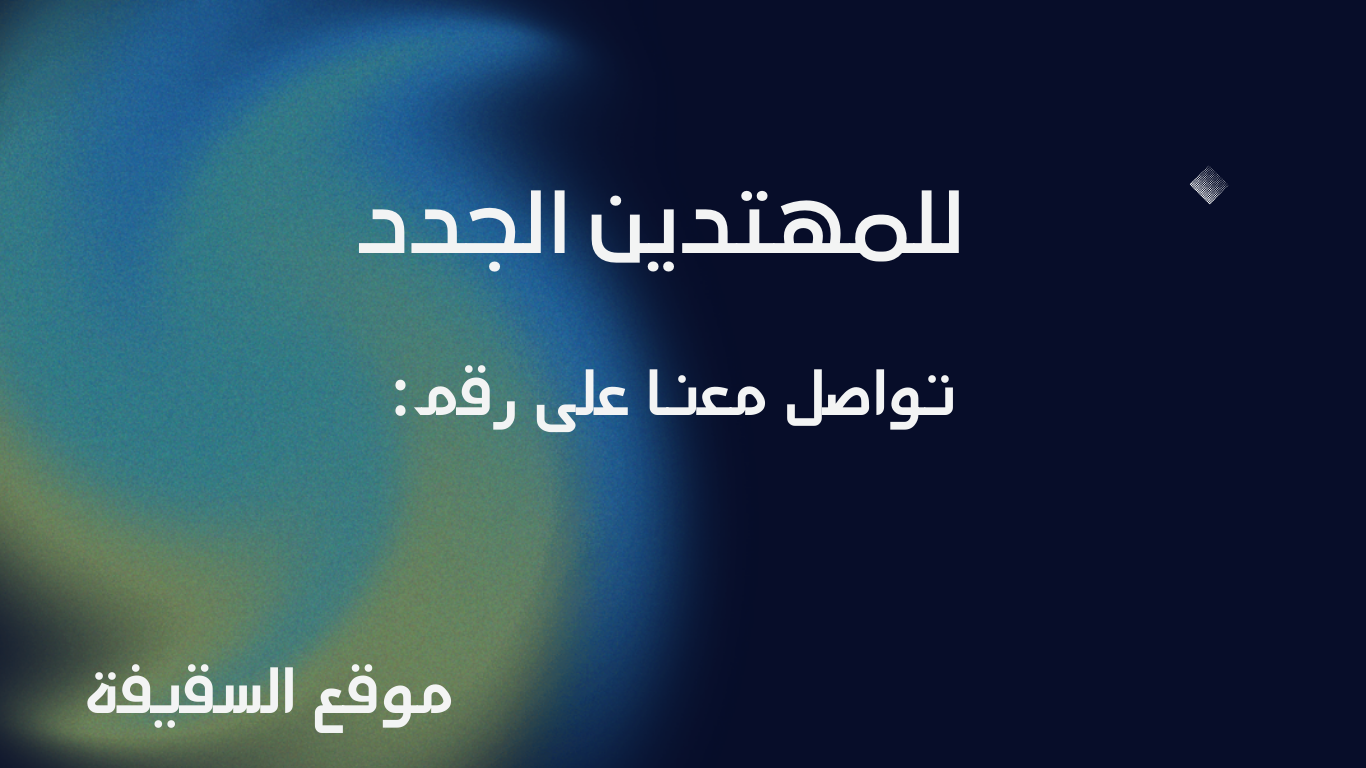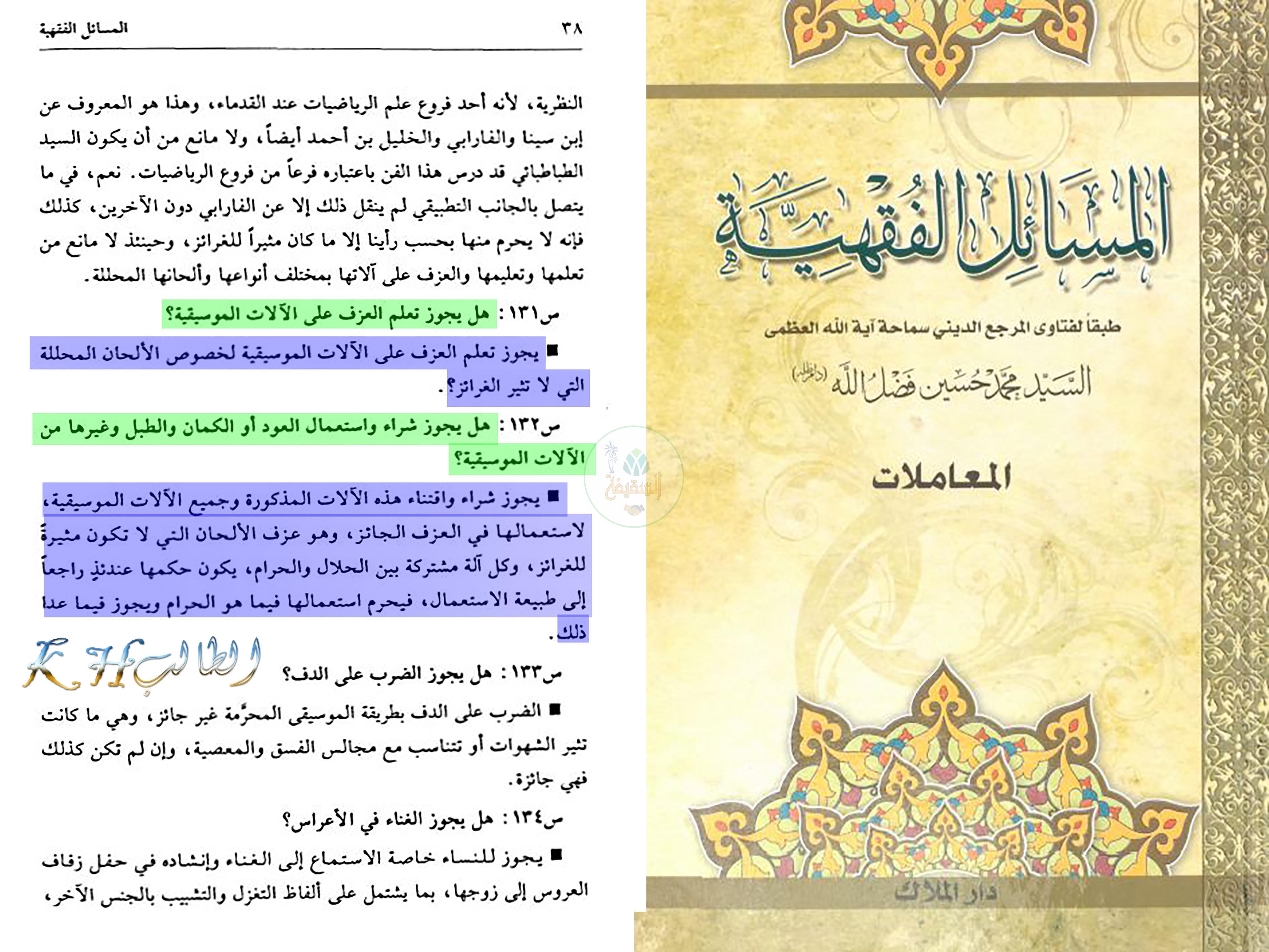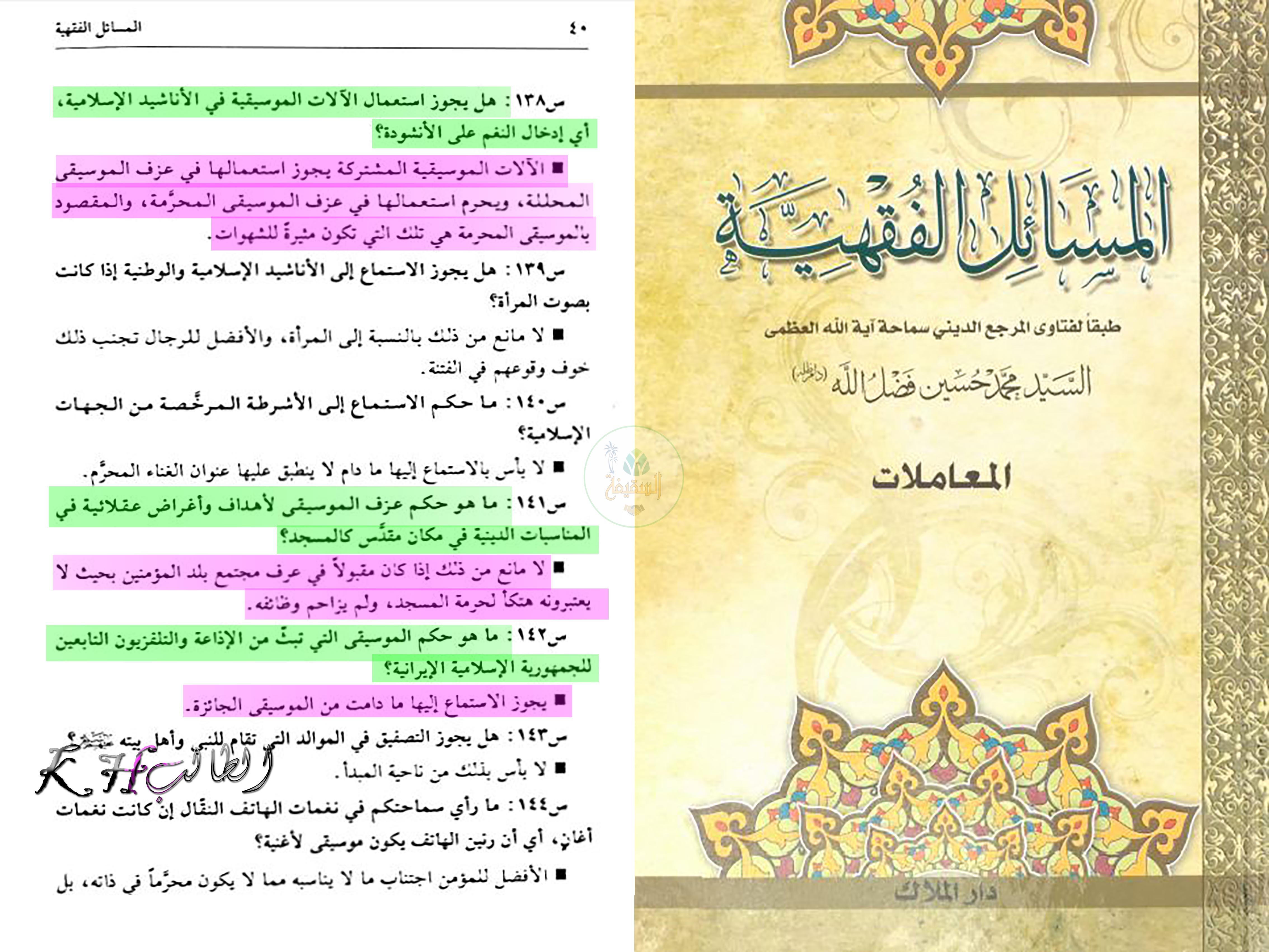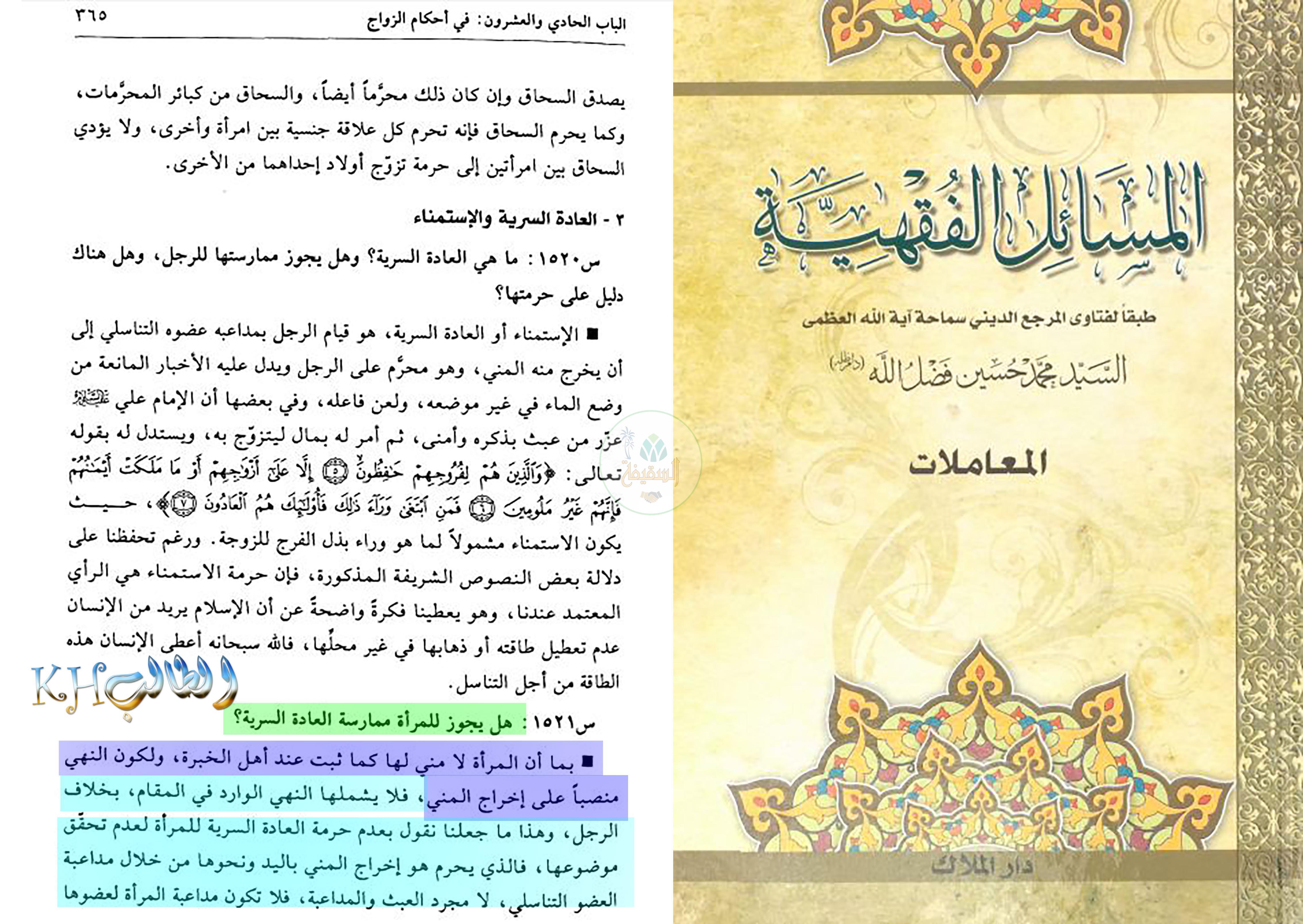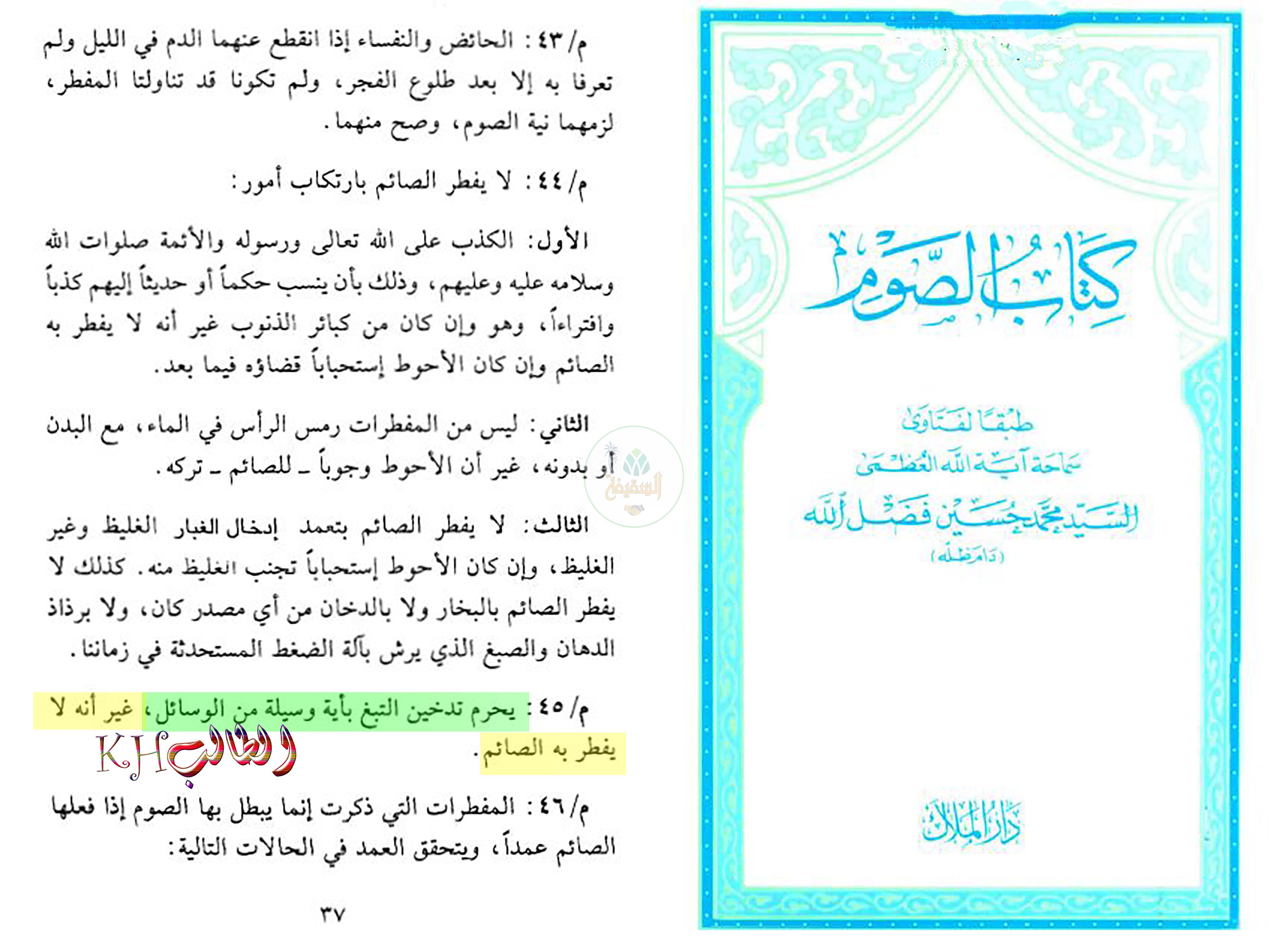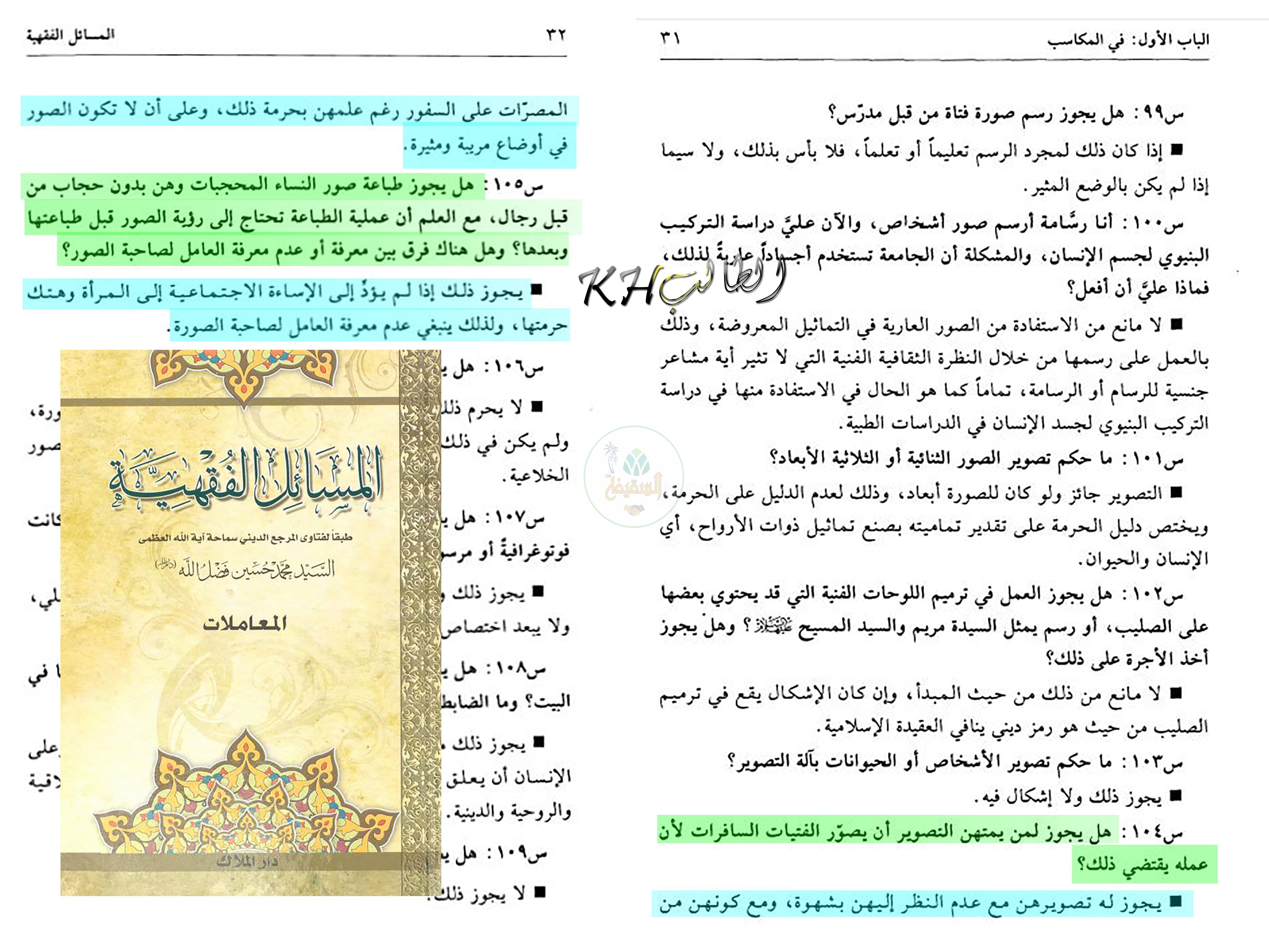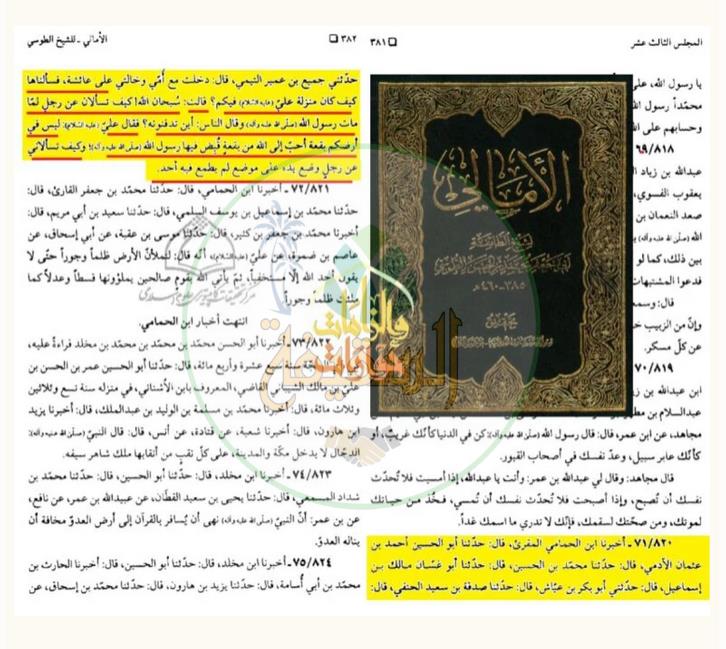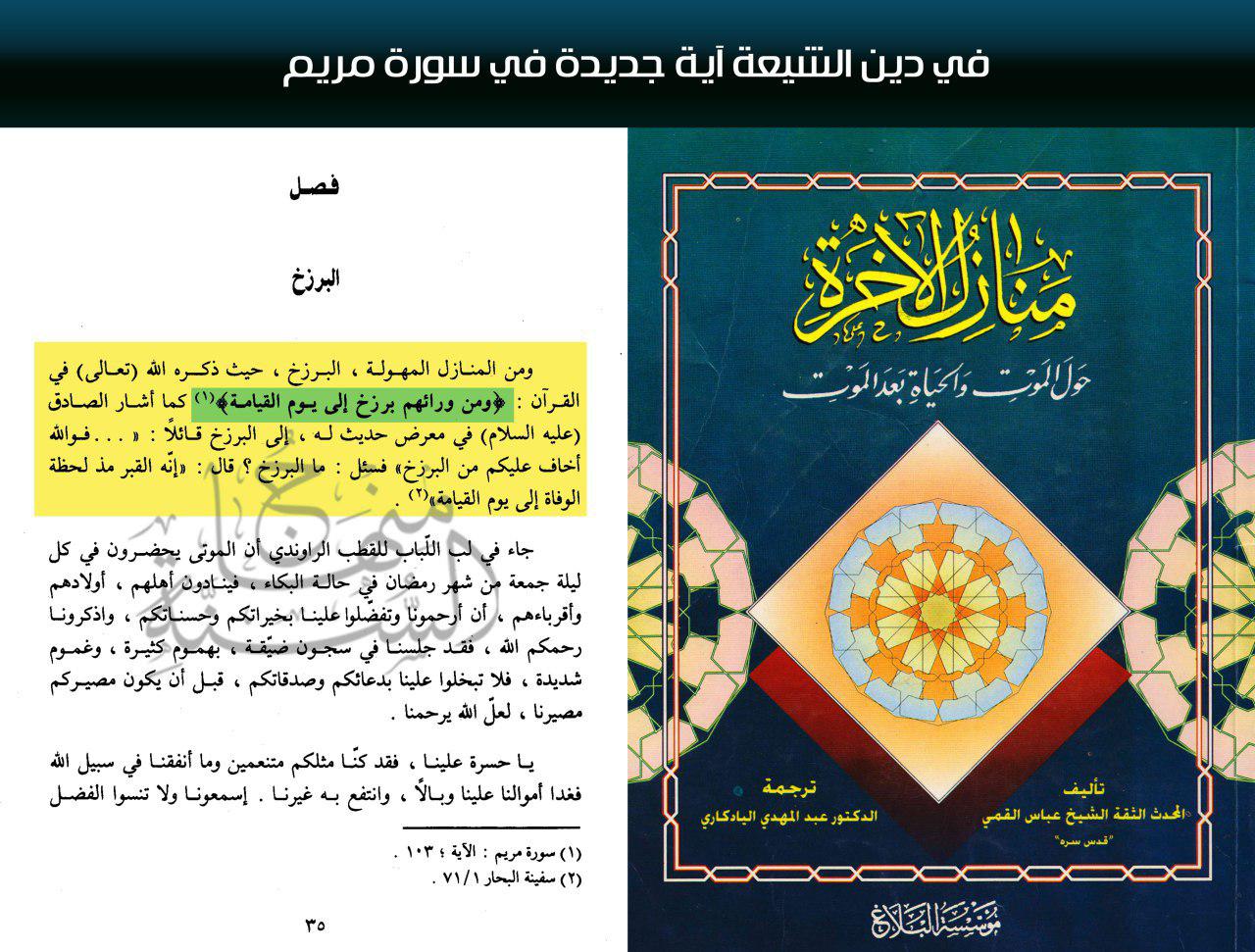لماذا تأخَّر الشِّيعة وتقدَّم غيرهم؟ قراءة بين الماضي والحاضر
شهد الفكر الشيعي الإمامي تحولات عميقة عبر العصور، خاصة فيما يتعلق بالموقف من الدولة والعمل السياسي والاجتماعي. وقد طرحت تساؤلات عدة من قبل باحثين معاصرين، أبرزهم أحمد الكاتب، حول أسباب "تأخر الشيعة" مقارنة بغيرهم من المسلمين. ويزعم الكاتب أن الفكر الإمامي التقليدي، القائم على نظرية "الانتظار" و"التقية"، أسهم في تهميش دور الشيعة في الإصلاح الاجتماعي والسياسي. هذا المقال يستعرض بموضوعية أقوال الفقهاء الكبار في المسألة، ويُحلل الخلفيات التاريخية والفكرية لذلك الموقف، ويرد على ما اعتبره البعض "ثورة فكرية شيعية جديدة" ابتعدت عن أصولها.
الموقف من الإصلاح الاجتماعي في الفكر الإمامي القديم
انعكست نظرية الانتظار للمهدي الغائب على كثير من المواقف السياسية والاجتماعية للفقهاء الإمامية، خاصة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تُعد من الركائز الأساسية لأي مشروع إصلاحي في الإسلام. وبحسب التصور الكلاسيكي، فإن هذه الفريضة تمر بمراحل (اللسان، اليد، الجراح والقتل)، ولكن كان استعمال القوة والدماء فيها مشروطًا بوجود الإمام المعصوم (عليه السلام) أو إذنه.
أقوال كبار فقهاء الشيعة في هذا الباب:
-
الشيخ المفيد في المقنعة:
"ليس له القتل والجراح إلا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام..."
-
الشيخ الطوسي في النهاية:
"... لا يجب فعله إلا بأذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة..."
-
القاضي ابن براج في المهذب:
"... لا يجوز فعله إلا بأمر الإمام العادل وإذنه..."
-
ابن إدريس في الاقتصاد:
"الظاهر من مذهب شيوخنا: أن هذا الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو من يأذن له الإمام".
وغيرهم من كبار الفقهاء الذين قيدوا استخدام العنف في الإصلاح الاجتماعي بوجود الإمام أو من ينوب عنه.
الكاتب أحمد الكاتب ومشروعه الإصلاحي
يرى أحمد الكاتب أن التفسير التقليدي لكلمة "الإمام" باعتباره الإمام المعصوم الغائب هو ما عطّل الإصلاح الاجتماعي، وجمّد العمل بمراحله الحاسمة. ويقترح إعادة تعريف "الإمام" ليشمل الحاكم أو الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، ما يسمح بإحياء القانون بصورة كاملة، دون تجميد أي مرحلة.
كما يعتبر الكاتب أن الشيعة اليوم، وخصوصًا المدرسة الجعفرية المعاصرة، قد تطورت وأصبحت أقرب إلى نهج أهل البيت (عليهم السلام) من السابق، وانفصلت عن السلبية السياسية التي كانت سائدة.
الرد على طرح الكاتب: منهجية مغلوطة وتدليس في النقل
يأتي الرد من باحثين تقليديين، ليؤكدوا أن:
-
الكاتب يخلط بين الوظيفة الفردية للأمر بالمعروف وبين وظيفة الدولة أو الفقيه الحاكم.
-
أغلب ما نقله من الفتاوى يخص المستوى الفردي، لا النظامي أو السياسي، مما يؤدي إلى قراءة غير دقيقة.
-
فقهاء الشيعة ميزوا بين المستويين، واشترطوا إذن الإمام أو نائبه في الجرح والقتل لدرء الفتنة، لا لتعطيل الإصلاح.
-
الكثير من فقهاء الشيعة مارسوا الإصلاح السياسي والاجتماعي وتصدّوا للظلم عبر التاريخ: كالتصدي للمغول، مواجهة الاستعمار، مقاومة المد الشيوعي، ومقارعة الأنظمة المستبدة.
-
المقاومة الإسلامية في العصر الحديث، خاصة في لبنان وفلسطين، هي نتاج هذا الفقه المقاوم الذي يتزعمه علماء الشيعة الإمامية.
هل الشيعة متأخرون حقًا؟ أم أن التقييم غير موضوعي؟
يُعدّ اتهام الشيعة بالتأخر العام تقييماً سطحياً وانتقائياً، خاصة في ظل ما أنجزه علماء الشيعة من:
-
بناء منظومات فكرية وعقائدية متكاملة
-
مقاومة المحتلين والطغاة
-
إنشاء مؤسسات دينية ومجتمعية فاعلة
-
قيادة حركات تحرر ومقاومة مشروعة
بل إن كثيرًا من أعلام الشيعة كانوا شهداء الكلمة والموقف، كما وثق ذلك العلامة الأميني في كتابه شهداء الفضيلة.
خلاصة القول:
الفرق بين الطرحين لا يكمن فقط في النظرية، بل في تأويل المصطلحات وتحديد الصلاحيات. فبينما يرى أحمد الكاتب أن "الإمام" في الفقه التقليدي لا يشمل إلا المعصوم، يرى خصومه أن "الفقيه الجامع للشرائط" يشمل ضمنًا تلك الصلاحيات، وقد مورست فعلاً عبر التاريخ.
وهكذا يتضح أن الفكر الإمامي ليس جامدًا كما يصوره البعض، بل مرن وقابل للتطور في إطار الشرعية، دون الخروج عن أصوله.