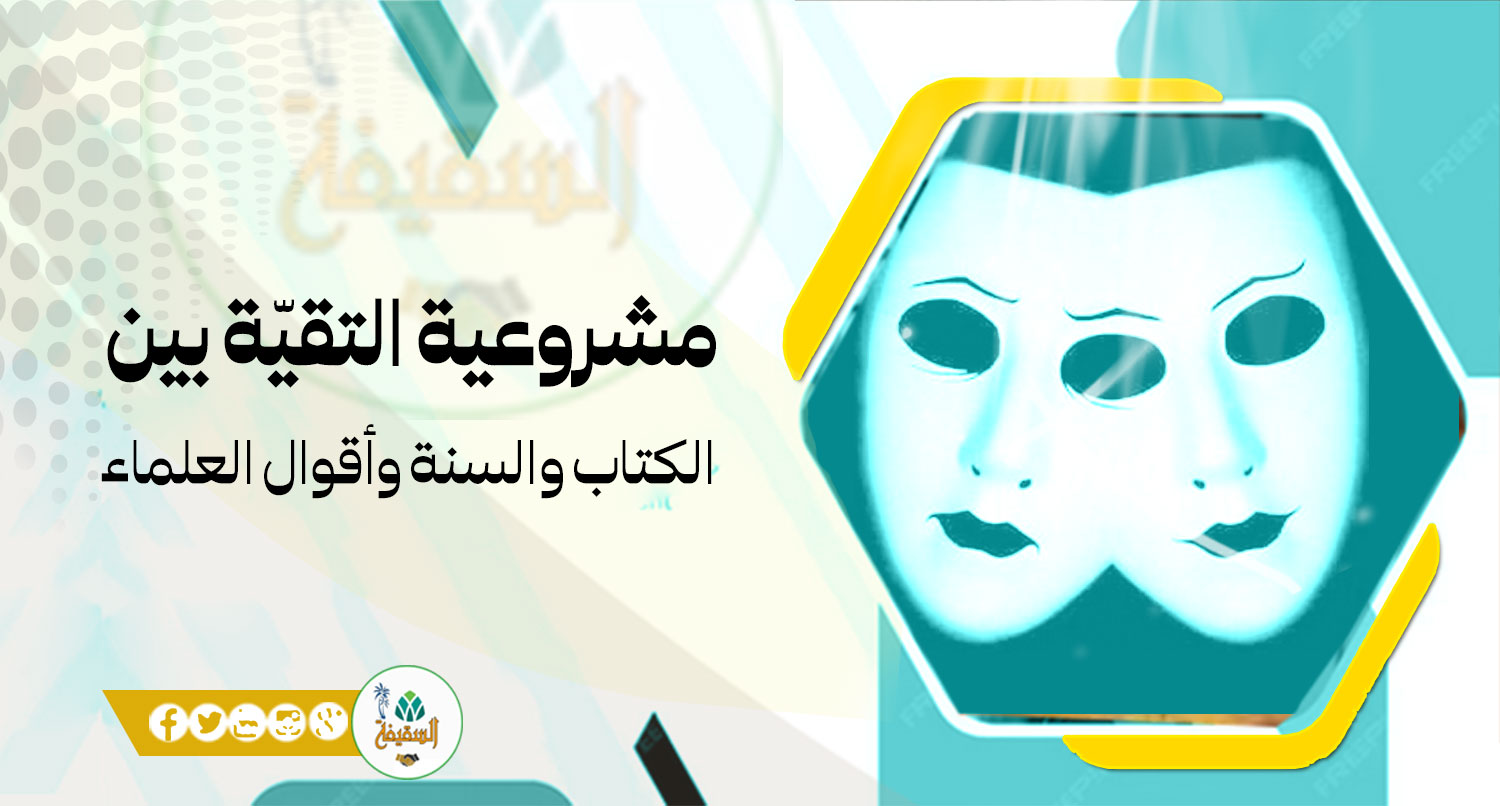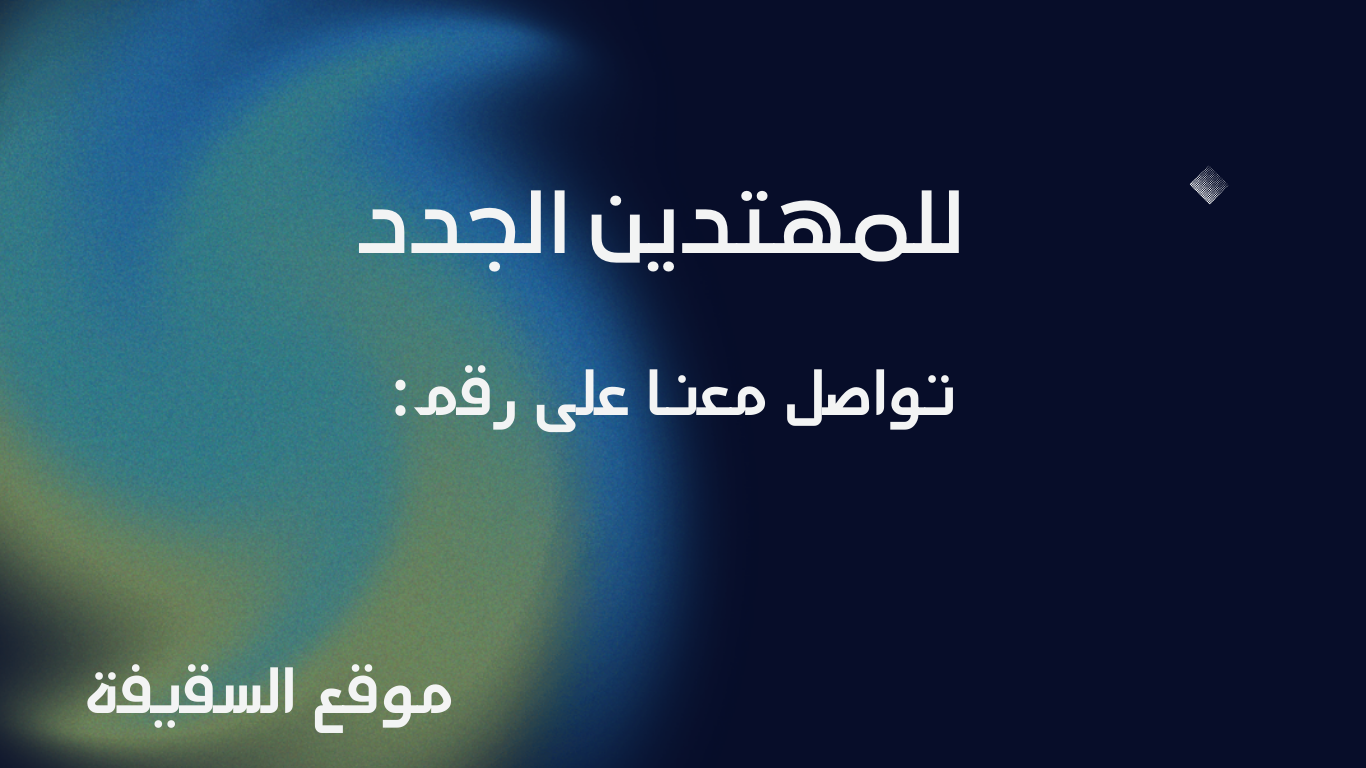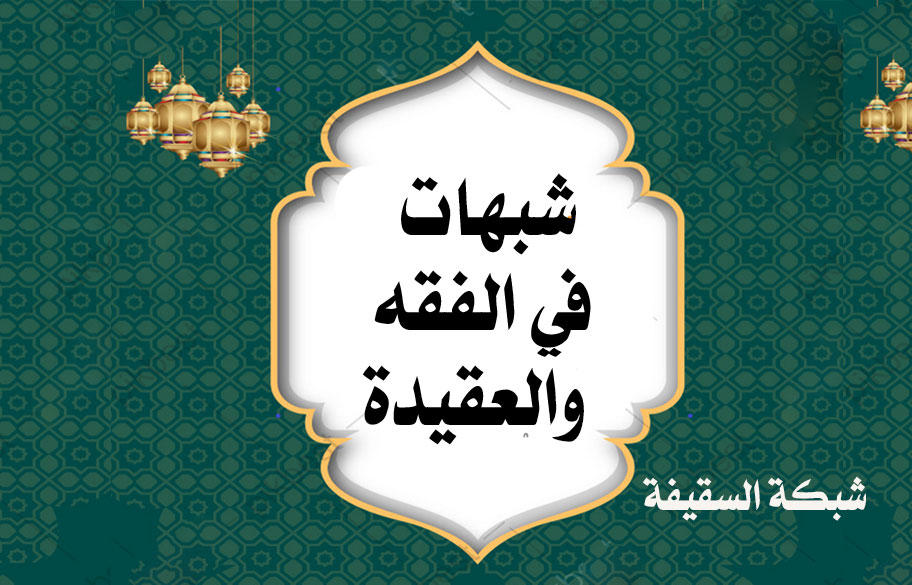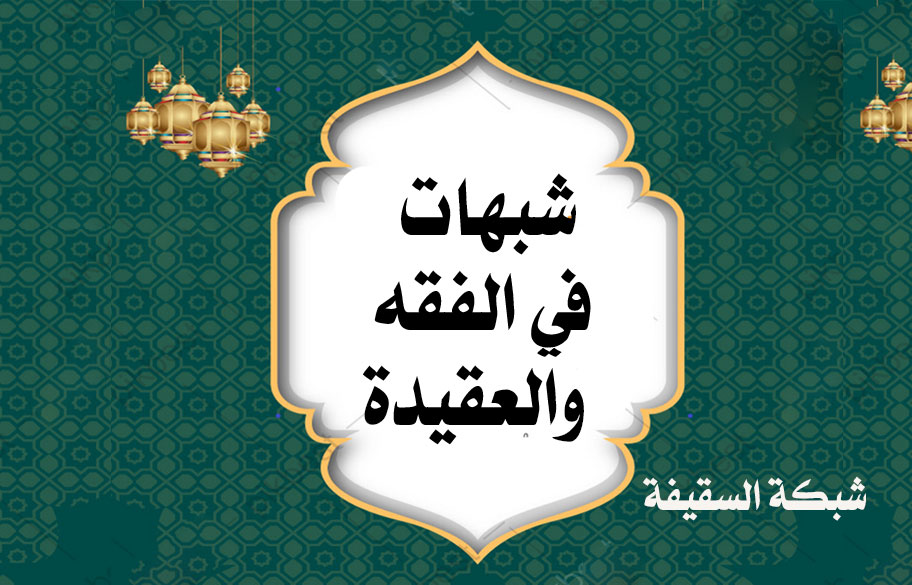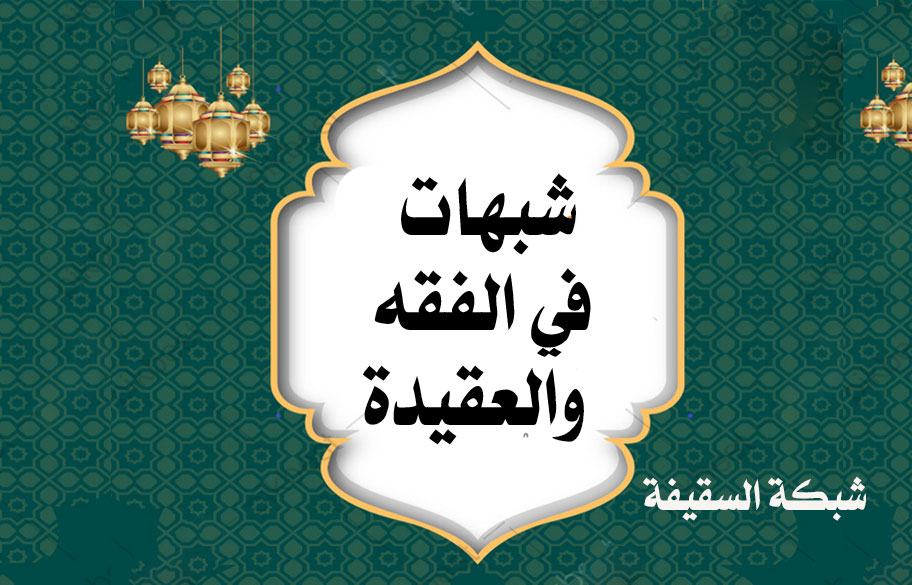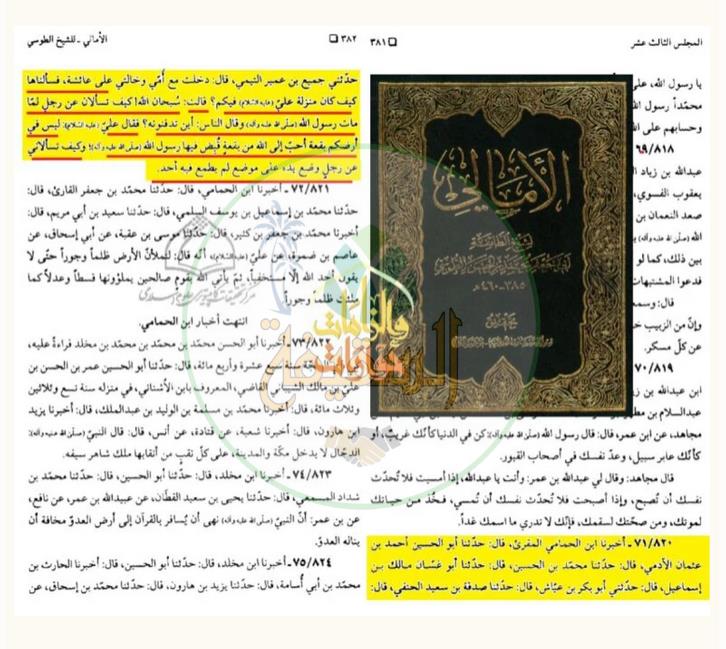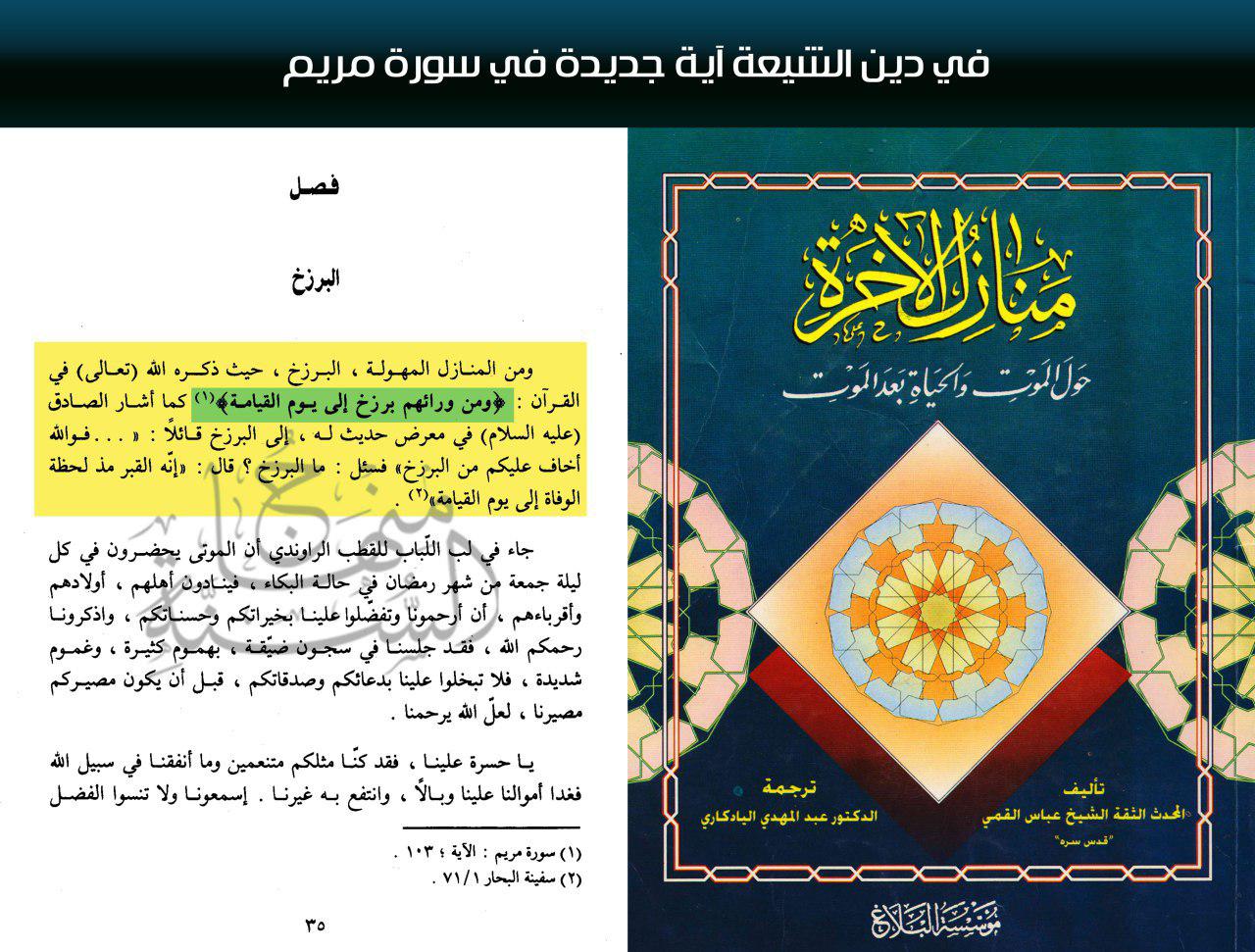تُعَدّ التقيّة من المسائل الفقهية التي شغلت عقول العلماء والمفسرين قديمًا وحديثًا، فهي مفهوم يرتبط بأحوال الخوف والإكراه وحماية النفس والعرض والدين. وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية، مما جعلها جزءًا من النقاشات الفقهية الدقيقة. وفي هذا السياق تناول علماء اللغة والفقه والتفسير هذا المصطلح شرحًا وتأصيلاً، فبيّنوا أصله اللغوي ودلالاته، ثم استنبطوا أحكامه من النصوص الشرعية، ووضحوا متى تجوز ومتى لا تجوز، وهل تبقى رخصتها قائمة بعد عزة الإسلام أو أنها خاصة بحال الضعف. ويستعرض هذا المقال أدلة مشروعية التقيّة من الكتاب والسنة، وأقوال أئمة أهل السُنة والجماعة حولها، مع تسليط الضوء على اختلافاتهم في التفاصيل، واتفاقهم على أنها رخصة استثنائية عند الضرورة، لا قاعدة عامة ولا أصلاً أصيلاً من أصول الدين.
جاء في لسان العرب - مادة (وقى)-:
اتّقيت الشيءَ وتقَيْتُه أتّقيه، وأتْقيه تقًى وتُقاة: حذِرته[1].
ويقول ابن الأثير: وأصل (اتقى):
(اوتقى)، فقلبت الواو ياء للكسرة قبلها، ثم أبدلت تاء وأدغمت، ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي: جعلناه وقاية من العدو[2].
وقال الراغب الأصفهاني: الوقاية:
حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، يقال وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء. [3]
وفي المعجم الوسيط: ووقى الشيء وقيا ووقاية: صانه عن الأذى وحماه، والتقية: الخشية والخوف[4].
ويقول ابن حجر: ومعنى التقية: الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير، وأصله وقية بوزن حمزة، فعلة من الوقاية[5].
مشروعية التقية من الكتاب والسنة:
وأصل مشروعية التقية مأخوذ من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول الله عز وجل: ﴿لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران:28].
|
مختارات من السقيفة |
|
الشيعة الإمامية تخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم من الائمة قراءة القرآن في الحمام بين الجواز والضوابط |
ويقول تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: 106].
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله وضع - وفي لفظ: تجاوز - عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [6].
أقوال علماء أهل السُنة في التقية:
يقول ابن كثير في تفسير الآيات: أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم -أي: الكافرين- فله أن يتقيهم بظاهره، لا بباطنه ونيته... وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان... وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوه: قول الله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ [النحل:106][7].
وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله، وقد روى العوفي عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه حين عذبه المشركون ليكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوافقهم على ذلك مكرهاً، وجاء معتذراً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله هذه الآية.
وهكذا قال شعبة وقتادة وأبو مالك، وقال ابن حرير:
حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه، حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عادوا فعد.
ولهذا اتفق العلماء على أن من أُكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاءً لمهجته، ويجوز له أن يأبى كما كان بلالرضي الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل، ويأمرونه بالشرك بالله، فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فكان يقول: لا أسمع، فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك[8].
|
مقالات السقيفة ذات صلة |
|
الروايات الصحيحة في كتب أهل السنة والجماعة عن المهدي مع نزول عيسى أحاديث نزول عيسى وصلاته وخروج المهدي شبهة حديث: المهدي خير من ابي بكر وعمر |
ويقول الشوكاني في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ [آل عمران:28]: وفي ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم، ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً، وخالف في ذلك قوم من السلف فقالوا: لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام[9].
ويقول القرطبي:
قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام أن يتقوا من عدوهم، وقال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن، ولا يقتل ولا يأتي مأثماً. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل.
وقال رحمه الله: وقيل: إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان.
والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم، ومن أُكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر[10].
◘ وقال: أجمع أهل العلم على أن من أُكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي، غير محمد بن الحسن، فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلماً. وهذا قول يرده الكتاب والسنة[11].
◘وقال: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله، أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه، أو أكل ماله، أو الزنى أو شرب الخمر، أو أكل الربا، يروى هذا عن الحسن البصري والأوزاعي وسحنون من علمائنا... وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان.
◘ وقال: أجمع العلماء على أن من أُكره على الكفر فاختار القتل أنه عظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة[12].
ويقول الخازن:
والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النية، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ﴾، ثم هذه التقية رخصة، فلو صبر على إظهار إيمانه حتى قتل كان له بذلك أجر عظيم[13].
ويقول الزمخشري:
رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم، والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع[14].
ويقول البغوي:
في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾: يعني: إلا أن تخافوا منهم مخافة...ومعنى الآية أن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم، إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعاً عن نفسه، من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالاً حراماً أو يظهر الكفار على عورة المسلمين، والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ ثم هذا رخصة، فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم، وأنكر قوم التقية اليوم: فقال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين، فأما اليوم فقد أعز الله عز وجل الإسلام، فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. وقال يحيى البكاء: قلت لسعيد بن جبير في أيام الحجاج: إن الحسن كان يقول لكم: التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. قال سعيد: ليس في الإسلام تقية، إنما التقية في أهل الحرب[15].
ويقول الواحدي:
﴿إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً﴾؛ أي: تقية. هذا في المؤمن إذا كان في قوم كفار وخافهم على ماله ونفسه، فله أن يخالفهم ويداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعاً عن نفسه، قال ابن عباس: يريد: مداراة ظاهرة[16].
وقد روي: أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. تقية منه، فخلى سبيله، ثم قال للآخر: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم نعم نعم. قال: أتشهد أني رسول الله، فقال: أنا أصم، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله، فذكر درجة الذي صبر على القتل، وقال: إن الأول أخذ برخصة الله[17].
وقد صح عن رسول الله: أنه قال: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"[18].
ويقول ابن عطية: وذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى الآية: إلا أن تخافوا منهم خوفاً. وهذا هو معنى التقية[19].
[1] انظر: لسان العرب لابن منظور (15/401).
[2] انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (5/484).
[3] انظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم (2/530).
[4] انظر: المعجم الوسيط (2/1029).
[5] انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (19/398).
[6] انظر: تفسير ابن كثير (2/775).
([7]) انظر: فتح القدير للشوكاني (1/452).
[8] انظر: تفسير القرطبي (4/57).
[9] انظر: تفسير القرطبي (10/182).
[10] انظر: تفسير القرطبي (10/188).
[11] انظر: تفسير الخازن (1/358).
[12] انظر: تفسير الكشاف للزمخشري (1/265).
[13] انظر: تفسير البغوي (2/26).
[14] انظر: الوجيز للواحدي (1/205).
[15] انظر: تفسير البغوي (2/26).
[16] انظر: الوجيز للواحدي (1/205).
[17] انظر: تفسير آيات الأحكام للصابوني (1/180).
[18] انظر: المعجم الكبير للطبراني (7/327)، شعب الإيمان للبيهقي (7/52)، مسند أحمد (17/228).
[19] انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (1/425).