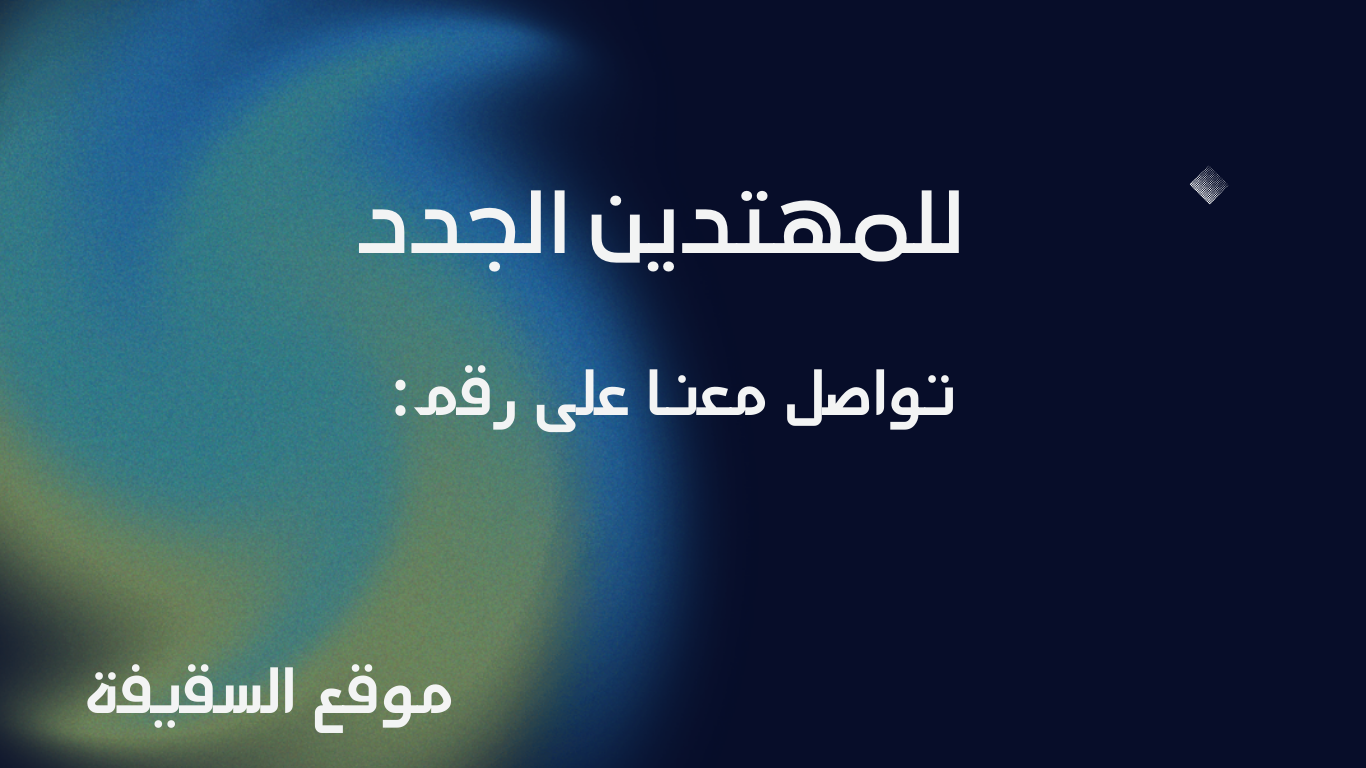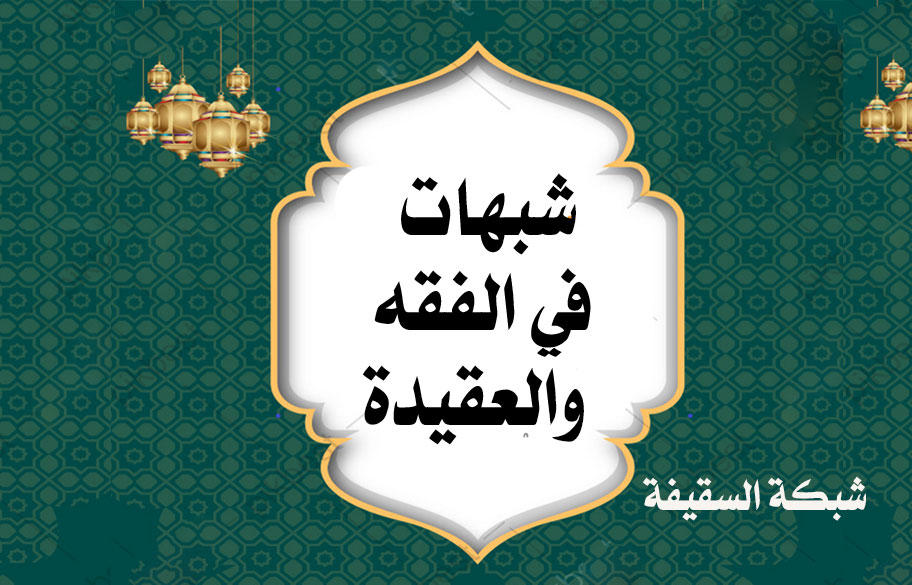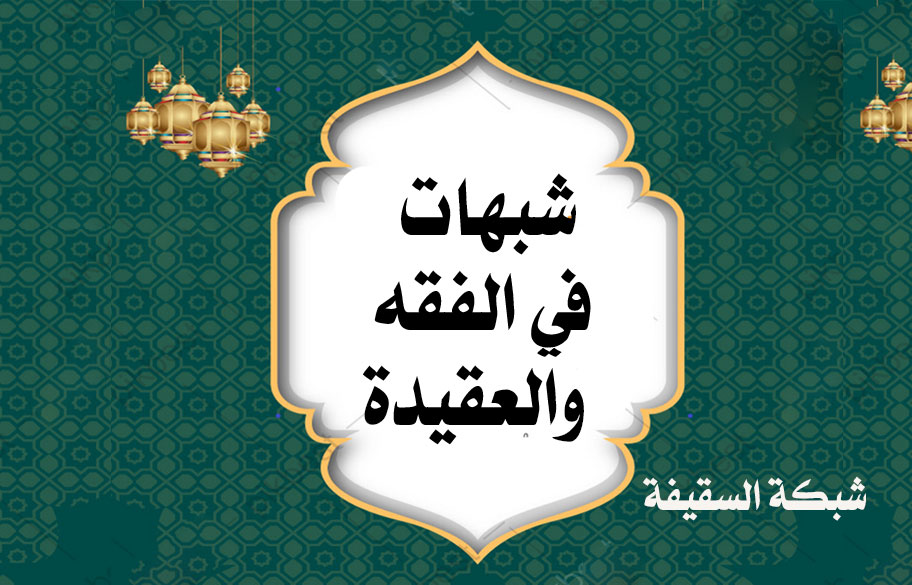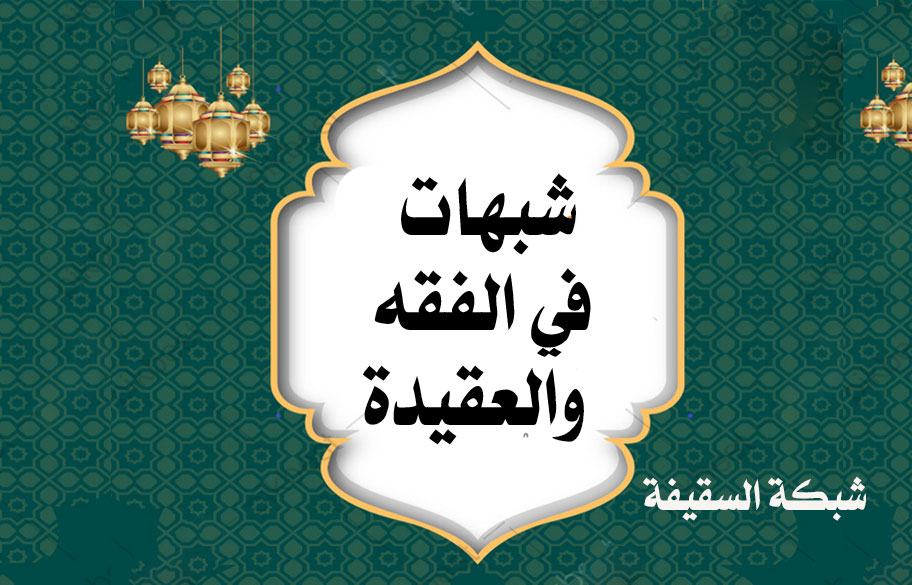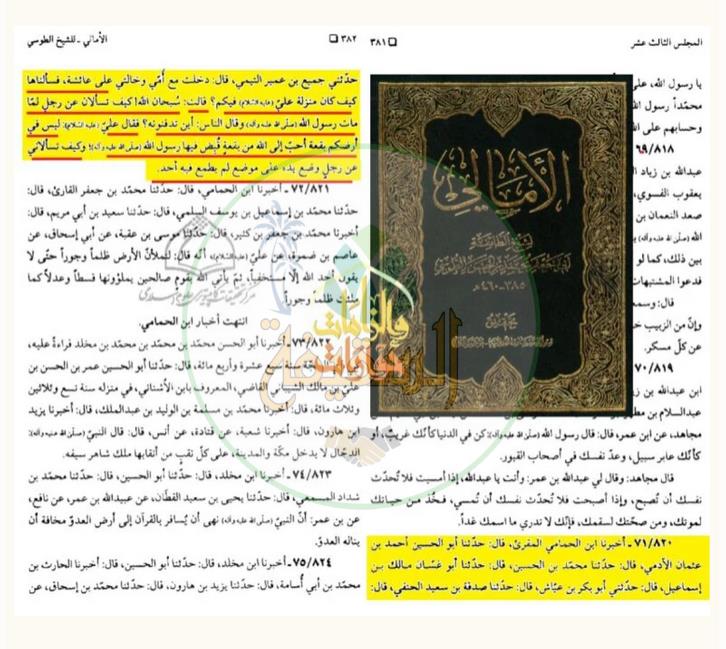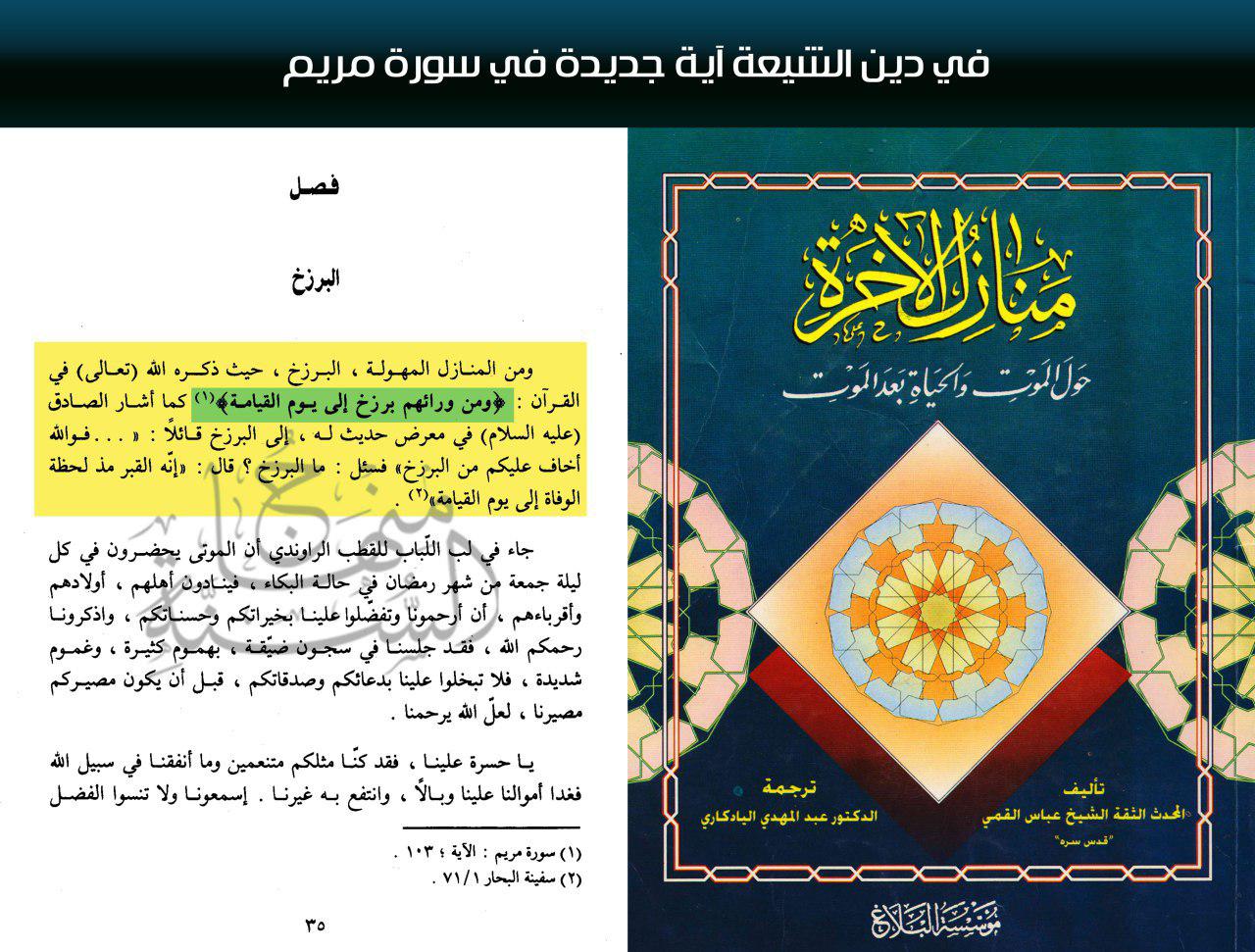تُعَدّ التقيّة من المسائل الفقهية الشائكة التي دار حولها نقاش طويل بين العلماء والمفسرين، وذلك لارتباطها الوثيق بظروف الإكراه والخوف والاضطرار. فهي ليست مجرد مسألة نظرية، بل واقع عاشه المسلمون في صدر الإسلام، حين تعرضوا للتعذيب والقتل بسبب إيمانهم. وقد تناولها العلماء من زوايا مختلفة: فمنهم من ركّز على حدودها وضوابطها الشرعية، ومنهم من اعتبرها رخصة مؤقتة تنتهي بزوال الضعف، فيما رأى آخرون أنها تبقى جائزة إلى يوم القيامة كلما تحقق موجبها. وهذا المقال يسلط الضوء على آراء كبار الأئمة من المذاهب المختلفة في مسائل: ممن تكون التقيّة؟ وبأي شيء تكون؟ وما الذي تبيحه؟ مع بيان اختلافاتهم في الأقوال والأفعال، وعرض اجتهاداتهم في ضوء نصوص الكتاب والسنة.
واختلف العلماء في التقية ممن تكون؟ وبأي شيء تكون؟ وأي شيء تبيح؟
فأما الذي تكون منه التقية فكل قادر غالب مكره يخاف منه، فيدخل في ذلك الكفار إذا غلبوا وجورة الرؤساء والسلابة وأهل الجاه في الحواضر، قال مالك رحمه الله: وزوج المرأة قد يكره.
وأما بأي شيء تكون التقية ويترتب حكمها؛ فذلك بخوف القتل، وبالخوف على الجوارح، وبالضرب بالسوط، وبسائر التعذيب، فإذا فُعِل بالإنسان شيء من هذا أو خافه خوفاً متمكناً فهو مكره، وله حكم التقية، والسجن إكراه، والتقييد إكراه، والتهديد والوعيد إكراه، وعداوة أهل الجاه الجورة تقية، وهذه كلها بحسب حال المكره، وبحسب الشيء الذي يكره عليه، فكم من الناس ليس السجن فيهم بإكراه، وكذلك الرجل العظيم يكره بالسجن والضرب غير المتلف ليكفر، فهذا لا تتصور تقيته من جهة عظم الشيء الذي طلب منه، ومسائل الإكراه هي من النوع الذي يدخله فقه الحال.
وأما أي شيء تبيح، فاتفق العلماء على إباحتها للأقوال باللسان من الكفر وما دونه، ومن بيع وهبة وطلاق، وإطلاق القول بهذا كله، ومن مداراة ومصانعة. وقال ابن مسعود: ما من كلام يدأ عني بسوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلماً به.
واختلف الناس في الأفعال، فقال جماعة من أهل العلم - منهم الحسن ومكحول ومسروق -: يفعل المكره كل ما حمل عليه مما حرم الله فعله وينجي نفسه بذلك. وقال مسروق: فإن لم يفعل حتى مات دخل النار. وقال كثير من أهل العلم - منهم سحنون -: بل إن لم يفعل حتى مات فهو مأجور، وتركه ذلك المباح أفضل من استعماله .... وقال جمع كثير من العلماء: التقية إنما هي مبيحة للأقوال، فأما الأفعال فلا. روي ذلك عن ابن عباس والربيع والضحاك، وروي ذلك عن سحنون، وقال الحسن في الرجل يقال له: اسجد لصنم وإلا قتلناك، قال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد يجعل نيته لله، فإن كان إلى غير القبلة فلا وإن قتلوه، قال ابن حبيب: وهذا قول حسن[1].
|
مقالات السقيفة ذات صلة |
|
الروايات الصحيحة في كتب أهل السنة والجماعة عن المهدي مع نزول عيسى أحاديث نزول عيسى وصلاته وخروج المهدي شبهة حديث: المهدي خير من ابي بكر وعمر |
ويقول ابن الجوزي:
قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ قرأ يعقوب والمفضل عن عاصم «تقية» بفتح التاء من غير ألف، قال مجاهد: إلا مصانعة في الدنيا. قال أبو العالية: التقاة باللسان، لا بالعمل.
◘ ثم قال: والتقية رخصة، وليست بعزيمة، قال الإمام أحمد وقد قيل: إن عرضت على السيف تجيب؟ قال: لا. وقال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟!
◘ وقال: الإكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها، وفي الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان:
إحداهما: أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به.
والثانية: أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب.
وإذ ثبت جواز «التقية» فالأفضل ألا يفعل، نص عليه أحمد في أسير خير بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر على القتل فله الشرف، وإن لم يصبر فله الرخصة. فظاهر هذا الجواز. وروى عنه الأثرم أنه سئل عن التقية في شرب الخمر فقال: إنما التقية في القول. فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك.
فأما إذا أُكره على الزنا لم يجز له الفعل، ولم يصح إكراهه، نص عليه أحمد، فإن أُكره على الطلاق لم يقع طلاقه، نص عليه أحمد، وهو قول مالك والشافعي[2].
ويقول الرازي: اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة، ونحن نذكر بعضها:
الحكم الأول:
أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار، ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز - أيضاً - أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه، وأن يعرض في كل ما يقول؛ فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب.
الحكم الثاني للتقية:
هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل، ودليله ما ذكرناه في قصة مسيلمة.
الحكم الثالث للتقية:
أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة، وقد تجوز - أيضاً - فيما يتعلق بإظهار الدين، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير - كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين - فذلك غير جائز البتة.
|
مختارات من السقيفة |
|
الشيعة الإمامية تخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم من الائمة قراءة القرآن في الحمام بين الجواز والضوابط |
الحكم الرابع:
ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس.
الحكم الخامس:
التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال، يحتمل أن يحكم فيها بالجواز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد»، ولأن الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا؟! والله أعلم.
الحكم السادس:
قال مجاهد: هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين، فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا.
وروى عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة. وهذا القول أولى؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان[3].
ويقول الألوسي في قوله تعالى:
﴿إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً﴾: في الآية دليل على مشروعية التقية، وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء، والعدو قسمان: الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين، كالكافر والمسلم، والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية، كالمال والمتاع والملك والإمارة، ومن هنا صارت التقية قسمين:
أما القسم الأول: فالحكم الشرعي فيه: أنَّ كل مؤمن وقع في محل لا يمكن أن يظهر دينه لتعرض المخالفين وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه، ولا يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف، فإن أرض الله تعالى واسعة.
◘ نعم. إن كان ممن لهم عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبان وانساء والعميان والمحبوسين، والذين يخوفهم المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمهات تخويفاً يظن معه إيقاع ما خوفوا به غالباً، سواء كان هذا القتل بضرب العنق، أو بحبس القوت، أو بنحو ذلك؛ فإنه يجوز له المكث مع المخالف، والموافقة بقدر الضرورة، ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج أو الفرار بدينه، ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكن تحملها - كالحبس مع القوت، والضرب القليل الغير مهلك- لا يجوز له موافقتهم.
وفي صورة الجواز أيضاً: موافقتهم رخصة، وإظهار مذهبه عزيمة، فلو تلفت نفسه لذلك فإنه شهيد قطعاً.
وأما القسم الثاني:
فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمها فيه[4].
ويقول محمد رشيد رضا: وقد استدل بعضهم بالآية على جواز التقية، وهي مايقال أو يفعل مخالفا للحق لأجل توقي الضرر، ولهم فيها تعريفات وشروط وأحكام، وقيل: إنها مشروعة للمحافظة على النفس والعرض والمال. وقيل: لا تجوز التقية لأجل المحافظة على المال، وقيل: إنها خاصة بحال الضعف. وقيل: بل عامة، وينقل عن الخوارج أنهم منعوا التقية في الدين مطلقاً وإن أكره المؤمن وخاف القتل؛ لأن الدين لا يقدم عليه شيء، ويرد عليهم قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾، وقصارى ما تدل عليه الآية أن للمسلم أن يتقي ما يتقى من مضرة الكافرين، وقصارى ماتدل عليه آية سورة النحل ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾ ما تقدم آنفاً، وكل ذلك من باب الرخص لأجل الضرورات العارضة، لا من أصول الدين المتبعة دائماً، ولذلك كان من مسائل الإجماع وجوب الهجرة على المسلم من المكان الذي يخاف فيه إظهار دينه ويضطر فيه إلى التقية[5].
ويقول المراغي:
ترك موالاة المؤمنين للكافرين حتم لازم في كل حال، إلا في حال الخوف من شيء تتقونه منهم، فلكم حينئذ أن تتقوهم بقدر ما يبقى ذلك الشيء؛ إذ القاعدة الشرعية: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح[6].
ويقول في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ﴾، ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة.
وعلى هذه الأقوال سار بقية المفسرين والعلماء من أهل السُنة والجماعة في القديم والحديث.
إذاً فالتقية رخصة يلجأ اليها المسلم إذا وقع تحت وطأة أحوال عصيبة جداً تصل به إلى حد القتل والإيذاء العظيم فيضطر إلى إظهار خلاف ما يبطن، وهي غالباً ما تكون مع الكفار، واتفقوا على هذا التصور العام، على خلاف يسير في بعض ما يتعلق بالمسألة، كالقول بزوالها بعد عزة الإسلام، أو جوازها إلى يوم القيامة، وأفضلية اختيار العزيمة عليها في مواطن الإكراه، وكونها جائزة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بينهم الحالة بين المسلمين والكافرين، وغيرها مما مر بك، وهي لا تخرج في جميع أحوالها عن كونها رخصة في حال الضرورة، وعن كونها تتعلق بالظاهر لا بما تكنه القلوب.
[1] انظر: المحرر الوجيز (1/420)، جامع لطائف التفسير للقماش (12/290).
[2] انظر: زاد المسير لابن الجوزي (1/372).
[3] انظر: مفاتيح الغيب للرازي (8/12)، وما بعدها.
[4] انظر: روح المعاني للألوسي (2/121).
[5] تفسير المنار (3/231).
[6] تفسير المراغي (3/136).